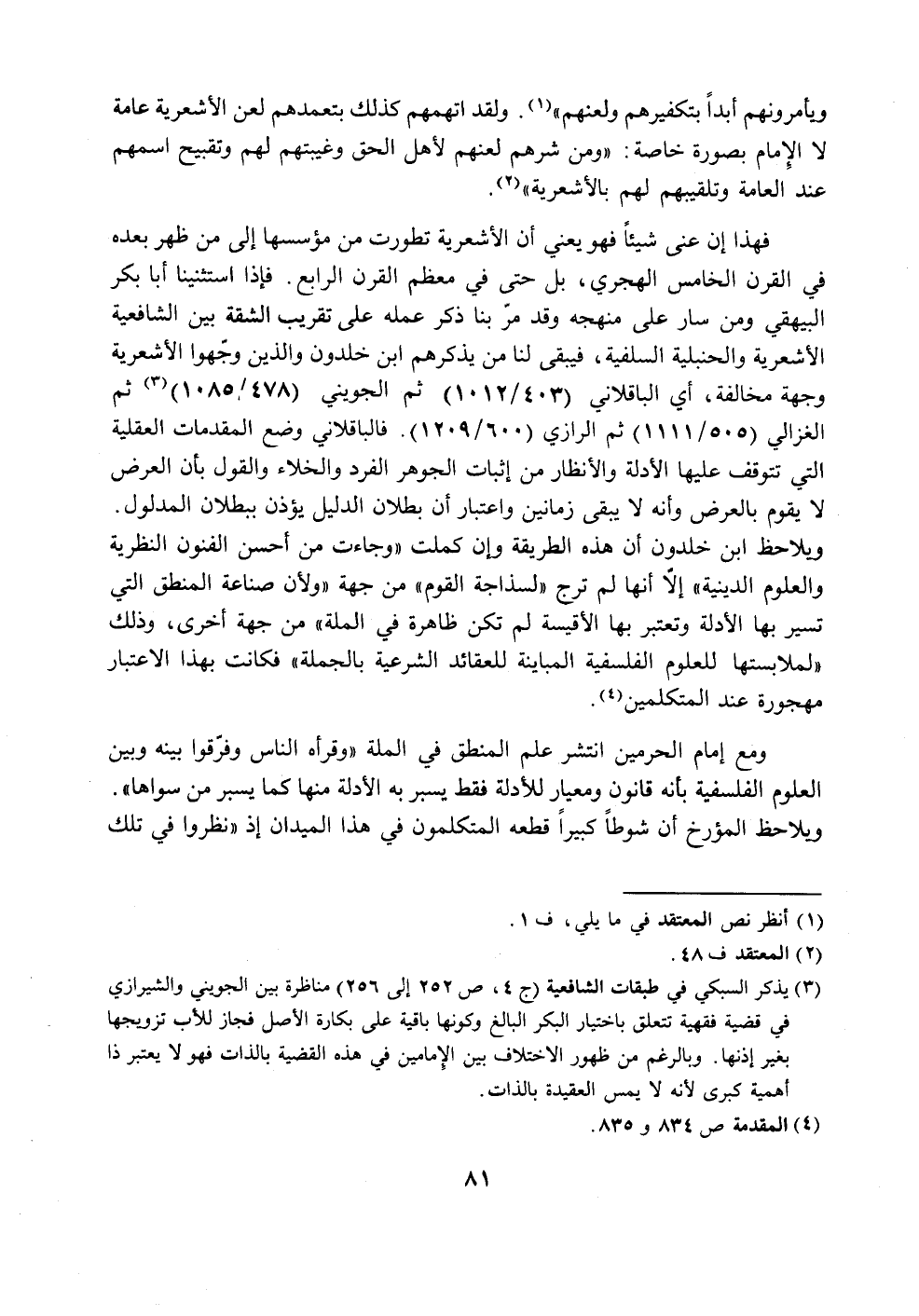
كتاب شرح اللمع
ويأمرونهم أبدا بتكفيرهم ولعنهم " (1). ولقد اتهمهم كذلك بتعمدهم لعن الأشعرية عامةلا الإمام بصورة خاصة: "ومن شرهم لعنهم لأهل الحق وغيبتهم لهم وتقبيح اسمهم
عند العامة وتلقيبهم لهم بالأشعرية" (2).
فهذا إن عنى شيئأ فهو يعني أن الأشعرية تطورت من مؤسسها إلى من ظهر بعده
في القرن الخامس الهجري، بل حتى في معظم القرن الرابع. فإذا استثنينا أبا بكر
البيهقي ومن سار على منهجه وقد مر بنا ذكر عمله على تقريب الشقة بين الشافعية
الأشعرية والحنبلية السلفية، فيبقى لنا من يذكرهم ابن خلدون والذين وخهوا الأشعرية
وجهة مخالفة، أي الباقلاني (1012/ 403) ثم الجويني (478/! 1085) (3) ثم
الغزالي (505/ 1111) ثم الرازي (0 1209/ 60). فالباقلاني وضع المقدمات العقلية
التي تتوقف عليها الأدلة والأنظار من إثبات الجوهر الفرد والخلاء والقول بأن العرض
لا يقوم بالعرض وأنه لا يبقى زمانين واعتبار أن بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول.
ويلاحظ ابن خلدون أن هذه الطريقة وإن كملت "وجاءت من أحسن الفنون النظرية
والعلوم الدينية " إلَّا أنها لم ترح "لسذاجة القوم " من جهة "ولأن صناعة المنطق التي
تسير بها الأدلة وتعتبر بها الأقيسة لم تكن ظاهرة في الملة " من جهة أخرى، وذلك
"لملابستها للعلوم الفلسفية المباينة للعقائد الشرعية بالجملة " فكانت بهذا الاعتبار
مهجورة عند المتكلمين (4).
ومع إمام الحرمين انتشر علم المنطق في الملة "وقرأه الناس وفرقوا بينه وبين
العلوم الفلسفية بأنه فانون ومعيار للأدلة فقط يسبر به الأدلة منها كما يسبر من سواها".
ويلاحظ المؤرخ أن شوطا كبيرا قطعه المتكلمون في هذا الميدان إذ "نظروا في تلك
__________
(1) أنظر نص المعتقد في ما يلي، ف 1.
(2) المعتقد ف 48.
(3) يذكر السبكي في طبقات الشافعية (ح 4، ص 252 إلى 256) مناظرة بين الجويني والشيرازي
في قضية فقهية تتعلق باختيار البكر البالغ وكونها باقية على بكارة الأصل فجاز للأب تزويجها
بغير إذنها. وبالرغم من ظهور الاختلاف بين الإمامين في هذه القضية بالذات فهو لا يعتبر ذا
أهمية كبرى لأنه لا يمس العقيدة بالذات.
(4) المقدمة ص Art و 835.
81