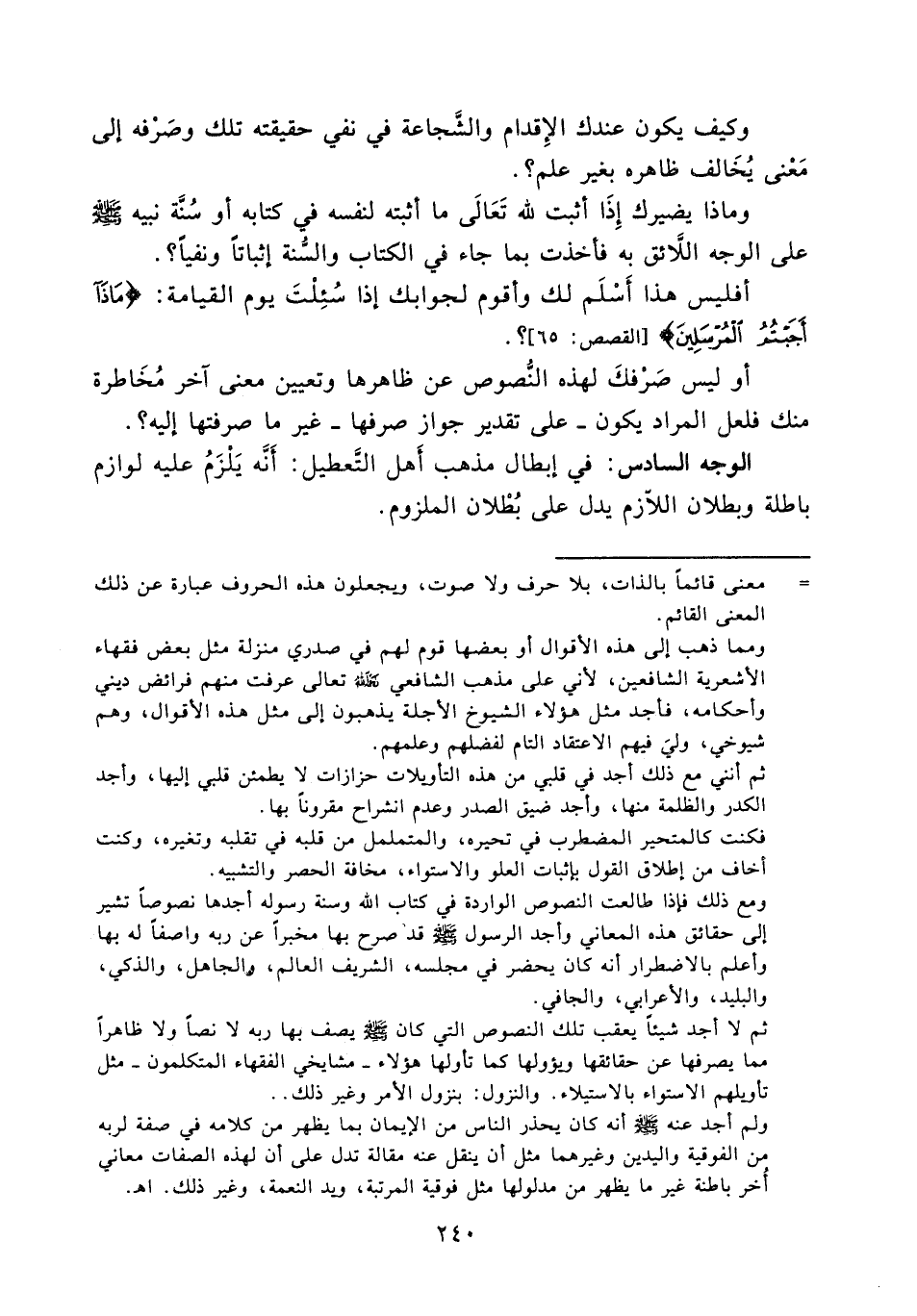
كتاب المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى
وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم؟ .وماذا يضيرك إذا أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتاً ونفياً؟ .
أفليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة: {ماذا أجبتم المرسلين} [القصص: 65] .
أو ليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك فلعل المراد يكون - على تقدير جواز صرفها - غير ما صرفتها إليه
الوجه السادس: في إبطال مذهب أهل التعطيل: أنه يلزم عليه لوازم باطلة وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم.
__________
= معنى قائماً بالذات، بلا حرف ولا صوت، ويجعلون هذه الحروف عبارة عن ذلك المعنى القائم.
ومما ذهب إلى هذه الأقوال أو بعضها قوم لهم في صدري منزلة مثل بعض فقهاء الأشعرية الشافعيين، لأني على مذهب الشافعي رحمه الله تعالى عرفت منهم فرائض
ديني وأحكامه، فأجد مثل هؤلاء الشيوخ الأجلة يذهبون إلى مثل هذه الأقوال، وهم شيوخي، وليَّ فيهم الاعتقاد التام لفضلهم وعلمهم.
ثم أنني مع ذلك أجد في قلبي من هذه التأويلات حزازات لا يطمئن قلبي إليها، وأجد الكدر والظلمة منها، واجد ضيق الصدر وعدم انشراحه مقروناً بها.
فكنت كالمتحير المضطرب في تحيره، المتململ من قلبه في تقلبه وتغيره، وكنت أخاف من إطلاق القول بإثبات العلو، والاستواء، مخافة الحصر والتشبيه.
ومع ذلك فإذا طالعت النصوص الوارد في كتاب الله وسنة رسوله أجدها نصوصاً تشير إلى حقائق هذه المعاني وأجد الرسول صلى الله عليه وسلم قد صرح بها مخبراً عن ربه واصفاً له بها وأعلم بالاضطرار أنه كان يحضر في مجلسه الشريف العالم، والجاهل والذكي والبليد والأعرابي الجافي ثم لا أجد شيئاً يعقب تلك النصوص التي كان صلى الله عليه وسلم يصف بها ربه لا نصاً ولا ظاهراً مما يصرفها عن حقائقها ويؤولها كما تأولها هؤلاء - مشايخي الفقهاء المتكلمون - مثل تأويلهم الاستواءُ بالاستيلاء. والنزول: بنزول الأمر وغير ذلك..
ولم أجد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحذر الناس من الإيمان بما يظهر من كلامه في صفة لربه من الفوقية واليدين وغيرهما مثل أن ينقل عنه مقالة تدل على أن لهذه الصفات معاني أُخر باطنه غير ما يظهر من مدلولها مثل فوقية المرتبة، ويد النعمة، وغير ذلك. ا. هـ.