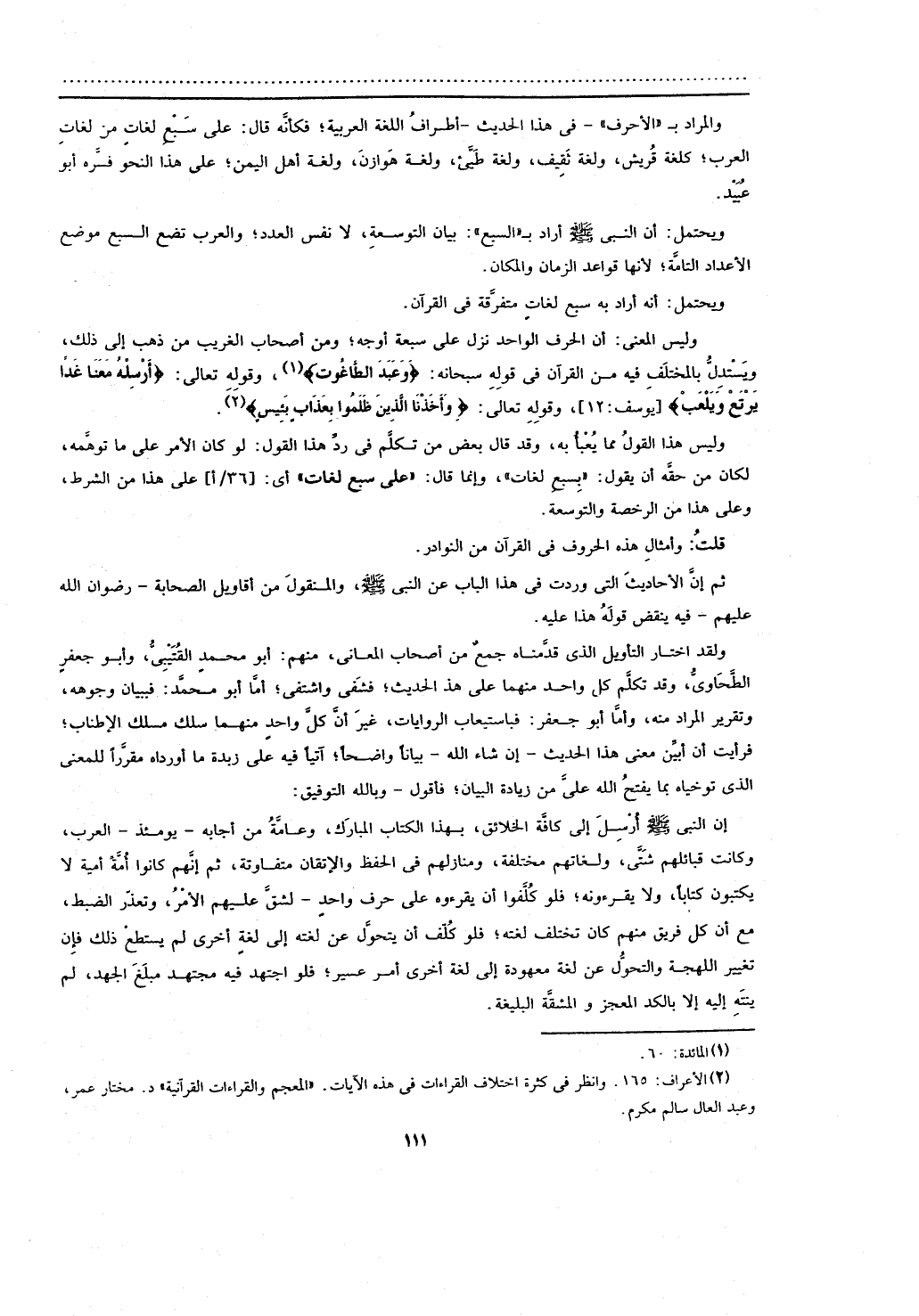
كتاب الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي (اسم الجزء: 1)
والمراد بـ (الأحرف) - في هذا الحديث- أطراف اللغة العربية؛ فكأنه قال: على سبع لغات من لغات العرب؛ كلغة قريش، ولغة ثقيف، ولغة طيئ، ولغة هوازن، ولغة أهل اليمن؛ على هذا النحو فره أبو عبيد.ويحتمل: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد بـ (السيع): بيان التوسعة: لا نفس العدد؛ والعرب تضع السبع موضع الأعداد التامة؛ لأنها قواعد الزمان والمكان.
ويحتمل: أنه أراد به سبع لغات متفرقة في القرآن.
وليس المعنى: أن الحرف الواحد نزل على سبعة أوجه؛ ومن أصحاب الغريب من ذهب إلى ذلك، ويستدل بالمختلف فيه من القرآن في قوله سبحانه: {وعبد الطاغوت}، وقوله تعالى: {أرسله معنا عدا يرتع ويلعب} [يوسف: 12]، وقوله تعال: {وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس}.
وليس هذا القول مما يعبأ به، وقد قال بعض من تكلم في رد هذا القول: لو كان الأمر على ما توهمه، لكان من حقه أن يقول: (بسبع لغات)، وإنما قال: (على سبع لغات) أي: [36/أ] على هذا من الشرط وعلى هذا من الرخصة والتوسعة.
قلت: وأمثال هذه الحروف في القرآن من النوادر.
ثم إن الأحاديث التي وردت في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والمنقول من أقاويل الصحابة- رضوان الله عليهم- فيه ينقض قوله هذا عليه.
ولقد اختار التأويل الذي قدمناه جمع من أصحاب المعاني، منهم: أبو محمد القتيبي، أبو جعفر الطحاوي، وقد تكلم كل واحد منهما على هذا الحديث؛ فشفى واشتفى؛ أما أبو محمد: فببيان وجوهه، وتقرير المراد منه، وأما أبو جعفر: فباستيعاب الروايات، غير أن كل واحد منهما سلك مسلك الإطناب؛ فرأيت أن أبين معنى هذا الحديث- إن شاء الله- بيانا واضحا؛ آتيا فيه على زبدة ما أورداه مقررا للمعنى الذي توخياه بما يفتح الله على من زيادة البيان؛ فأقول- وبالله التوفيق:
إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرسل إلى كافة الخلائق، بهذا الكتاب المبارك، وعامة من أجابه- يومئذ- العرب، وكانت قبائلهم شتى، ولغاتهم مختلفة، ومنازلهم في الحفظ والإتقان متفاوتة، ثم إنهم كانوا أمة أمية لا يكتبون كتابا، ولا يقرءونه؛ فلو كلفوا أن يقرءوه على حرف واحد- لشق عليهم الأمر، وتعذر الضبط، مع أن كل فريق منهم كان تختلف لغته؛ فلو كلف أن يتحول عن لغته إلى لغة أخرى لم يستطع ذلك فإن تغيير اللهجة والتحول عن لغة معهودة إلى لغة أخرى أمر عسير؛ فلو اجتهد فيه مجتهد مبلغ الجهد، لم ينته إليه إلا بالكد المعجز والمشقة البليغة.