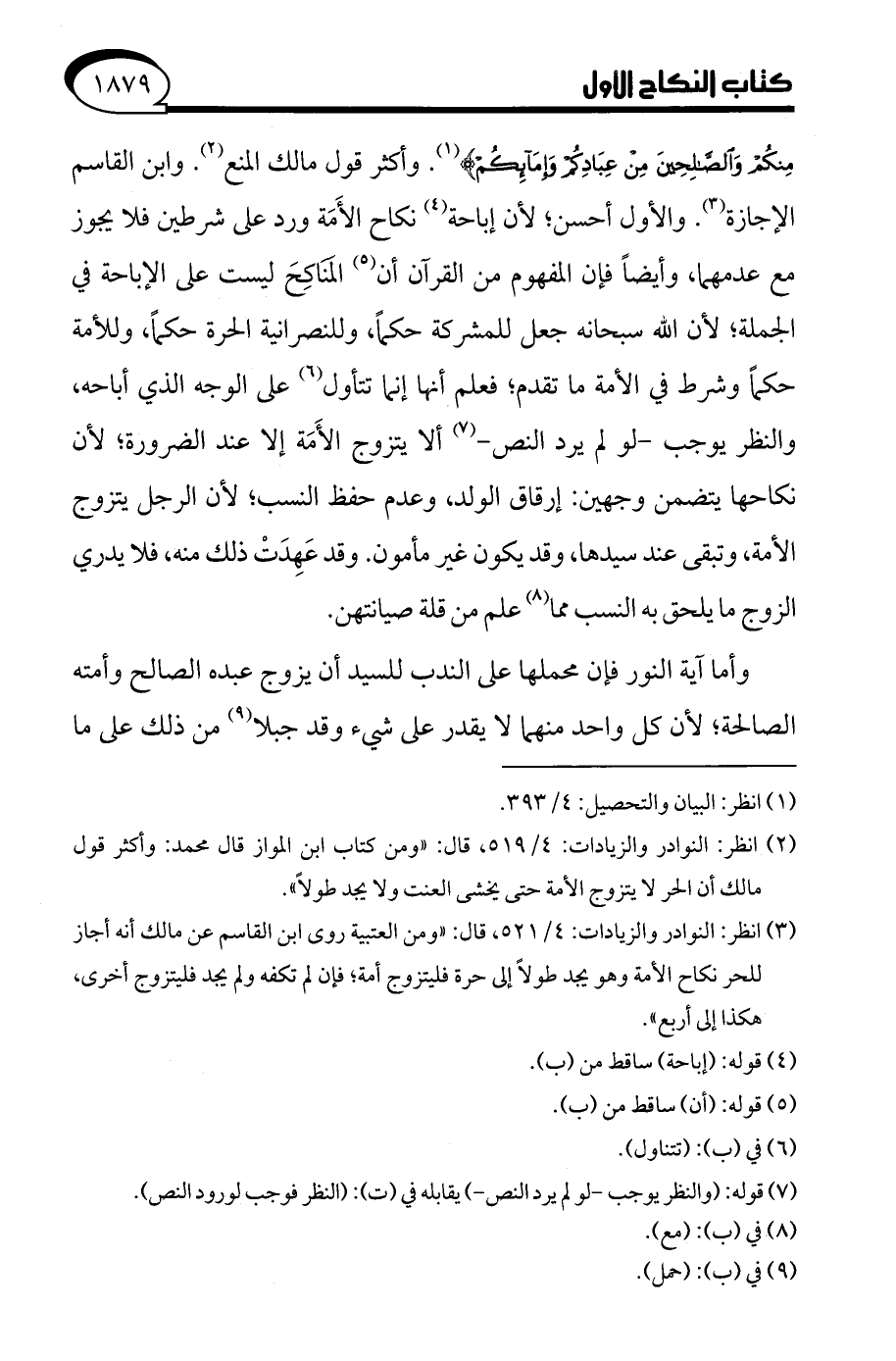
كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 4)
مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} (¬1). وأكثر قول مالك المنع (¬2). وابن القاسم الإجازة (¬3). والأول أحسن؛ لأن إباحة (¬4) نكاح الأَمَة ورد على شرطين فلا يجوز مع عدمهما، وأيضًا فإن المفهوم من القرآن أن (¬5) المَنَاكِحَ ليست على الإباحة في الجملة؛ لأن الله سبحانه جعل للمشركة حكمًا، وللنصرانية الحرة حكمًا، وللأمة حكمًا وشرط في الأمة ما تقدم؛ فعلم أنها إنما تتأول (¬6) على الوجه الذي أباحه، والنظر يوجب -لو لم يرد النص- (¬7) ألا يتزوج الأَمَة إلا عند الضرورة؛ لأن نكاحها يتضمن وجهين: إرقاق الولد، وعدم حفظ النسب؛ لأن الرجل يتزوج الأمة، وتبقى عند سيدها، وقد يكون غير مأمون. وقد عَهِدَتْ ذلك منه، فلا يدري الزوج ما يلحق به النسب مما (¬8) علم من قلة صيانتهن.وأما آية النور فإن محملها على الندب للسيد أن يزوج عبده الصالح وأمته الصالحة؛ لأن كل واحد منهما لا يقدر على شيء وقد جبلا (¬9) من ذلك على ما
¬__________
(¬1) انظر: البيان والتحصيل: 4/ 393.
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 519، قال: "ومن كتاب ابن المواز قال محمد: وأكثر قول مالك أن الحر لا يتزوج الأمة حتى يخشى العنت ولا يجد طولًا".
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 521، قال: "ومن العتبية روى ابن القاسم عن مالك أنه أجاز للحر نكاح الأمة وهو يجد طولًا إلى حرة فليتزوج أمة؛ فإن لم تكفه ولم يجد فليتزوج أخرى، هكذا إلى أربع".
(¬4) قوله: (إباحة) ساقط من (ب).
(¬5) قوله: (أن) ساقط من (ب).
(¬6) في (ب): (تتناول).
(¬7) قوله: (والنظر يوجب -لو لم يرد النص-) يقابله في (ت): (النظر فوجب لورود النص).
(¬8) في (ب): (مع).
(¬9) في (ب): (حمل).