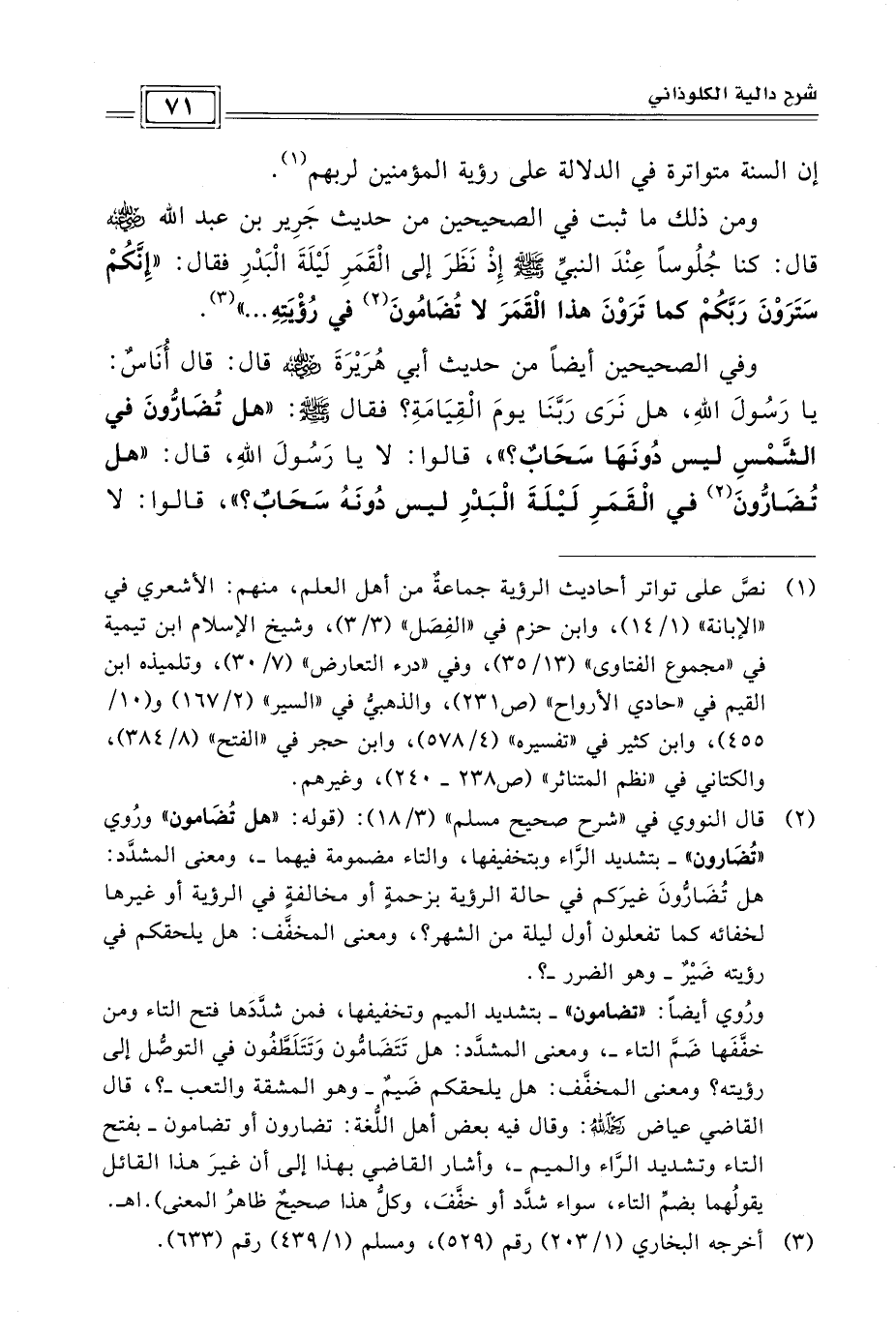
كتاب شرح القصيدة الدالية للكلوذاني
إن السنة متواترة في الدلالة على رؤية المؤمنين لربهم (1).ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث جَرِير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا جُلُوسًا عِنْدَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ نَظَرَ إلى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قال: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كما تَرَوْنَ هذا الْقَمَرَ لا تُضَامُونَ (2) في رُؤْيَتِهِ ...» (3).
وفي الصحيحين أيضاً من حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال أُنَاسٌ: يا رَسُولَ اللَّهِ هل نَرَى رَبَّنَا يوم الْقِيَامَةِ؟ فقال: «هل تُضَارُّونَ في الشَّمْسِ ليس دُونَهَا سَحَابٌ؟» قالوا: لا
__________
(1) نصَّ على تواتر أحاديث الرؤية جماعةٌ من أهل العلم، منهم: الأشعري في «الإبانة» (1/ 14)، وابن حزم في «الفِصَل» (3/ 3)، وشيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (13/ 35)، وفي «درء التعارض» (7/ 30)، وتلميذه ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص 231)، والذهبيُّ في «السير» (2/ 167) و (10/ 455)، وابن كثير في «تفسيره» (4/ 578)، وابن حجر في «الفتح» (8/ 384)، والكتاني في «نظم المتناثر» (ص 238 - 240)، وغيرهم.
(2) قال النووي في «شرح صحيح مسلم» (3/ 18): (قوله: «هل تُضَامون» ورُوي «تُضَارون» -بتشديد الرَّاء وبتخفيفها، والتاء مضمومة فيهما-، ومعنى المشدَّد: هل تضارون غيركم في حالة الرؤية بزحمة أو مخالفة في الرؤية أو غيرها لخفائه كما تفعلون أول ليلة من الشهر، ومعنى المخفَّف: هل يلحقكم في رؤيته ضَيْرٌ وهو الضرر.
وروي أيضاً: «تضامون» -بتشديد الميم وتخفيفها، فمن شدَّدَها فتح التاء ومن خفَّفَها ضَمَّ التاء-، ومعنى المشدَّد هل تتضامون وتتلطفون في التوصل إلى رؤيته، ومعنى المخفَّف هل يلحقكم ضَيمٌ وهو المشقة والتعب، قال القاضي عياض رحمه الله: وقال فيه بعض أهل اللُّغة: تضارون أو تضامون -بفتح التاء وتشديد الرَّاء والميم- وأشار القاضي بهذا إلى أن غير هذا القائل يقولُهما بضمِّ التاء سواء شدَّد أو خفَّفَ وكلُّ هذا صحيحٌ ظاهرُ المعنى) أ. هـ
(3) أخرجه البخاري (1/ 203 رقم 529)، ومسلم (1/ 439 رقم 633).