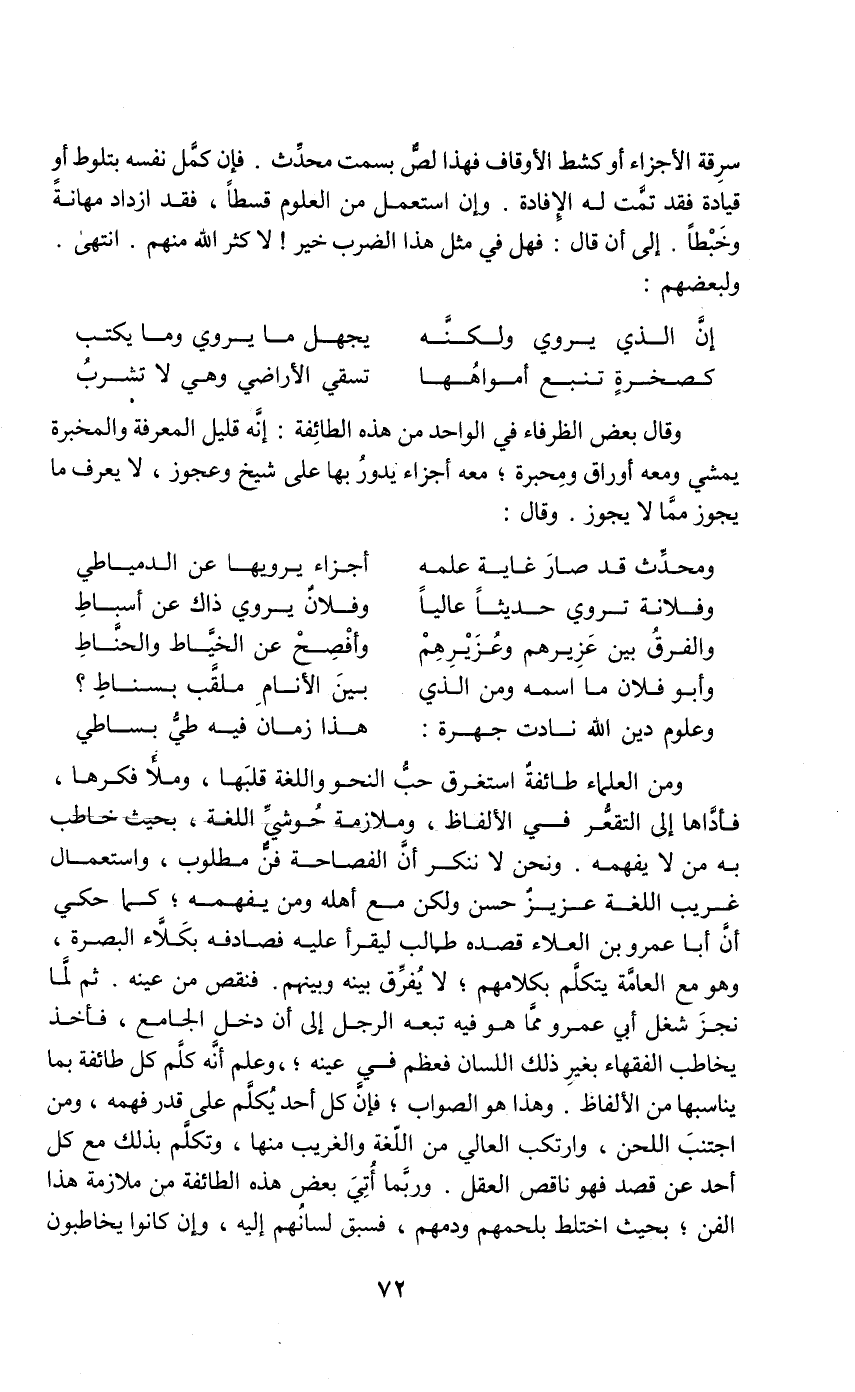
كتاب معيد النعم ومبيد النقم
سرِقة الأجزاء أو كشط الأوقاف فهذا لصٌّ بسمت محدِّث. فإن كمَّل نفسه بتلوط أو قيادة فقد تمَّت له الإفادة. وإن استعمل من العلوم قسطًا، فقد ازداد مهانةً وخَبْطًا. إلى أن قال: فهل في مثل هذا الضرب خير! لا كثر اللَّه منهم. انتهى. ولبعضهم:إنَّ الذي يروي ولكنَّه ... يجهل ما يروي وما يكتب
كصخرةٍ تنبع أمواهُها ... تسقي الأراضي وهي لا تشربُ
وقال بعض الظرفاء في الواحد من هذه الطائِفة: إنَّه قليل المعرفة والمخبرة يمشي ومعه أوراق ومِحبرة؛ معه أجزاء يدورُ بها على شيخ وعجوز، لا يعرف ما يجوز ممَّا لا يجوز. وقال:
ومحدِّث قد صارَ غاية علمه ... أجزاء يرويها عن الدمياطي
وفلانة تروي حديثًا عاليًا ... وفلانٌ يروي ذاك عن أسباطِ
والفرقُ بين عَزِيرهم وعُزَيْرِهِمْ ... وأفْصِحْ عن الخيَّاط والحنَّاطِ
وأبو فلان ما اسمه ومن الذي ... بينَ الأنامِ ملقَّب بسناطِ؟
وعلوم دين اللَّه نادت جهرة: ... هذا زمان فيه طيُّ بساطي
ومن العلماء طائفةٌ استغرق حبُّ النحو واللغة قلبَها، وملأ فكرها، فأدَّاها إلى التقعُّر في الألفاظ، وملازمة حُوشيِّ اللغة، بحيث خاطب به من لا يفهمه. ونحن لا ننكر أنَّ الفصاحة فنٌّ مطلوب، واستعمال غريب اللغة عزيزٌ حسن ولكن مع أهله ومن يفهمه؛ كما حكي أنَ أبا عمرو بن العلاء قصده طالب ليقرأ عليه فصادفه بكَلَّاء البصرة، وهو مع العامَّة يتكلَّم بكلامهم؛ لا يُفرِّق بينه وبينهم. فنقص من عينه. ثم لمَّا نجزَ شغل أبي عمرو ممَّا هو فيه تبعه الرجل إلى أن دخل الجامع، فأخذ يخاطب الفقهاء بغيرِ ذلك اللسان فعظم في عينه؛ وعلم أنَّه كلَّم كل طائفة بما يناسبها من الألفاظ. وهذا هو الصواب؛ فإنَّ كل أحد يُكلَّم على قدر فهمه، ومن اجتنبَ اللحن، وارتكب العالي من اللّغة والغريب منها، وتكلَّم بذلك مع كل أحد عن قصد فهو ناقص العقل. وربَّما أُتِيَ بعض هذه الطائفة من ملازمة هذا الفن؛ بحيث اختلط بلحمهم ودمهم، فسبق لسانُهم إليه، وإن كانوا يخاطبون