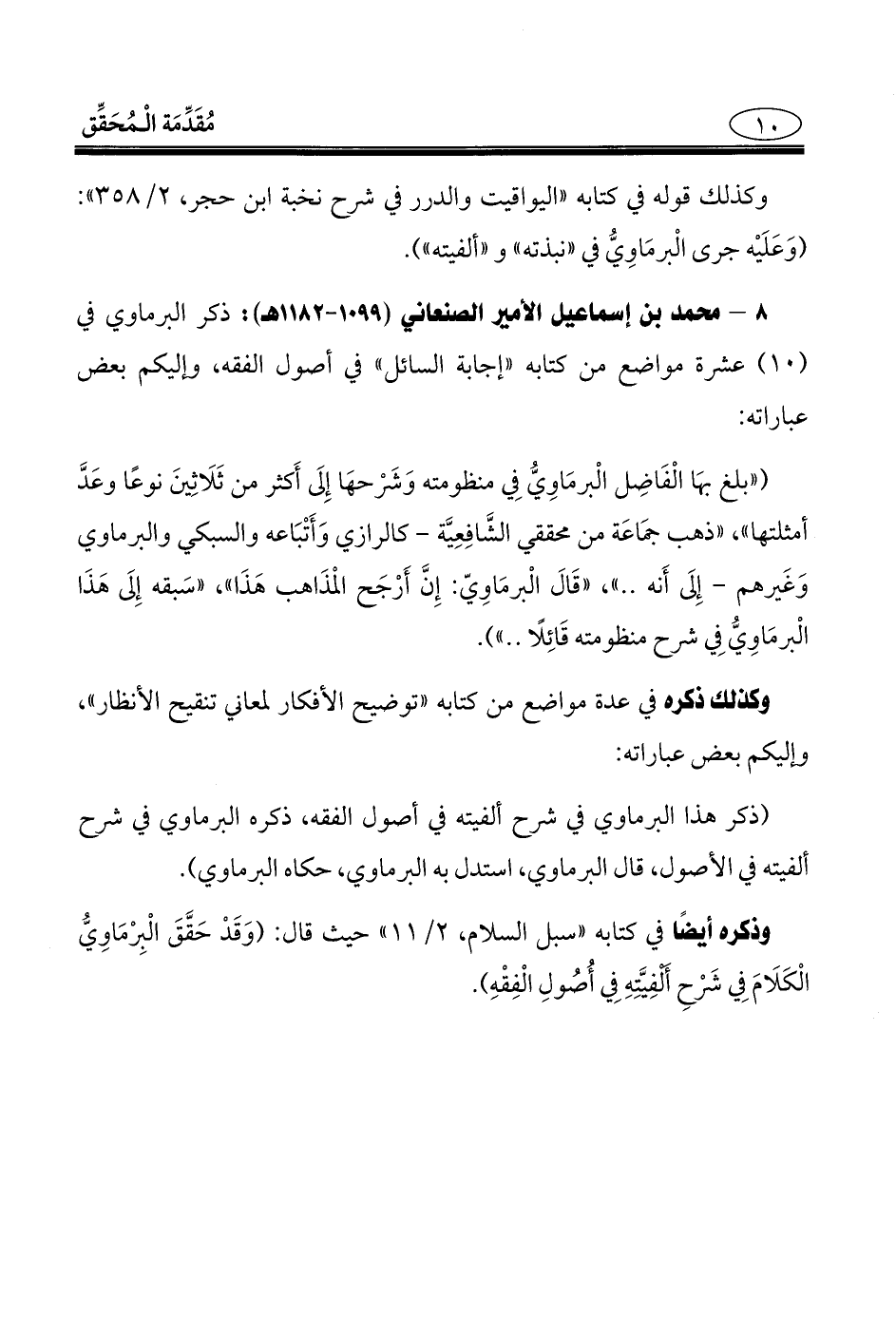
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية
وكذلك قوله في كتابه "اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر، 2/ 358": (وَعَلَيْه جرى الْبرمَاوِيُّ في "نبذته" و"ألفيته").8 - محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني (1099 - 1182 هـ): ذكر البرماوي في (10) عشرة مواضع من كتابه "إجابة السائل" في أصول الفقه، وإليكم بعض عباراته:
("بلغ بهَا الْفَاضِل الْبرمَاوِيُّ فِي منظومته وَشَرْحهَا إِلَى أَكثر من ثَلَاثِينَ نوعًا وعَدَّ أمثلتها"، "ذهب جمَاعَة من محققي الشَّافِعِيَّة - كالرازي وَأَتْبَاعه والسبكي والبرماوي وَغَيرهم - إِلَى أَنه .. "، "قَالَ الْبرمَاوِيّ: إِنَّ أَرْجَح المْذَاهب هَذَا"، "سَبقه إِلَى هَذَا الْبرمَاوِيُّ فِي شرح منظومته قَائِلًا .. ").
وكذلك ذكره في عدة مواضع من كتابه "توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار"، وإليكم بعض عباراته:
(ذكر هذا البرماوي في شرح ألفيته في أصول الفقه، ذكره البرماوي في شرح ألفيته في الأصول، قال البرماوي، استدل به البرماوي، حكاه البرماوي).
وذكره أيضًا في كتابه "سبل السلام، 2/ 11" حيث قال: (وَقَدْ حَقَّقَ الْبِرْمَاوِيُّ الْكَلَامَ فِي شَرْحِ أَلْفِيَّتِهِ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ).
(طائفة لا [يجيزون] (¬1) بعثة الرسل)، وعن "السُّوفسطائية" -بضم السين المهملة الأولى وبالفاء، وربما قيل: "السوفسطانية" بنون بعد الألف- قوم ينكرون الحقائق، وكان شيخنا شيخ الإسلام البلقيني يعيبُ ذِكر خلاف مثل هؤلاء في أصول الفقه كما سبق ذِكره في موضع آخَر.
نعم، إذا ذكِر لغرض معرفة شبهتهم وردِّها كي لا يغتر بها مسلم، فلا بأس.
وحمل إمام الحرمين مخالفة السمنية - أي: ومن وافقهم على عدم إفادة "المتواتر" العِلم -على معنى أنَّ العدد وإنْ كثر فلا اكتفاء به حتى ينضم إليه ما يجري مجرى القرينة.
ومن هنا أُخِذ أن الإمام يقول باستناد العِلم للقرينة، لا لمجرد الإخبار المتواتر.
وكذلك قال ابن رشد في "مختصر المستصفى": لم يقع خلاف في كون المتواتر يفيد اليقين إلا ممن لا يُؤْبَه له.
قال: (وهُم السوفسطائية، وجاحده يحتاج لعقوبة؛ فإنه كاذب بلسانه على ما في نفسه، إنما الخلاف في جهة وقوع اليقين، فقَوم رأوه بالذات وقوم رأوه بالعرض، وقوم رأوه مكتسبًا). انتهى
وحاصل قولهما أن الخلاف لفظي. قال ابن الحاجب: (إن قول المنكِر لإفادته العِلم بُهْت، فإنَّا نجد العِلم ضرورةً بالبلاد النائية والأُمم الخالية والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم والخلفاء - رضي الله عنه -بمجرد الإخبار، كما في العلم بالحس) (¬2).
وفي المسألة قول ثالث: إنه يفيد في الخبر عن الموجود، ولا يفيد عن الماضي.
فإنْ قلتَ: هل لهذه المسألة ثمرة في الفقه؟
¬__________
(¬1) في (ز، ش): يجوزون.
(¬2) مختصر المنتهى مع بيان المختصر (1/ 637).
والطريقتان مشهورتان، إلَّا أنَّه ينبغي في مِثل هذا الوقت رجحان طريقة التَّأويلِ وإظهاره؛ لِمَا حدث من البدع وتلبيس بعض المبتدعة على ضعيفي العقول وحملهم على أن يعتقدوا ظاهرها الذي قامت الأدلة القاطعة على استحالته، وقام الإجماع من الفريقين على عدم إرادة ظاهره، فهو من باب النصح الواجب، والله تعالى أعلم.
ص:
450 - وَسمِّ بِـ "الْمُجْمَلِ" مَا لَمْ يَتَّضِحْ ... دِلَالَةً؛ لِلاشْتِرَاكِ لم [يَضِحْ] (¬1)
451 - أَوْ رَجَحَ الْمَجَازُ حَتَّى سَاوَى ... حَقِيقَةً، وَكُلُّ مَا تَسَاوَى
الشرح:
لَمَّا ذكرتُ أن المتشابه ما لم يتضح المقصود منه وأن تحته نوعين:
أحدهما: ما لم يُرَد ظاهرُه.
وثانيهما: ما تساوى محتملاه أو محتملاته وهو "المجمل".
وسبق الكلام في القسم الأول، بينتُ هنا القسم الثاني الذي هو "المجمل"، وأصله من الجمل وهو الجمع. قال ابن طريف: أجملتُ الشيء: جمعته عن تفرقة، وأجملت الحساب: جمعته. وقال ابن دُرَيد: ("أجملت الحساب" لا أحسبه عربيًّا صحيحًا) (¬2).
فَـ "المُجْمَل": ما لم تتضح دلالته من حيث الاستواء فيها:
- إما للاشتراك ولا قرينة ترجح شيئًا من المحتمل، إما بأنْ لا قرينة أصلًا، أو لكُلٍّ
¬__________
(¬1) في (ض، ت) ت تضح. وفي (ن 1، ن 2، ن 3، ن 4): يصح.
(¬2) جمهرة اللغة (1/ 491).
فقال ابن الحاجب: (إنه الذي يَقْرب من مدلوله قبل التخصيص) (¬1).
ومقتضى هذا أن يكون أكثر من النصف، وفسره جَمعٌ -كالبيضاوي- بأن يبقى غير محصور. والتفسيران متقاربان؛ إذِ المراد بكونه يقرب من مدلول العام أن يكون غير محصور، فإنَّ العام هو المستغرق لِما يَصْلح له مِن غيْر حَصْر، فهو معنى أن يبقى غير محصور، ولهذا قابله ابن الحاجب بأقوال الثلاثة والاثنين والواحد الآتي ذِكرها.
فقول البيضاوي في تعليله على تفسيره السابق: (لسماجة "أكلتُ كُل رمان في البيت" ولم يأكل غير واحدة) (¬2) إنما مراده أن يكون الذي في البيت الواحد والاثنان والثلاثة؛ لكون ذلك محصورًا، و"كُل" إنما تكون لغير المحصور.
وذِكرُهُ الواحد مثال، خلافًا لمن انتقد عليه بأنه لا يَلزم مِن قُبْح هذا قُبْحُ المحصور كالاثنين والثلاثة. فالدعوى عامة والدليل خاص.
وإذا تَقرر ما ذكرناه من عدم مغايرة التفسيرين، عرفتَ أن ما في "جمع الجوامع" مِن جَعْلِهما قولين متغايرين ليس بجيد.
المذهب الرابع: أنه لا بُد من بقاء أقَل الجمع مطلقًا ولو لم يكن صيغة العموم جمعًا. حكاه ابن برهان وغيره.
فقول ابن الحاجب: (وقيل: اثنان. وقيل: ثلاثة) لَعلَّه للخلاف الآتي في كون الجمع اثنين أو ثلاثة، فيرجعان إلى هذا المذهب، ويحتمل أن المدْرَك غير ذلك، والأمر سهل.
المذهب الخامس: التفصيل بين أن يكون التخصيص بالاستثناء والبدل فيجوز إلى واحد، وبين أن لا يكون بهما فلا يجوز إلى واحد. حكاه ابن المطهر.
¬__________
(¬1) مختصر المنتهى (2/ 235) مع بيان المختصر.
(¬2) منهاج الوصول (174) بتحقيقي.
لذلك. أي: فإن التعليل إنما هو مستفاد من وقوع الجملة استئنافية مُشْعِرة بسؤال مُقَدَّر كما في {إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ} [يوسف: 53]، كأنه قيل: ما سبب أن لا تبرئ نفسك؟ فأجاب بذلك.
ولهذا يستفاد التعليل في مِثله مِن غير أن يكون في الكلام "إنَّ"، نحو:
قال لي كيف أنت؟ قلتُ: عليل ... سهر دائم وحزن طويل
كأنه سُئل: ما سبب عِلتك؟ فقال: سببها السهر وطول الحزن.
الخامس:
من صيغ الظاهر أيضًا: "إذْ"، فإنها تأتي للتعليل كما قاله ابن مالك. كقوله تعالى: {وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ} [الكهف: 16]، {اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ} [المائدة: 20]، {وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ} [الأحقاف: 11]، {وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ} [الزخرف: 39]، {قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا} [النساء: 72]، {اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ} [الأحزاب: 9].
وقول الشاعر:
فأصبحوا قد أَعادَ اللهُ نِعمتهم ... إذْ هُم قريش وإذْ ما مِثلهم بشَر
وذكر أن سيبويه أشار إلى ذلك، ونازعه أبو حيان.
وقولي: (وَمَا مَضى لِلسَّبَبِ) أي: ومما يُعد مِن أدوات التعليل في الظاهر ما سبق في باب معاني الكلم التي يُحتاج إليها مما ذكر مِن معانيه السببية، مثل: "على" في قوله تعالى: {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: 185]، و"في" مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "دخلت امرأة