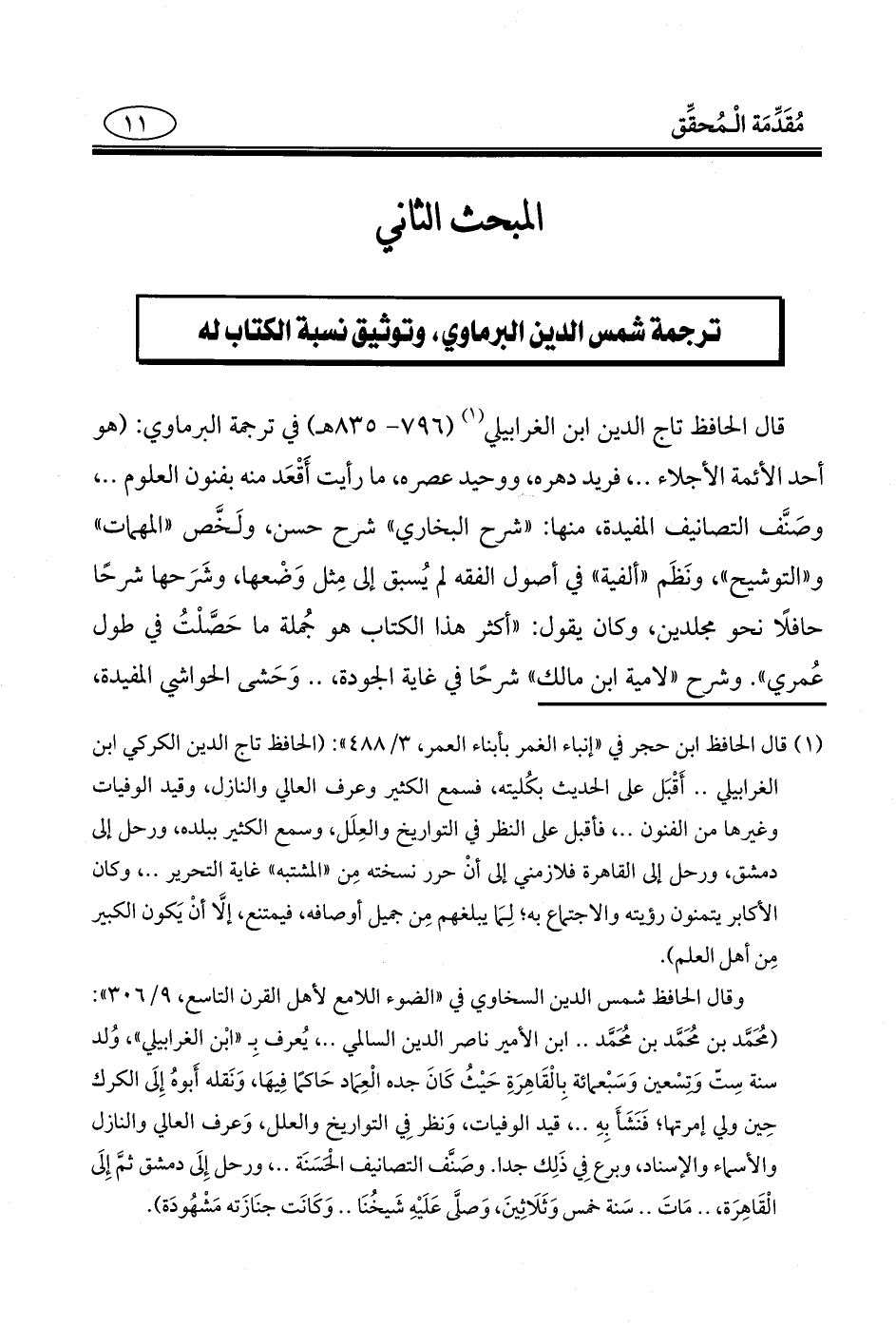
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية
المبحث الثاني: ترجمة شمس الدين البرماوي، وتوثيق نسبة الكتاب لهقال الحافظ تاج الدين ابن الغرابيلي (¬1) (796 - 835 هـ) في ترجمة البرماوي: (هو أحد الأئمة الأجلاء .. ، فريد دهره، ووحيد عصره، ما رأيت أَقْعَد منه بفنون العلوم .. ، وصَنَّف التصانيف المفيدة، منها: "شرح البخاري" شرح حسن، ولَخَّص "المهمات" و"التوشيح"، ونَظَم "ألفية" في أصول الفقه لم يُسبق إلى مِثل وَضْعها، وشَرَحها شرحًا حافلًا نحو مجلدين، وكان يقول: "أكثر هذا الكتاب هو جُملة ما حَصَّلْتُ في طول عُمري". وشرح "لامية ابن مالك" شرحًا في غاية الجودة، .. وَحَشى الحواشي المفيدة،
¬__________
(¬1) قال الحافظ ابن حجر في "إنباء الغمر بأبناء العمر، 3/ 488": (الحافظ تاج الدين الكركي ابن الغرابيلي .. أَقْبَل على الحديث بكُليته، فسمع الكثير وعرف العالي والنازل، وقيد الوفيات وغيرها من الفنون .. ، فأقبل على النظر في التواريخ والعِلَل، وسمع الكثير ببلده، ورحل إلى دمشق، ورحل إلى القاهرة فلازمني إلى أنْ حرر نسخته مِن "المشتبه" غاية التحرير .. ، وكان الأكابر يتمنون رؤيته والاجتماع به؛ لِمَا يبلغهم مِن جميل أوصافه، فيمتنع، إلَّا أنْ يَكون الكبير مِن أهل العلم).
وقال الحافظ شمس الدين السخاوي في "الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، 9/ 306": (مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد .. ابن الأمير ناصر الدين السالمي .. ، يُعرف بِـ "ابْن الغرابيلي"، وُلد سنة سِتّ وَتِسْعين وَسَبْعمائة بِالْقَاهِرَةِ حَيْثُ كَانَ جده الْعِمَاد حَاكمًا فِيهَا، وَنَقله أَبوهُ إِلَى الكرك حِين ولي إمرتها؛ فَنَشَأَ بِهِ .. ، قيد الوفيات، وَنظر فِي التواريخ والعلل، وَعرف العالي والنازل والأسماء والإسناد، وبرع فِي ذَلِك جدا. وصَنَّف التصانيف الْحَسَنَة .. ، ورحل إِلَى دمشق ثمَّ إِلَى الْقَاهِرَة، .. مَاتَ .. سَنة خمس وَثَلَاثِينَ، وَصلَّى عَلَيْهِ شَيخُنَا .. وَكَانَت جنَازَته مَشْهُودَة).
قلتُ: نعم إذَا فرَّعنا على أن بيع الغائب باطل، فهل يقوم مقام الرؤية خبر التواتر بضبطه حتى يصير كالمشاهَد؟
قال الروياني في "البحر": (قال بعض أصحابنا بخراسان: فيه طريقان، أحدهما: القطع بجواز البيع كالمرئي، والثاني: قولان). انتهى
الثاني: ذهب الجمهور إلى أن العلم فيه ضروري لا يتوقف على نظر، خلافًا للكعبي، وصرح إمام الحرمين في "البرهان" بموافقته، لكنه قال: (وقد كثرت المطاعن على الكعبي من أصحابه ومن عصبة الحق، والذي أراه تنزيل مذهبه عند كثرة المخبرين على النظر في ثبوت إيالة جامعة وانتفائها، فلم يَعْنِ الرجُل نظرا عقليًّا وفِكرًا [سبريًّا] (¬1) على مقدمات ونتائج، فليس ما ذكره إلا الحق) (¬2). انتهى
وأوضح الغزالي في "المستصفى" ذلك، فقال: (إن تحقيق القول فيه أنه ضروري، بمعنى أنه لا يحتاج في حصوله إلى الشعور بتوسط واسطة مفضية إليه مع أن الواسطة حاضرة في الذهن. وليس ضروريًّا، بمعنى أنه حاصل من غير واسطة) (¬3). انتهى
فرجع حملهما إلى قول الجمهور وأنه لا خلاف في المعنى، فالنقل عنهما أنهما يخالفان في إفادته العلم ضرورة -ليس بجيد.
نعم، نقل الشيخ أبو إسحاق عن البلخي موافقة الكعبي، وحكاه أيضًا غيره عن الدقاق وأبي الحسين. فإنْ حُمل على تأويل إمام الحرمين، ارتفع الخلاف أصلًا، وهذا هو اللائق؛ فإن حصول العلم فيه بالضرورة أمرٌ مشاهَد.
¬__________
(¬1) كذا في (ز). لكن في (ش): مرتبا. وفي سائر النُّسخ: سريا.
(¬2) البرهان (1/ 376).
(¬3) المستصفي (1/ 106).
قرينة.
- وإما لرجحان المجاز حتَّى ساوى الحقيقة.
- وإما لِتَعذُّر الحقيقة مع تَعدُّد المجاز والتساوي فيه، أو نحو ذلك.
وهو معنى قولي بعده: (وَكُلُّ مَا تَسَاوَى) إلى آخِر الأبيات الآتية، فعممتُ الحكم بذلك لكل متساو، وبينتُ به أن الصورتين المتقدمتين مثال، لا للحصر.
واحترزت هنا - بقولي: (لِلاشْتِرَاكِ) إلى آخِره - عن القسم الأول الذي من "المجمل" وهو الذي لم تتضح دلالته لِكَونه لم يُرَد به المعنى الظاهر وأُريد الخفي، ولكن لَمَّا لم تتعين جهة من الخفي، نَشأ من ذلك مسألة: هل يُؤَوَّل المشْكل من الآيات والأحاديث؛ أو يُسْكت عنه؟ وقد سبق التنبيه عليه.
واعلَم أنَّه لا يخفى أن ذلك حيث لم يحمل المشترك والحقيقة والمجاز والمجازين على الكل، فإنْ وجب الحمل حيث أَمكن فلا إجمال، وقد سبق بيان ذلك في محله، والله أعلم.
ص:
452 - فَإنْ يُبَيِّنِ الدَّلِيلُ الْمَقْصَدَا ... مِنْهُ، فَذَا "مُبَيَّن"، أَوْ فُقِدَا
453 - في الْأَصْلِ إجْمَالٌ لَهُ فَيُسْمَى ... "مُبَيَّنًا"، لِقَصْدِ ذَاكَ [رَسْمَا] (¬1)
الشرح:
هذا خبر عن المبتدأ المذكور في آخر البيت الذي قبله، وهو قولي: (وَكُلُّ مَا تَسَاوَى). أي: ما تساوى فيه المحتمل فالحكم فيه ذلك.
¬__________
(¬1) في (ق، ت، ش): رُسِمَا. وفي (ص، ن 1، ن 3): رَسْمَا. وبالثاني ينضبط الوزن.
السادس: تفصيل آخَر، قال ابن الحاجب: (إنه المختار). قال الأصفهاني وغيره: ولا يعرف لغيره أن التخصيص إنْ كان بالاستثناء والبدل يجوز إلى واحد، أو بالمتصل غيرهما -كالصفة- يجوز إلى اثنين، أو بالمنفصل في العام المحصور القليل يجوز إلى اثنين أيضًا. مِثل: "قتلتُ كل زنديق"، وقد قتل اثنين، والزنادقة كانوا ثلاثة. وبالمنفصل غير المحصور أو العدد الكثير يكون المختار القول بإبقاء العدد الذي يَقْرب مِن مدلول العام.
قولي: (إلَّا إذَا كَانَ الْعُمُومُ جَمْعَا) إلى آخِره -بيان لمسألة أقَل الجمع ما هو؟ حتى يترتب عليها بعض المذاهب في المسألة السابقة. وهذا وجه مناسبة ذِكر مسألة "أقَل الجمع" هنا كما ذكرها إمام الحرمين والإمام الرازي وأتباعه. وذكرها جَمعٌ -كابن الحاجب- عقب مسألة: الجمع المنكَّر هل هو للعموم؟ أو لا؟
ولكن هنا أليق؛ لأنَّ مَن يقول بعموم الجمع المنكَّر لا يُعَيِّن الحمل على أقَل الجمع، بل على الأقل أو غيره مما يقتضيه الحال وإنْ كان يُحمل على الأقل حيث لا قرينة، لكنه ليس المقصود من تلك المسألة.
وفي أقل ما ينطلق عليه الجمع مذاهب تُقدَّم عليها مُقدِّمة، وهي: أن الدال على متعدد إما مثنى أو جمع أو اسم جمع أو جنس جمعي أو غير ذلك من الضمائر (كَـ "قمنا" و"قمتم" و"أنتم") أو الإشارة (كَـ"أولئك") أو الموصول (كَـ "الذين") أو غير ذلك مما لا ينحصر. لكن المثنى ونحوه لا غرض لنا فيه، بل في غيره.
فلنبدأ بالجموع؛ لأنها موضوع هذه المسألة غالبًا، ثم نتعرض لبعض ما أشرنا إليه.
فنقول:
الجمع قِسمان:
جمع قِلة: وهو ما يطلق للعَشرة فمَا دُونها.
النار في هرة" (¬1). فالمدار على أن يظهر التعليل فى لفظه في ذلك المحل. والله أعلم.
وقولي: (والثالث الإيماء في التجنب) تمامه قولي بعده:
ص:
806 - أَنْ يُقْرَنَ الْوَصْفُ بِحُكْمٍ، أَيْ وَلَوْ ... مُسْتَنْبَطًا، لَوْ لَمْ يُفِدْ أَوْ مَا رَأَوْا
807 - نَظِيرَهُ عِلِّيَّةً لَبَعُدَا ... وَذَا كتَفْرِيقٍ بِوَصْفٍ قُيِّدَا
808 - أَيْ: بَينَ حُكْمَيْنِ هُمَا قَدْ ذُكِرَا ... أَوْ وَاحِدٌ فَقَطْ، فَكُنْ مُعْتَبِرًا
الشرح:
والمراد بذلك الطريق الثالث مِن طُرق العلة، وهو "الإيماء" للعلة والتنبيه من غير أن يكون فيه نَص لا صريحًا ولا ظاهرًا.
ومنهم مَن يُدْخله في قِسم الظاهر، ويجعل منه ما سبق في الترتيب بِـ "الفاء" في كلام الشارع - صلى الله عليه وسلم - أو في كلام الراوي كما جرى عليه البيضاوي، فإن ظاهره أن [الكل] (¬2) مِن قبيل النَّص على العلة. لكن قال الآمدي والهندي: إن دلالة هذا الطريق على العلة إنما هي بالالتزام؛ لأنه يُفهم التعليل فيه مِن جهة المعنى، لا من جهة اللفظ.
قال الهندي: لأنه لو كان موضوعًا للعلة، لم يُجعل مِن قبيل الإيماء، إذ لا يقال في الموضوع للشيء: إنه إيماءٌ إليه.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (رقم: 3140)، صحيح مسلم (رقم: 2619).
(¬2) كذا في (ص، ق)، لكن في (س): الكلام.