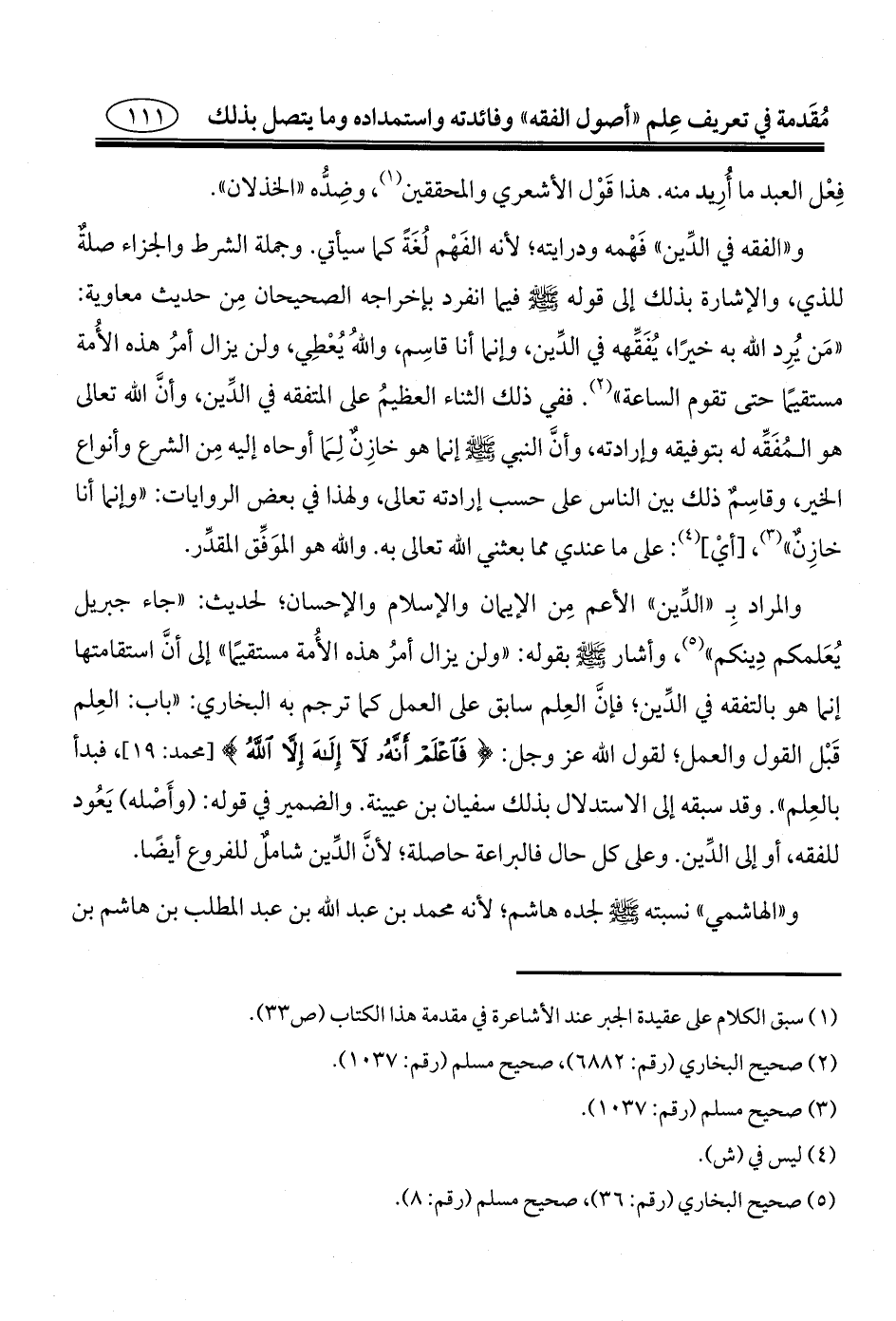
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية
فِعْل العبد ما أُرِيد منه. هذا قَوْل الأشعري والمحققين (¬1)، وضِدُّه "الخذلان".و"الفقه في الدِّين" فَهْمه ودرايته؛ لأنه الفَهْم لُغَةً كما سيأتي. وجملة الشرط والجزاء صلةٌ للذي، والإشارة بذلك إلى قوله - صلى الله عليه وسلم - فيما انفرد بإخراجه الصحيحان مِن حديث معاوية: "مَن يُرِد الله به خيرًا، يُفَقِّهه في الدِّين، وإنما أنا قاسِم، واللهُ يُعطِي، ولن يزال أمرُ هذه الأُمة مستقيمًا حتى تقوم الساعة" (¬2). ففي ذلك الثناء العظيمُ على المتفقه في الدِّين، وأنَّ الله تعالى هو المُفَقِّه له بتوفيقه وإرادته، وأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما هو خازِنٌ لِمَا أوحاه إليه مِن الشرع وأنواع الخير، وقاسِمٌ ذلك بين الناس على حسب إرادته تعالى، ولهذا في بعض الروايات: "وإنما أنا خازِنٌ" (¬3)، [أيْ] (¬4): على ما عندي مما بعثني الله تعالى به. والله هو الموَفِّق المقدِّر.
والمراد بِـ "الدِّين" الأعم مِن الإيمان والإسلام والإحسان؛ لحديث: "جاء جبريل يُعَلمكم دِينكم" (¬5)، وأشار - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "ولن يزال أمرُ هذه الأُمة مستقيمًا" إلى أنَّ استقامتها إنما هو بالتفقه في الدِّين؛ فإنَّ العِلم سابق على العمل كما ترجم به البخاري: "باب: العِلم قَبْل القول والعمل؛ لقول الله عز وجل: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} [محمد: 19]، فبدأ بالعِلم". وقد سبقه إلى الاستدلال بذلك سفيان بن عيينة. والضمير في قوله: (وأَصْله) يَعُود للفقه، أو إلى الدِّين. وعلى كل حال فالبراعة حاصلة؛ لأنَّ الدِّين شاملٌ للفروع أيضًا.
و"الهاشمي" نسبته - صلى الله عليه وسلم - لجده هاشم؛ لأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن
¬__________
(¬1) سبق الكلام على عقيدة الجبر عند الأشاعرة في مقدمة هذا الكتاب (ص 33).
(¬2) صحيح البخاري (رقم: 6882)، صحيح مسلم (رقم: 1037).
(¬3) صحيح مسلم (رقم: 1037).
(¬4) ليس في (ش).
(¬5) صحيح البخاري (رقم: 36)، صحيح مسلم (رقم: 8).
ومما يدل على أنَّ ذلك احتياط في الصوم أنه لا يجري في حلول أَجَل ولا معلق طلاق أو عتق أو نحو ذلك قطعًا إلَّا أن يتأخر التعليق عن ثبوته ويعلق به، فإنه ينصرف عُرفًا إلى الثبوت الذي به الصيام، وهذا [مقتضى] (¬1) ما أشرتُ إليه في الجمع بين النصين مِن كوْن العَدْل الواحد للصوم احتياطًا والعَدْلَين في سائر الأحكام.
نعم، يُعكِّر على هذا الجمع نصوص الشافعي المصرحة بأنه لا يُصام إلا بشهادة عدلين، منها ما قاله في موضع من "الأم"، ولفظه: (ولا يلزم الناس أنْ يصوموا إلا بشهادة عدلين فأكثر، وكذلك لا يُفطرون، وأَحَبُّ إليَّ لو صاموا بشهادة العدل؛ لأنه لا مؤنة عليهم في الصيام. إنْ كان مِن رمضان، أدوه. وإنْ لم يكن، رجوتُ أنْ يُؤجَروا به) (¬2). انتهى.
وهو صريح في أن الصوم بعدل مستحب احتياطًا، لا وجوب فيه، وأن الوجوب بعدلين.
وإنما قلنا في قبول الواحد للصوم (على القول به): إنه شهادة كالرواية في الواحد فقط؛ لِمَا في حديث: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإنْ غم عليكم فاقدروا له" (¬3). زيادة
¬__________
= صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى ترَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ". قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا كَانَ شَعْبَانُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ، نَظَرَ لَهُ، فَإِنْ رُئِيَ فَذَاكَ، وإِنْ لَمْ يُرَ وَلَمْ يَحُلْ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ وَلَا قَتَرَةٌ، أَصْبَحَ مُفْطِرًا. فَإِنْ حَالَ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ أَوْ قَتَرَةٌ، أَصْبَحَ صَائِمًا. قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفْطِرُ مَعَ النَّاسِ، وَلَا يَأْخُذُ بِهَذَا الحسَابِ).
قال الألباني: صحيح. (صحيح سنن أبي داود: 2320).
(¬1) في (ص): يقتضى.
(¬2) الأم (7/ 50 - 51).
(¬3) صحيح البخاري (رقم: 1810)، صحيح مسلم (رقم: 1080).
لكن ابن مالك قد غاير بينهما ومَثَّل التعليلية بقوله تعالى: {ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ} [البقرة: 54]، وقوله تعالى: {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا} [النساء: 160].
ويؤيده ما فَرق به بعضهم بين السببية والتعليل بأن العلة مُوجِبة لمعلولها، بخلاف السبب فإنه أمارة على المسبَّب.
قال: ومن هنا اختلف [أهل السنة] (¬1) والمعتزلة في أن أفعال العبد هل هي عِلة لثوابه وعقابه؟ أو سبب؟
فقال المعتزلة بالأول.
وأهل السنة بالثاني، وفرَّعوا على ذلك الحج عن الغير، فمَن قال: (عِلة)، أبطله؛ لأن عمل زيد لا يكون علة لبراءة عمرو. ومَن قال: (سبب)، قال: يصح؛ لجواز أن يكون سببًا للبراءة وعَلَمًا عليها.
قلتُ: قد سبق أن مذهب أهل السنة أن كُلًّا من السبب والعلة مُعَرِّف، لا موجِب مُؤَثِّر بذاته، فلا فرق حينئذٍ بينهما من هذه الجهة وإنِ افترقا كما سبق من حيث إنَّ العلة فيها مناسبة وملائمة للحُكم، والسبب أَعَم من ذلك؛ فيُكتفَى به؛ ولذلك اقتصرتُ في النَّظم عليه.
الرابع: المصاحبة بمعنى "مع "، كقوله تعالى: {قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ} [النساء: 170] ويغني عنها وعن مصحوبها الحال، فالتقدير هنا: "مُحِقًّا"؛ ولهذا يسميها كثير من النحويين "باء" الحال.
الخامس: الظرفية بمعنى "في" المكانية، نحو: {وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ} [آل عمران: 123]، أو الزمانية، نحو: {وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ (137) وَبِاللَّيْلِ} [الصافات: 137، 138]. وربما كانت الظرفية مجازية، نحو: "بكلامك بهجة".
¬__________
(¬1) كذا في (ص، ش). لكن في (ت، ظ): بين السُّنة. وفي (ق): بين السنية. وفي (ض): بين أهل السنة.
تنبيهات
أحدها: حُكي عن المرتضى مخالفة في كون الشرط مخصِّصًا مخرِجًا لبعض الأفراد كما في الاستثناء، ووافقه صاحب "المصادر" -مِن المعتزلة- على ذلك؛ تَعلُّقًا بأنَّ الشرط إنما يُخرِج بعض الحالات، لا بعض الأفراد. فإنَّ القائل: (أكرم القوم إنْ دخلوا) إنما يفيد تقييد الإكرام بحالة دخولهم، ولولا الشرط لاستحقوا كلهم في كل حال.
وردَّه الجمهور بأنَّ مَن دخل، استحق دُون مَن لم يدخل، فهو تخصيص؛ لإخراجه بعض الأفراد؛ لأن القيد لكل فرد [فرد] (¬1)، لا للمجموع من حيث هو، وإلا لزم في نحو قوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: 6] أنْ لا تستحق مَن أرضعت ولدها إلا أن تُرضع جميع نساء العالم أولادهن، فعند ذلك تستحق الكل الأجر.
الثاني: الشرط المراد هنا ما كان بِـ "إنْ " وما في معناها كما سبق، بخلاف "لو" فإنه شرط في الماضي يقتضي امتناع جوابها؛ لامتناع شرطها كما سبق.
والشرط بِـ "إنْ" وما في معناها متوقَّع في المستقبل إما قطعًا (كَـ: إذا طلعت الشمس فأنت طالق) وإما مع الاحتمال (كـ: إنْ قام زَيد).
فإنْ ورَدَ ما يتوهم أنه لماضٍ، أُوِّل، نحو قوله تعالى حكاية عن عيسى عليه الصلاة والسلام: {إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ} [المائدة: 116]، فإنه إنْ كان قال ذلك في الدنيا فالاستقبال ظاهر، أو يقوله في الآخِرة -وهو الظاهر- فمُؤَوَّل على حذف فِعل مستقبل، نحو: إنْ ثبت أو تبيَّن أني قلتُه فأنت أَعْلم.
¬__________
(¬1) ليس في (ص).
ووجه البناء: أنَّ المعترِض عارَضَ عِلة المستدِل بِعِلة أخرى. فمَن منع التعليل بعلتين، رآه اعتراضًا؛ لِما يَلزم منه مِن تَعدُّد العِلل، وهو ممتنع عنده. ومَن لم يمنع، لم يَره سؤالًا قادحًا؛ لجواز كون الحكم له علتان.
قال ابن السبكي: (وعندي أنه يبنى قبل ذلك على جواز التعليل [بالعلة القاصرة] (¬1)، فإنْ منع، فالفَرْق مردود. وكأنهم سكتوا عن هذا البناء؛ لضعف القول بمنع القاصرة. ثم إذا جَوَّزناه، احتمل أنْ يمنع هذا؛ لتغايُرهما قصورًا وتَعَدِّيًا، واحتمل أن يكون جائزًا؛ إذْ لا تنافي بينهما، وهذا أرجَح. وهو مقتضى كلام ابن السمعاني وغيره) (¬2).
الطريق الثاني: أن يجعل تَعَيُّن الفرع مانعًا مِن ثبوت حُكم الأصل فيه.
كقولهم: يُقاد المسلم بالذمي، قياسًا على غير المسلم، بجامع القتل العمد المحض العدوان.
فيقول المعترِض: إنَّ تَعَيُّن الفرع -وهو الإسلام- مانع مِن وجوب القصاص عليه.
ولعله أيضًا مبني على جواز التعليل بالقاصرة، لكن بناه البيضاوي وغيره على أن النقض مع المانع هل يقدح؟ وقد سبقت المسألة.
¬__________
(¬1) كذا في (ص)، لكن في (س، ق): بالقاصرة.
(¬2) الإبهاج في شرح المنهاج (3/ 135).