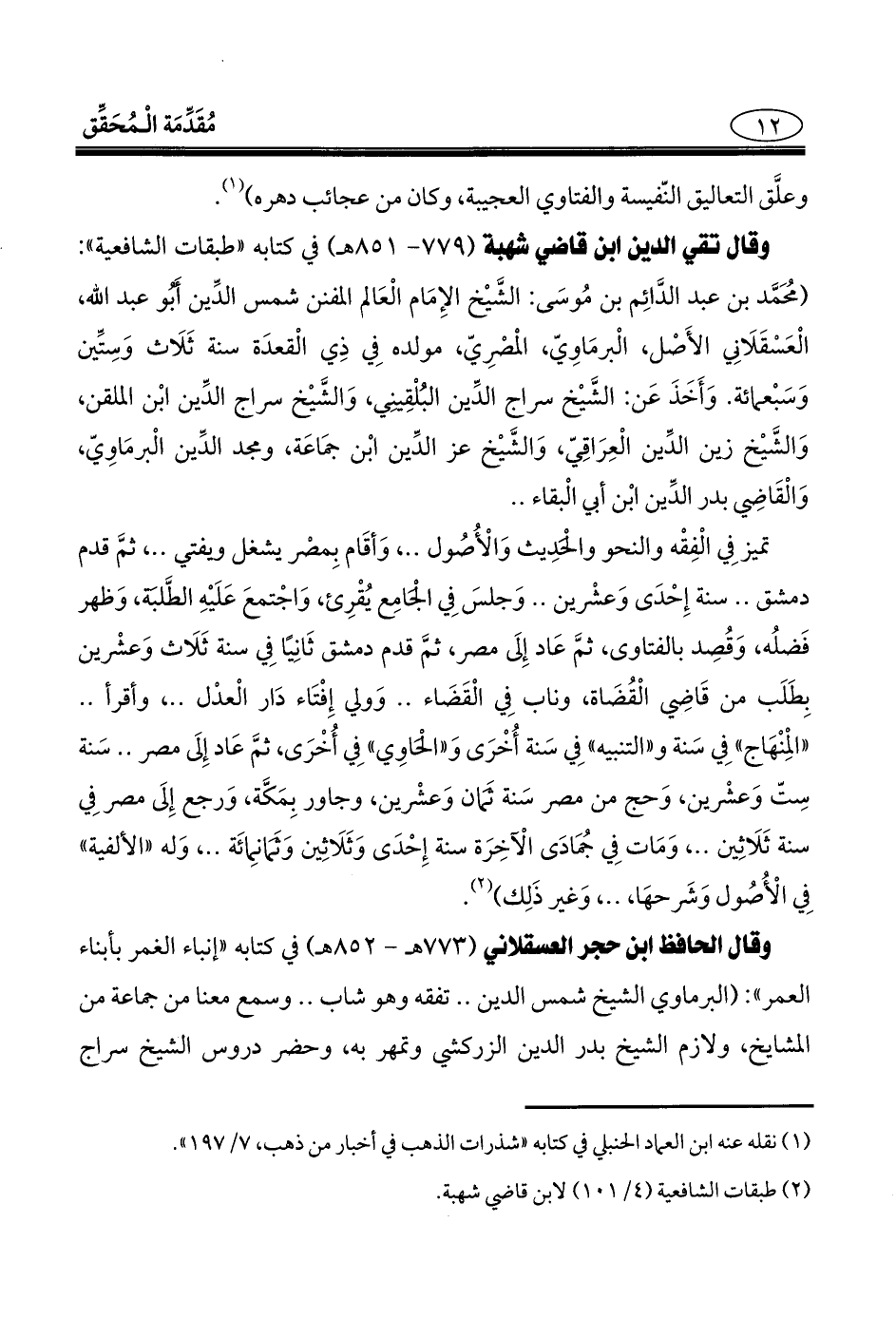
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية
وعلَّق التعاليق النّفيسة والفتاوي العجيبة، وكان من عجائب دهره) (¬1).وقال تقي الدين ابن قاضي شهبة (779 - 851 هـ) في كتابه "طبقات الشافعية": (مُحَمَّد بن عبد الدَّائِم بن مُوسَى: الشَّيْخ الإِمَام الْعَالم المفنن شمس الدِّين أَبُو عبد الله، الْعَسْقَلَانِي الأَصْل، الْبرمَاوِيّ، الْمصْرِيّ، مولده فِي ذِي الْقعدَة سنة ثَلَاث وَسِتِّين وَسَبْعمائة. وَأَخَذَ عَن: الشَّيْخ سراج الدِّين البُلْقِينِي، وَالشَّيْخ سراج الدِّين ابْن الملقن، وَالشَّيْخ زين الدِّين الْعِرَاقِيّ، وَالشَّيْخ عز الدِّين ابْن جمَاعَة، ومجد الدِّين الْبرمَاوِيّ، وَالْقَاضِي بدر الدِّين ابْن أبي الْبقاء ..
تميز فِي الْفِقْه والنحو والْحَدِيث وَالْأُصُول .. ، وَأقَام بِمصْر يشغل ويفتي .. ، ثمَّ قدم دمشق .. سنة إِحْدَى وَعشْرين .. وَجلسَ فِي الجْامِع يُقْرِئ، وَاجْتمعَ عَلَيْهِ الطَّلبَة، وَظهر فَضلُه، وَقُصِد بالفتاوى، ثمَّ عَاد إِلَى مصر، ثمَّ قدم دمشق ثَانِيًا فِي سنة ثَلَاث وَعشْرين بِطَلَب من قَاضِي الْقُضَاة، وناب فِي الْقَضَاء .. وَولي إِفْتَاء دَار الْعدْل .. ، وأقرأ .. "الْمِنْهَاج" فِي سَنة و"التنبيه" فِي سَنة أُخْرَى وَ"الْحَاوِي" فِي أُخْرَى، ثمَّ عَاد إِلَى مصر .. سَنة سِتّ وَعشْرين، وَحج من مصر سَنة ثَمَان وَعشْرين، وجاور بِمَكَّة، وَرجع إِلَى مصر فِي سنة ثَلَاثِين .. ، وَمَات فِي جُمَادَى الْآخِرَة سنة إِحْدَى وَثَلَاثِين وَثَمَانِمائَة .. ، وَله "الألفية" فِي الْأُصُول وَشَرحهَا، .. ، وَغير ذَلِك) (¬2).
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني (773 هـ - 852 هـ) في كتابه "إنباء الغمر بأبناء العمر": (البرماوي الشيخ شمس الدين .. تفقه وهو شاب .. وسمع معنا من جماعة من المشايخ، ولازم الشيخ بدر الدين الزركشي وتمهر به، وحضر دروس الشيخ سراج
¬__________
(¬1) نقله عنه ابن العماد الحنبلي في كتابه "شذرات الذهب في أخبار من ذهب، 7/ 197".
(¬2) طبقات الشافعية (4/ 101) لابن قاضي شهبة.
نعم، في المسألة قول ثالث: إنه يفيد عِلمًا بين المكتسَب والضروري. قاله صاحب "الكبريت الأحمر". فإنْ عَنَى ما قاله الإمام فظاهر، وإلا فلا حاصل له.
وقول رابع: وهو التوقف في المسألة. قاله الشريف المرتضَى، وصححه صاحب " المصادر"، واختاره الآمدي.
الأمر الثالث: الشروط:
أحدها: تَعدُّد المخبرين.
ثانيها: أن يبلغوا ما يمتنع في مثله التواطؤ على الكذب عُرْفًا. وهل لذلك عدد معين؟ الصحيح المنع، وسيأتي بيان ذلك.
ثالثها: الاستناد للحس أو للعلم الضروري كما سبق بيان الخلاف فيه.
ولا يخفَى خروج هذه من التعريف.
رابعها: كون السامع له غير عالم بمدلوله ضرورةً أو استدلالًا، كالإخبار بأن السماء فوق الأرض، وبأن العالَم حادث لمن هو مسلم.
وهذا خارج من قولنا: (يفيد العلم)؛ لأنه لم يُفِد شيئًا؛ لأن العلم بذلك كان حاصلًا.
وخامسها: أن لا يكون السامع معتقدًا خلافه؛ لأن اعتقاده يمنع من حصول العلم من التواتر. شَرَطَه المرتضى. قيل: لِيثبت به تواتُر إمامة علي - رضي الله عنه -، وأنَّ المانع من إفادة السامعين العِلم اعتقادهم خلافه.
ورُدَّ بأنَّ ذلك بُهت منه؛ فلَم يُنقل ذلك فضلًا عن تواتره، ثُم الاعتقاد لا يدفع أن يحصل من التواتر ما يرفعه ويزيله؛ لأنَّ الفَرْض فيمن يستحيل تواطؤهم على الكذب.
سادسها: كوْن المخبرين قاطعين بذلك. شَرَطه جمعٌ، كالقاضي، لكن قال ابن الحاجب: إنه غير محتاج إليه؛ لأنه إنْ أُريدَ عِلم الجميع فباطل؛ لجواز أن يكون بعضهم ظانًّا، ومع ذلك
ودخلت الفاء في خبر المبتدأ، لتضمُّنه معنى الشرط، أي: إذا عرف معنى "المجمل" وأنه ما لم تتضح دلالته؛ لِتَسَاوي ما يحتمله، فإنْ دَل دليل على المقصود منه، سُمي "مُبَيَّنًا" بالفتح، اسم مفعول مِن: بَيَّنه تبيينًا.
وربما سُمي بِ "المُبَيِّن" ما لم يكن مُجْمَلًا قط وإنَّما هو واضح من الابتداء؛ لكونه بُيِّن، أي: قُصِد فيه البيان وإن لم يطرأ عليه، فالمبيَّن نوعان.
وهو معنى قولي: (لِقَصْدِ ذَاكَ رَسْمًا)، أي: لأجل ذلك رُسم بهذا الاسم، وإنَّما عللتُ تسمية الثاني "مُبينًا" بالقصد؛ لأن الأول لا يحتاج [في] (¬1) تسميته بذلك لتعليل.
و"المقصَد" بفتح الصاد بمعنى القصد، لأن "المَفْعَل" منه بالفتح: المصدر، وبالكسر: المكان والزمان. ثم يحتمل أنْ يُراد به المفعول، أي: المقصود، ويحتمل بقاؤه على المصدرية، فالمعنى صحيح على التقديرين، والله أعلم.
ص:
454 - وَإنْ عَلَى الْمَرْجُوحِ جَا دَلِيلُ ... فَتَرْكُ ظَاهِرٍ لَهُ تَأْوِيل
455 - صَحِيح، أوْ مَا أَشْيَهَ الدَّلِيلَا ... فَفَاسِدٌ، وَلَيْسَ ذَا مَقْبُولَا
456 - أَوْ لَا لِشَيْءٍ أَبَدًا فَلَعِبُ ... وَلَيْسَ في التَّأْوِيلِ هَذَا يُحْسَبُ
الشرح:
لَمَّا سبق أن المتشابه نوعان: مجمل، و [مؤَوَّل] (¬2)، وبينتُ آنفًا أن المجمل يزول إجماله
¬__________
(¬1) من (ق).
(¬2) في (ص، ق، ظ): مشكل.
وجمع كثرة: وهو ما يُطلق لأحد عشر فصاعدًا إلى ما لا نهاية له.
وجمع القِلة منحصر في نوعين:
أحدهما: جموع التصحيح وهو: ما سَلِمَ فيها بناءُ الواحد، سواء كانت لمذكر نحو: "مسلمين" أو مؤنث نحو: "مسلمات".
وثانيهما: أربعة من جموع التكسير، جمعها بعض القدماء في قوله:
بأفعُلٍ وبأفعالٍ وأفعِلةٍ ... وفِعْلةٍ يعرف الأدنى من العددِ
وزاد -في ضم جمعي التصحيح إليها أبو الحسن الدَّباج من نحاة أشبيلية -بيتًا، فقال:
وَسَالِمُ الْجَمْعِ أَيْضًا دَاخِلٌ مَعَهَا ... في ذلك الحكم، فَاحْفَظْهَا وَلَا تَزِدْ
ودليل كون النوعين للقِلة الاستقراءُ، فإنهم لا يفسرون العدد القليل إلا بها، كَـ"ثلاثة أفلُس"، و"أربعة أجمال"، و"خمسة أرغِفة"، و"سبعة صِبية"، و"سبع بَنين" و "تسع شجرات" ونحو ذلك.
وعلَّل النحاة ذلك في جمع التصحيح بأنه على حَد المثنى، فوجب قِلته وحصره. وفي الأربعة من التكسير بأنها تُصَغَّر على لفظها كالمفرد، وغيرها من جموع التكسير إنما تُصَغَّر على إفراد واحدها ثم يجمع بِـ "الواو والنون" في العاقل، وبـ "الألف والتاء" في غيره، فيقال: "رُجَيْلون" و"دريهمات".
نعم، قد يقوم جمع القِلة مقام جمع الكثرة، وبالعكس، كما في قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] فإن المطلقات في غاية الكثرة، وجمعها بالألف والتاء، وأكَدَها في قوله: {بِأَنْفُسِهِنَّ} بجمع قِلة.
واستعمل جمع الكثرة وهو "قروء" في ثلاثة، وربما كان ذلك استغناءً بما لا يستحق عما يستحق، كـ"رجال" ليس له جمع قِلة، و"أقلام" ليس له جمع كثرة.
وفيما [قالا] (¬1) نظر؛ لأن ما كان بـ "الفاء" ونحوه مِن حروف العلة يُعَد مِن قبيل النص كما ذكرناه، وإنما الذي مِن قبيل اللزوم ما سيأتي، ومع ذلك لا يخرج عن كونه مِن قبيل النص المقابل للاستنباط.
فـ "الإيماء": هو اقتران الوصف بحكم لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل لكان ذلك الاقتران بعيدًا مِن فصاحة كلام الشارع وإتيانه بالألفاظ في مواضعها؛ لِتَنزُه كلامه عن الحشو الذي لا فائدة فيه.
وهو على خمسة أوجه:
أحدها:
أن يحكم عقب عِلمه بصفة المحكوم عليه وقد أَنْهَى إليه المحكوم عليه حالَه، كقول الأعرابي: "واقعتُ أهلي في نهار رمضان". فقال: "أعتِق رقبة" (¬2). أخرجه الأئمة الستة، وهذا لفظ ابن ماجه. فكأنه قيل: كفِّر؛ لكونك واقعتَ في نهار رمضان. فكأنَّ الحرف الذي ترَتَّب به الحكم لفظًا موجود هنا، فيكون موجودًا تقديرًا. هذا هو الذي يغلب على الظن مِن ذلك، ولا التفات إلى احتمال أن يكون ابتداء كلام أو جواب سؤال أو زجرًا للسائل عن الكلام، كقول السيد لعبده إذا سأله عن شيء: اشتغل بشأنك.
أيضًا فكان يلزم خلو السؤال عن الجواب وتأخير البيان عن وقت الحاجة.
فإنْ حذف شيء من الأوصاف المرتَّب عليها الجواب لكونه لا مَدخل له في العِلية، نحو أن يقال: (في يوم كذا) أو: (للشخص الفلاني)، فيسمَّى إخراج ذلك مِن الاعتبار "تنقيح
¬__________
(¬1) كذا في (ق، ص)، لكن في (س): قالاه.
(¬2) سبق تخريجه.