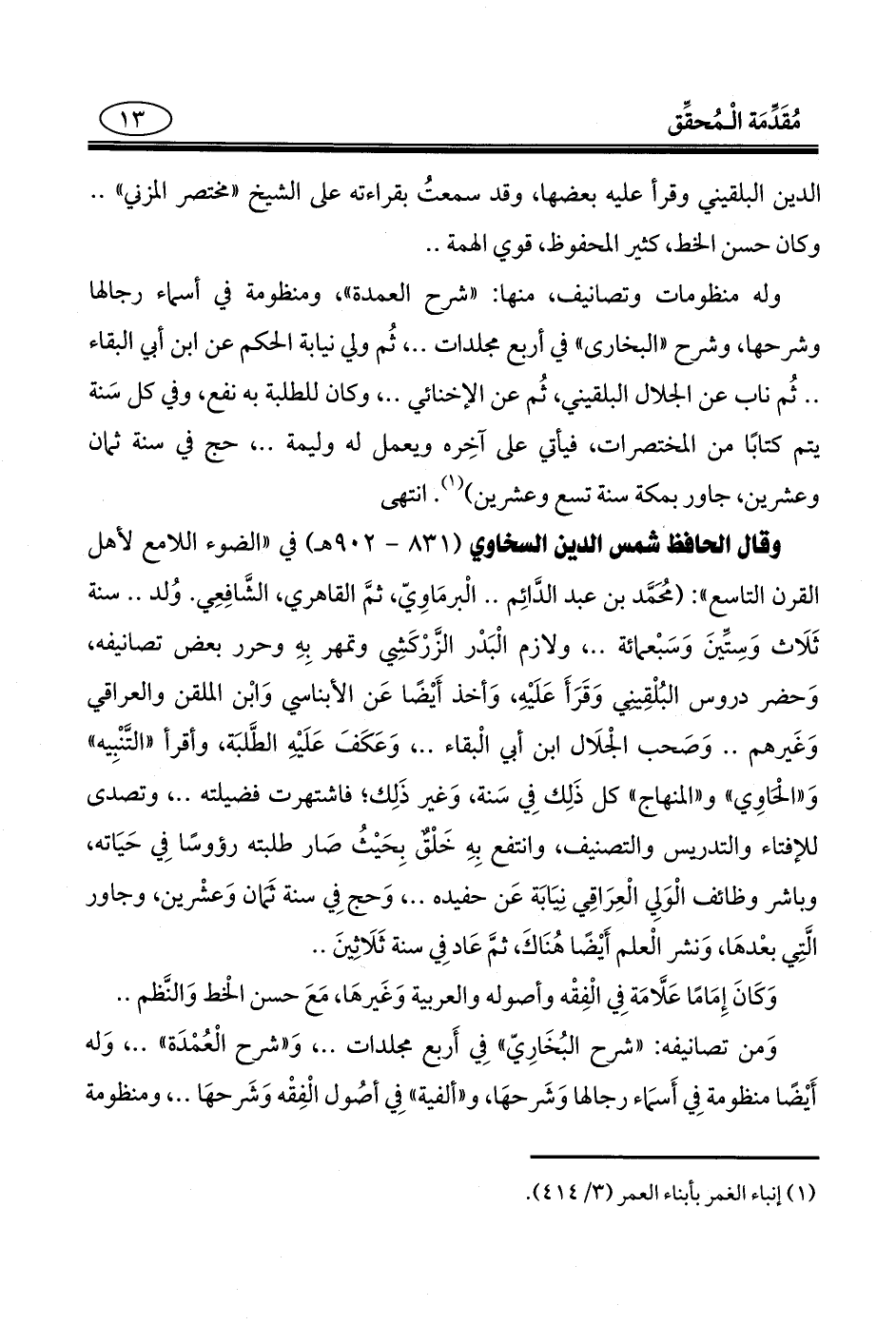
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية
الدين البلقيني وقرأ عليه بعضها، وقد سمعتُ بقراءته على الشيخ "مختصر المزني" ..وكان حسن الخط، كثير المحفوظ، قوي الهمة ..
وله منظومات وتصانيف، منها: "شرح العمدة"، ومنظومة في أسماء رجالها وشرحها، وشرح "البخارى" في أربع مجلدات .. ، ثُم ولي نيابة الحكم عن ابن أبي البقاء .. ثُم ناب عن الجلال البلقيني، ثُم عن الإخنائي .. ، وكان للطلبة به نفع، وفي كل سَنة يتم كتابًا من المختصرات، فيأتي على آخِره ويعمل له وليمة .. ، حج في سنة ثمان وعشرين، جاور بمكة سنة تسع وعشرين) (¬1). انتهى
وقال الحافظ شمس الدين السخاوي (831 - 902 هـ) في "الضوء اللامع لأهل القرن التاسع": (مُحَمَّد بن عبد الدَّائِم .. الْبرمَاوِيّ، ثمَّ القاهري، الشَّافِعِي. وُلد .. سنة ثَلَاث وَسِتِّينَ وَسَبْعمائة .. ، ولازم الْبَدْر الزَّرْكَشِي وتمهر بِهِ وحرر بعض تصانيفه، وَحضر دروس البُلْقِينِي وَقَرَأَ عَلَيْهِ، وَأخذ أَيْضًا عَن الأبناسي وَابْن الملقن والعراقي وَغَيرهم .. وَصَحب الْجلَال ابن أبي الْبقاء .. ، وَعَكَفَ عَلَيْهِ الطَّلبَة، وأقرأ "التَّنْبِيه" وَ"الْحَاوِي" و"المنهاج" كل ذَلِك فِي سَنة، وَغير ذَلِك؛ فاشتهرت فضيلته .. ، وتصدى للإفتاء والتدريس والتصنيف، وانتفع بِهِ خَلْقٌ بِحَيْثُ صَار طلبته رؤوسًا فِي حَيَاته، وباشر وظائف الْوَلِي الْعِرَاقِي نِيَابَة عَن حفيده .. ، وَحج فِي سنة ثَمَان وَعشْرين، وجاور الَّتِي بعْدهَا، وَنشر الْعلم أَيْضًا هُنَاكَ، ثمَّ عَاد فِي سنة ثَلَاثِينَ ..
وَكَانَ إِمَامًا عَلَّامَة فِي الْفِقْه وأصوله والعربية وَغَيرهَا، مَعَ حسن الْخط وَالنَّظم ..
وَمن تصانيفه: "شرح البُخَارِيّ" فِي أَربع مجلدات .. ، وَ"شرح الْعُمْدَة" .. ، وَله أَيْضًا منظومة فِي أَسمَاء رجالها وَشَرحهَا، و"ألفية" فِي أصُول الْفِقْه وَشَرحهَا .. ، ومنظومة
¬__________
(¬1) إنباء الغمر بأبناء العمر (3/ 414).
يحصل العلم. وإنْ أُريدَ عِلم البعض فلازم مِن لازم اشتراط الحس.
سابعها: اشتراط أن يكون المخبرون على صفة يوثَق بهم معها، لا كالمتلاعب والمكرَه، ولكن هذا مفهوم من استحالة التواطؤ على الكذب؛ لأن اللاعب والمكرَه قد يكذب لأجل ذلك، وإذا جوز السامع كذبه، فلا يفيده عِلمًا.
وثامنها: أن يتوافق إخبارهم لفظًا ومعنًى، أو معنًى فقط كما سيأتي بيانه، وهذا مفهوم من اشتراط التواطؤ، ومثلهم لا يتواطئون على كذب، والله أعلم.
ص:
263 - وَلَيْسَ فِيهِ عَدَدٌ مُعَيَّنُ ... لَكِنَّ ذَا أَرْبَعَةٍ لَا يُمْكِنُ
الشرح:
سبق أن المخبرين شرطهم أن يبلغوا مَبْلغًا يحيل تواطؤهم على الكذب بما أخبروا به، فهل لذلك عدد معيَّن؟ أو لا؟
الأصح لا؛ إذِ الضابط أن يفيد العلم بسبب استحالة تواطؤهم على الكذب، والأعداد لا مدخل لها في ذلك، فكم من قليل يتصف بذلك، وكثير لا يتصف به.
نعم، الأربعة لا يمكن أن يكون تواتُرًا، لأن قولهم لو كان [يفيد العلم] (¬1) لاستحالة تواطئهم على الكذب، لَمَا وَجب على القاضي أن يستزكي الأربعة في حد الزنا مثلًا، ولكنه واجب قطعًا؛ فوجب أن لا يفيد العلم إلا ما زاد مِن غير تعيين.
وقيل: يتعين الخمسة عدد أُولي العزم من الرُّسل على قول مَن فسرهم به، وهُم: نوح،
¬__________
(¬1) في (ز، ش): مفيدا للعلم.
بدليل يجيء مبيِّنًا للمقصود منه، بينتُ هنا أن القِسم الآخَر يتضح إذا قام على بيان المراد منه دليل، فيخرج بذلك عن "المتشابه".
وحقيقة هذا النوع أن يكون حملُ اللفظ على حقيقته الظاهرة منه متعذِّرًا؛ لاستحالتها عقلًا أو نقلًا، فيجب حيلَهُم ذٍ طرح ذلك الظاهر قطعًا، ثم يُنظر: فإنْ جاء دليل يدل على إرادة المرجوح عقليًّا أو نقليًّا، وَجَبَ الحمل عليه، وسُمي حينئذٍ "تأويلًا"، وهو مصدر "أَوَّلتُ الشيء": فسرتُه، مِن "آلَ": إذا رجع؛ لأنه رجوع من الظاهر إلى ذلك الذي آلَ إليه مِن دلالة اللفظ، وهو معنى قول صاحب "المقاييس": (تأويل الكلام: عاقبته، قال تعالى: {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ} [الأعراف: 53]، أي: ما يؤول إليه في بعثهم ونشورهم) (¬1).
ويجوز أن يكون مِن"الإيالة" وهي السياسة، فكأنه يسوس اللفظ إلى أن يستخرج معناه القصود منه.
وللناس كلام في الفرق بين التفسير والتأويل، قال الراغب: (أكثر ما يستعمل "التأويلُ" في المعاني و"التفسيرُ" في الألفاظ، وأكثره في مفردات الألفاظ، و"التَّأويلِ أكثره في الجُمل" (¬2).
ويُسمَّى هذا "التَّأويلِ" الذي لدليل: "تأويلًا صحيحًا". فإنْ تُرك الظاهر لا لدليل محقق بل لشبهة تُخَيَّل للسامع أنَّها دليل وعند التحقيق تضمحل، يُسمى "تأويلًا فاسدًا"، أو ربما قيل له: "تأويل بعيد"، كما سيأتي في موضعه ذِكر أمثلة من النوعين.
فإنْ عدل عن الظاهر لا لدليل ولا شُبهة دليل فهو ضربٌ من اللعب، ولا يُعد من التَّأويلِ، ولا يحسب بالكُلية.
¬__________
(¬1) مقاييس اللغة (1/ 162).
(¬2) تفسير الراغب الأصفهاني (1/ 11).
نعم، مقتضى قول سيبويه وجمع من أئمة النحو في التعبير عن ذلك بأنه قد "يُستعار كذا لكذا" أنَّ ذلك مجازٌ، وأن الحقيقة التفرقة السابقة.
فأول المذاهب في أقَل الجمع أنه ثلاثة، ولا يستعمل في الاثنين إلا مجازًا.
وإليه ذهب الأكثرون، منهم الشافعي وأبو حنيفة، واختاره الإمام الرازي وأتباعه كالبيضاوي، وكذا ابن الحاجب في "مختصره الكبير"، أما في "الصغير" فسيأتي ما وقع له فيه.
وربما رُوي هذا القول عن مالك، حكاه عنه عبد الوهاب، لكن المشهور عنه ما سيأتي. ورُوي عن عثمان وابن مسعود وابن عباس - رضي الله عنهما -. وممن نقله عن نَص الشافعي الروياني في "البحر" في "كتاب العدد"، قال: (وهو مشهور مذهب أصحابنا) (¬1).
وقال إمام الحرمين: إنه ظاهر مذهب الشافعي. وقال إلْكِيا: هو مختار الشافعي. ونقله القاضي أبو الطيب عن أكثر أصحابنا، وقال الأستاذ أبو إسحاق: إنه ظاهر المذهب. ونقل أيضًا عن نَص الشافعي في "الرسالة"، ونقله أَبو الخطاب -من الحنابلة- عن نَص أحمد، وحكاه ابن الدهان عن جمهور النحاة، وفي "شرح الكتاب" لابن خروف أنه مذهب سيبويه.
قال القفال الشاشي في "أصوله": ولهذا جعل الشافعي أقَل ما يعطى من الفقراء والمساكين -أيْ من الزكاة- ثلاثة، وفي الوصية للفقراء أقَلهم ثلاثة.
قال: لأن السِّمات دلائل على المسميات، وقد جعلوا للمفرد والمثنى صيغة، فلا بُدَّ أن يكون للجمع صيغة بخلافهما.
الثاني من المذاهب: أن أقَله اثنان. وبه قال القاضي أبو بكر، وحكاه هو وابن خويز منداد عن مالك، واختاره الباجي.
¬__________
(¬1) بحر المذهب (11/ 255).
المناط" كما سيأتي بيانه.
الثاني:
أنْ يُقَدر في كلام الشارع وَصْف لو لم يكن للتعليل لكان بعيدًا كما تَقدم، سواء أكان ذلك التقدير في محل السؤال أو في نظيره.
ففي محل السؤال كقوله - صلى الله عليه وسلم - وقد سُئل عن بيع الرطب بالتمر: "أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذَن" (¬1). رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن خزيمة والحاكم.
فلو لم يكن تقدير نقصان الرطب بالجفاف لأجل التعليل لكان تقديره بعيدًا؛ إذ لا فائدة فيه حينئذٍ، والجواب يتم [بدُونه] (¬2).
ونحو ذلك حديث: "إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات" في دخوله في بيت فيه هِر وامتناعه مِن دخول بيت فيه كلب لَمَّا قِيل له: "إنك تدخل على بني فلان وعندهم هرة". فقال: "إنها ليست بنجسه، إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات" (¬3).
ومثال التقدير في النظير: ما رُوي في الكتب الستة: "أنه - صلى الله عليه وسلم - لما سألته الخثعمية: إنَّ أبي
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.
(¬2) كذا في (ص)، لكن في (ق، س): دونه.
(¬3) قال الإمام أبو زرعة ابن العراقي في كتابه (التحرير، ص 410) بتحقيقي: (وهو بهذا السياق غير معروف في كُتب الحديث أصلًا، ومَن عزاه هكذا إلى أصحاب السنن الأربعة فقد أخطأ؛ فإنَّ الذي فيها حديث إصغاء الإناء للهرة وقوله: "إنها ليست بنجس؛ إنها من الطوافين عليكم والطوافات" مِن غير ذِكر الكلب أصلًا. والقصة التي فيها ذِكر الكلب رواها أحمد في مسنده، وفيها أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاب بقوله: "الهرة سبع").