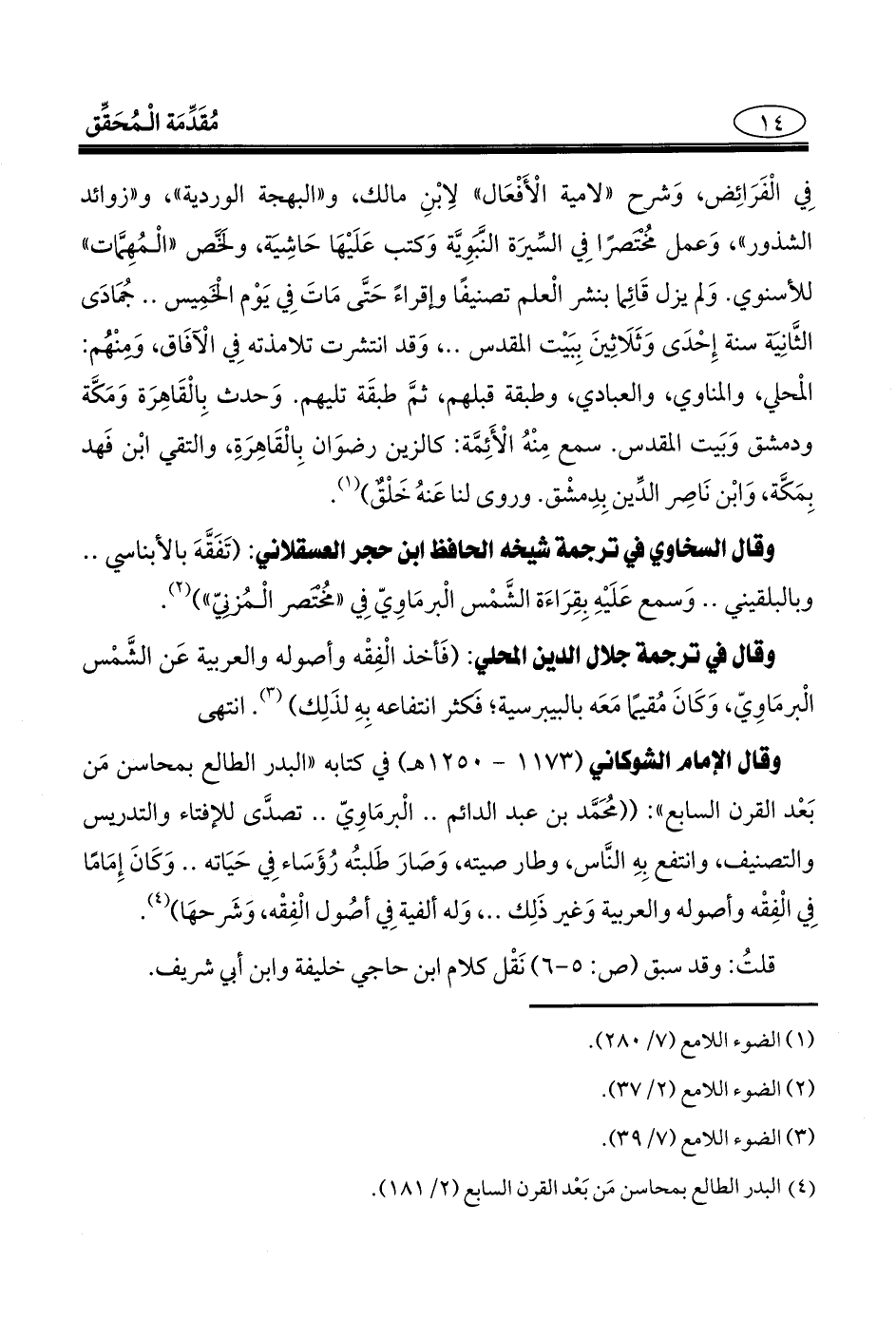
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية
فِي الْفَرَائِض، وَشرح "لامية الْأَفْعَال" لِابْنِ مالك، و"البهجة الوردية"، و"زوائد الشذور"، وَعمل مُخْتَصرًا فِي السِّيرَة النَّبَوِيَّة وَكتب عَلَيْهَا حَاشِيَة، ولَخَّص "الْمُهِمَّات" للأسنوي. وَلم يزل قَائِما بنشر الْعلم تصنيفًا وإقراءً حَتَّى مَاتَ فِي يَوْم الْخَمِيس .. جُمَادَى الثَّانِيَة سنة إِحْدَى وَثَلَاثِينَ بِبَيْت المقدس .. ، وَقد انتشرت تلامذته فِي الْآفَاق، وَمِنْهُم: الْمحلي، والمناوي، والعبادي، وطبقة قبلهم، ثمَّ طبقَة تليهم. وَحدث بِالْقَاهِرَة وَمَكَّة ودمشق وَبَيت المقدس. سمع مِنْهُ الْأَئِمَّة: كالزين رضوَان بِالْقَاهِرَةِ، والتقي ابْن فَهد بِمَكَّة، وَابْن نَاصِر الدِّين بِدِمشْق. وروى لنا عَنهُ خَلْقٌ) (¬1).وقال السخاوي في ترجمة شيخه الحافظ ابن حجر العسقلاني: (تَفَقَّهَ بالأبناسي .. وبالبلقيني .. وَسمع عَلَيْهِ بِقِرَاءَة الشَّمْس الْبرمَاوِيّ فِي "مُخْتَصر الْمُزنِيَ") (¬2).
وقال في ترجمة جلال الدين المحلي: (فَأخذ الْفِقْه وأصوله والعربية عَن الشَّمْس الْبرمَاوِيّ، وَكَانَ مُقيمًا مَعَه بالبيبرسية؛ فَكثر انتفاعه بِهِ لذَلِك) (¬3). انتهى
وقال الإمام الشوكاني (1173 - 1250 هـ) في كتابه "البدر الطالع بمحاسن مَن بَعْد القرن السابع": ((مُحَمَّد بن عبد الدائم .. الْبرمَاوِيّ .. تصدَّى للإفتاء والتدريس والتصنيف، وانتفع بِهِ النَّاس، وطار صيته، وَصَارَ طَلبتُه رُؤَسَاء فِي حَيَاته .. وَكَانَ إِمَامًا فِي الْفِقْه وأصوله والعربية وَغير ذَلِك .. ، وَله ألفية فِي أصُول الْفِقْه، وَشرحهَا) (¬4).
قلتُ: وقد سبق (ص: 5 - 6) نَقْل كلام ابن حاجي خليفة وابن أبي شريف.
¬__________
(¬1) الضوء اللامع (7/ 280).
(¬2) الضوء اللامع (2/ 37).
(¬3) الضوء اللامع (7/ 39).
(¬4) البدر الطالع بمحاسن مَن بَعْد القرن السابع (2/ 181).
وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد - صلى الله عليه وسلم -.
وقال القاضي: أقطع بأن قول الأربعة لا يكفي، وأتوقف في الخمسة. وحكى عن صاحب أبي الهذيل المعروف بأبي عبد الرحمن أنه شرط خمسة من المؤمنين أولياء الله ومعهم سادس ليس منهم؛ حتى يكون ملتبسًا فيهم. قال القاضي: وخالف ذلك سائر الذاهب.
وقيل: يشترط عشرة. وينسب للإصْطَخْري؛ لأن ما دُونها جمع قِلة.
وقيل: اثنا عشر؛ لأنهم عدد النقباء؛ لأن موسى عليه السلام بعثهم ليعرفوا أحوال بني إسرائيل؛ ليحصل العلم بقولهم.
وقيل: عشرون؛ لقوله تعالى: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ} [الأنفال: 65] الآية. نُقل عن أبي الهذيل وغيره من المعتزلة، وقيده الصيرفي بما إذا كانوا عدولًا، لكن المصابرة في القتال لا عُلْقَة لها بالأخبار، وأيضًا فقد نُسخ ذلك، فينبغي أن يقال بما نُسخ به وهو المائة التي قيل فيها: تغلب مائتين.
وقيل: أربعون، عدد الجمعة، ولقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [الأنفال: 64] وكانوا أربعين.
وقيل: سبعون، لقوله تعالى: {وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا} [الأعراف: 155].
وقيل: ثلاثمائة وبضعة عشر، عدد أهل بدر؛ لأنهم يحصل بخبرهم العلم للمشركين. و"البِضع" بكسر الباء: ما بين الثلاثة إلى التسعة. وفي "التقريب" للقاضي و"البرهان" للإمام و"الوجيز" لابن بَرهان و"إحكام" الآمدي تعيينهم بثلاثة عشر، وهو قولٌ في عدتهم حكاه الدمياطي.
وقيل: وعشرة. وقيل: وخمسة، وهو الذي في كتب الحديث، ولكنه لا يُباين رواية "وثلاثة عشر" كما تَوَهمه الدمياطي؛ لأن الذين خرجوا للقتال ثلاثمائة وخمسة، وأدخل النبي
وقد عُلم مما قررناه أن حَمْل اللفظ على ظاهره ليس مِن التَّأويلِ، وأن حمل المشترك ونحوه مِن [المتساوي] (¬1) على أحد محمليه أو محامله لدليل لا يُسمى تأويلًا، وأن حمله على المجموع لا يُسمى تأويلًا أيضًا، والله أعلم.
ص:
457 - فَإنْ تَوَقَّفَتْ عَلَى إضْمَارِ ... دِلَالَةُ النُّطْقِ لِصِدْقٍ جَارِ
458 - أَوْ صِحَّةٍ عَقْلًا يُرَى أَوْ شَرْعَا ... فَهْوَ اقْتِضَاءٌ كلُّهُ، فَيُرْعَى
459 - كَـ "رُفِعَ الْخَطَا" وَمثْلُ "وَاسْأَلِ" ... وَ"أَعْتِقِ الْعَبْدَ عَلَيَّ"، فَاقْبَل
الشرح:
أي: من دلالة المنطوق على المراد منه:
صريح: وهو ما وُضع اللفظ له، فيدل عليه بالمطابقة أو التضمُّن، حقيقةً أو مجازًا.
وغير صريح: وهو ما دل [على] (¬2) غير ما وُضِع له، وإنَّما يدل من حيث إنه لازم له، فهو دالٌّ عليه بالالتزام.
وقَسَّمه ابن الحاجب إلى ثلاثة أقسام: اقتضاء، وإشارة، وإيماء؛ لأنه إما أن يكون مقصودًا للمتكلِّم ولكن توقف على ما يصححه، أو لم يتوقف، أو يكون غير مقصود للمتكلم.
فالأول - وهو ما توقفت دلالته على مُقَدَّر آخَر - يُسمى "دلالة الاقتضاء"، وإليها
¬__________
(¬1) كذا في (ص، ز)، لكن في (ت): المساوي.
(¬2) في (ز): عليه في.
ونقله صاحب "المصادر" عن أبي يوسف، قال: ولهذا ذهب إلى انعقاد صلاة الجمعة باثنين سوى الإمام. فجعل قوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9] اثنين يسعيان فصاعدًا إلى الإمام.
لكن أنكر ذلك عن أبي يوسف شمسُ الأئمة السرخسي، وقال: (إن عنده الجمع الصحيح ثلاثة كما يقوله محمد فيما نَص عليه في "السير الكبير") (¬1).
وقال ابن حزم: (إنَّ كون أقل الجمع اثنين قولُ جمهور أهل الظاهر) (¬2). ثم اختار خِلافه.
وحكاه سليم عن الأشعرية وبعض المحدثين، وحكاه ابن الدهان النحوي عن محمد بن داود وأبي يوسف والخليل ونفطويه، واختاره الغزالي.
وربما احتُج لذلك بقوله تعالى: {قَالُوا يَامُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ} [الأعراف: 138]، فسألوا إلهًا مع الله؛ لتكون الآلهة اثنين، تَعالَى الله عن ذلك، لا إله غيره.
وُيروى هذا القول أيضًا عن عمر وزيد بن ثابت - رضي الله عنهما -.
واعلَم أن ما نُقل من ذلك عن الصحابة إنما أُخذ من اختلافهم في حجب الأم عن الثلث إلى السدس بأخوين أو بثلاثة، لا أنهم تكلموا في أقَل الجمع بخصوصه.
وربما كان مَأخذ مَن قال باثنين غير ذلك، كما روى ابن خزيمة والبيهقي وابن عبد البر بسندٍ -وإن كان متكلَّمًا فيه- إلى ابن عباس في الاستدلال على ذلك، ولكن الحاكم رواه، وقال: صحيح الإسناد: أنه دخل على عثمان، فقال له: (إن الأخوين لا يردان الأم إلى السدس، فإنما قال الله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} [النساء: 11]، والأخوان في لسان قومك
¬__________
(¬1) أصول السرخسي (1/ 151).
(¬2) الإحكام في أصول الأحكام (4/ 413).
أدركتْه الوفاة وعليه فريضة الحج، أينفعه إنْ حججتُ عنه؟ فقال: أرأيت لو كان على أبيك دَين فقضيته أكان ينفعه؟ قالت: نعم" (¬1). فنظيره في المسئول عنه كذلك، وفيه تنبيه على الأصل الذي هو دَين الآدمي على الميت، والفرع وهو الحج الواجب عليه، والعلة وهي قضاء دَين الميت. فقد جمع فيه - صلى الله عليه وسلم - أركان القياس كلها.
ونحوه ما في "الصحيحين": "جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إنَّ أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيتِ لو كان على أُمك دَين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك" (¬2).
وقيل: إن من ذلك حديث عمر في "أبي داود" و"النسائي" لما سأله عن قُبلة الصائم: "أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم أتفطر؟ ". قال: لا. قال: "فَمَهْ" (¬3). وذلك أنه ذكر الوصف في نظير المسئول عنه وهو المضمضة التي هي مقدمة الشرب، ورتَّب عليها الحكم وعدم الإفساد، ونَبَّه على الأصل وهو الصوم مع المضمضة، والفرع وهو الصوم مع القُبلة.
وقيل: ليس هذا مِن ذلك، وإنما هو نقض لِمَ تَوهَّمه عُمَر مِن إفساد القُبلة التي هي مقدمة الجماع الذي هو مُفْسد، فإن عمر فض توهَّم أن القُبلة تفسد كما يفسد الجماع، فنقض - صلى الله عليه وسلم - تَوهُّمه بالمضمضة، لا أن ذلك تعليل لِمَنعْ الإفساد.
الثالث:
أنْ يُفرق بين حُكمَين بصفتين، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "للراجل سهم، وللفارس سهمان". كذا
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.
(¬2) صحيح مسلم (رقم: 1148)، وانظر: صحيح البخاري (1852).
(¬3) سبق تخريجه.