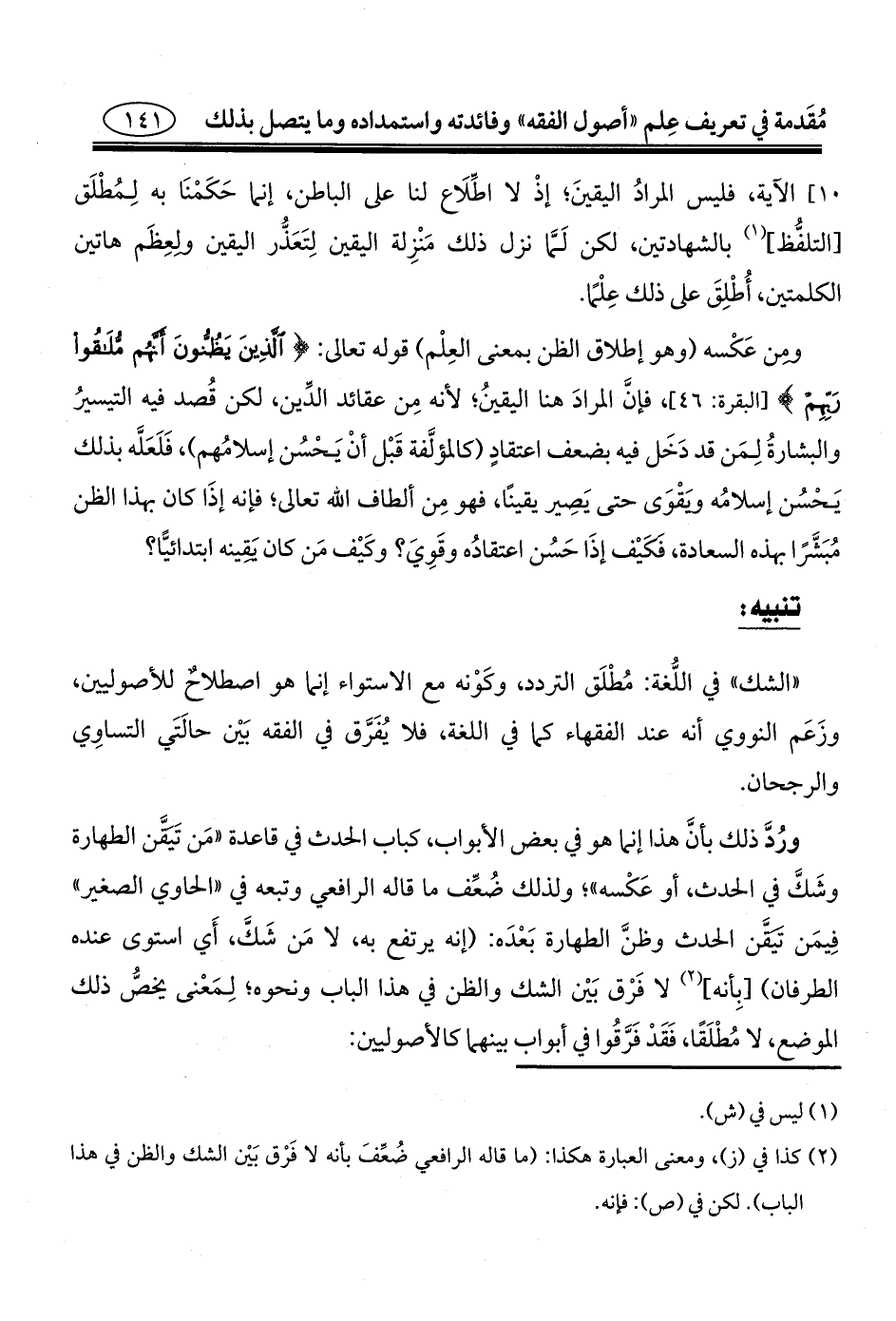
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية
10] الآية، فليس المرادُ اليقينَ؛ إذْ لا اطِّلَاع لنا على الباطن، إنما حَكَمْنَا به لِمُطْلَق [التلفُّظ] (¬1) بالشهادتين، لكن لَمَّا نزل ذلك مَنْزِلة اليقين لِتَعَذُّر اليقين ولِعِظَم هاتين الكلمتين، أُطْلِقَ على ذلك عِلْمًا.ومِن عَكْسه (وهو إطلاق الظن بمعنى العِلْم) قوله تعالى: {الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ} [البقرة: 46]، فإنَّ المرادَ هنا اليقينُ؛ لأنه مِن عقائد الدِّين، لكن قُصد فيه التيسيرُ والبشارةُ لِمَن قد دَخَل فيه بضعف اعتقادٍ (كالمؤلَّفة قَبْل أنْ يَحْسُن إسلامُهم)، فَلَعَلَّه بذلك يَحْسُن إسلامُه ويَقْوَى حتى يَصِير يقينًا، فهو مِن ألطاف الله تعالى؛ فإنه إذَا كان بهذا الظن مُبَشَّرًا بهذه السعادة، فكَيْف إذَا حَسُن اعتقادُه وقَوِيَ؟ وكَيْف مَن كان يَقِينه ابتدائيًّا؟
تنبيه:
"الشك" في اللُّغة: مُطْلَق التردد، وكَوْنه مع الاستواء إنما هو اصطلاحٌ للأصوليين، وزَعَم النووي أنه عند الفقهاء كما في اللغة، فلا يُفَرَّق في الفقه بَيْن حالَتَي التساوِي والرجحان.
ورُدَّ ذلك بأنَّ هذا إنما هو في بعض الأبواب، كباب الحدث في قاعدة "مَن تَيَقَّن الطهارة وشَكَّ في الحدث، أو عَكْسه"؛ ولذلك ضُعِّف ما قاله الرافعي وتبعه في "الحاوي الصغير" فِيمَن تَيَقَّن الحدث وظنَّ الطهارة بَعْدَه: (إنه يرتفع به، لا مَن شَكَّ، أَي استوى عنده الطرفان) [بِأنه] (¬2) لا فَرْق بَيْن الشك والظن في هذا الباب ونحوه؛ لِمَعْنى يخصُّ ذلك الموضع، لا مُطْلَقًا، فَقَدْ فَرَّقُوا في أبواب بينهما كالأصوليين:
¬__________
(¬1) ليس في (ش).
(¬2) كذا في (ز)، ومعنى العبارة هكذا: (ما قاله الرافعي ضُعِّفَ بأنه لا فَرْق بَيْن الشك والظن في هذا الباب). لكن في (ص): فإنه.
وهو الظُّلمة؛ لأنه إذا غَطَّى عليه الأمر، [أَظْلَمَه] (¬1) عليه.
وأما في الاصطلاح فهو قسمان: قِسم مُضر يمنع القبول، وقسم لا يضر.
فالثاني -وهو ما بدأتُ به في النَّظم- له صُوَر:
إحداها: أن يُسمِّي شيخَه في روايته بِاسْم له غيْر مشهور، ومرادي بالاسم ما يُقْصد تعريفه به مِن اسمٍ وكنية ولقب ونسبٍ ووصفٍ.
كقول أبي بكر بن مجاهد المقرئ الإمام: (حدثنا عبد الله بن أبي [عبد الله]) (¬2). يُريد به عبد الله بن أبي داود السجستاني. وقوله أيضاً: (حدثنا محمد بن سند). يريد النقاش المفسر، نَسَبَه إلى جدٍّ له. وكقول الخطيب الحافظ: (حدثنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي)، ومرةً: (الروياني)، وهُوَ هُوَ. وكقوله: (حدثنا علي بن أبي علي المعدل)، ومرةً: (البصري)، وهُو هو، ونحو ذلك.
وُيسمَّى هذا "تدليس الشيوخ"، ذكره ابن الصلاح (¬3) بعد مَا ذَكر ما يُسمَّى "تدليس الإسناد"، وهو أن يروي عمن لقيه أو عاصَره ما لم يسمعه منه مُوهِمًا سماعه منه قائلًا: "قال فلان" أو "عن فلان" ونحوه، وربما لم يسقط شيخَه وأسقطه غيره.
ومَثَّله غيره بما في "الترمذي" عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة مرفوعًا: "لا نَذْر في معصية، وكفارتُه كفارة يمين" (¬4). ثم قال: هذا حديث لا يصح؛ لأنَّ الزهري لم يسمعه
¬__________
(¬1) كذا في (ز، ق). لكن في سائر النُّسخ: أظلم.
(¬2) في (ز): أَوفى.
(¬3) مقدمة ابن الصلاح (ص 74).
(¬4) سنن أبي داود (رقم: 3292)، سنن الترمذي (رقم: 1524). قال الألباني: صحيح. (صحيح سنن أبي داود: 3290).
والثاني: استلزام الشرط للجزاء، أي: يكون الشرط ملزومًا والجزاء لازمًا.
وحينئذٍ فينظر فيهما: إنْ تَساويا، لَزِمَ مِن انتفاء الشرط انتفاء الجواب، وإنْ لم يتساويا فلا يَلزم من انتفائه انتفاؤه.
فمِن الأول نحو: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} [الأنبياء: 22]، فتَعدُّد الآلهة ملزوم للفساد الذي هو لازم، وهو مساوٍ له، فيلزم من انتفاء كل منهما انتفاء الآخر، ومن وجود كل منهما وجودُ الآخر.
وعلى هذا النوع يَصْدُق أنها حرف امتناع؛ لامتناع.
وِمن الثاني -وهو ما يكون اللزوم فيه أَعَم- نحو: (لو كان إنسانًا لكان حيوانًا)، فإن مِن لازِم الإنسان الحيوان، ولكنه أعم من الإنسان وغيره، فلا يَلزم مِن انتفاء كونه إنسانًا انتفاءُ كونه حيوانًا.
قيل: هذا وارد على مَن يقول: (امتناع؛ لامتناع).
وهذا معنى قولي: (فَيَنتفِي إنْ نَاسَبَا وَلَا مُقَدَّمٌ يَكُونُ ذَاهِبَا يَخْلُفُهُ غَيْرٌ). أي: فيرتب على ما سبق -من كونها تقتضي امتناع ما يليها وأنها حال- كَوْنُ ذلك المقدم استلزم تاليه ما ذكر، وهو أنه إذا كان المقدم مناسبًا للتالي ولا يمكن أن يذهب ويخلفه غيره وهو المشارك الذي شرحناه.
ومعنى قولي: (يَخْلُفُهُ غَيْرٌ) أي: غيره.
ثم قلتُ: إن مثال هذا القسم أكمل. أي: ذكر في القرآن العظيم مكملًا، (فكُنْ) إذا ذكرته (مُكَمِّلًا) له بتلاوتك الآية بكمالها.
نعم، اشتراط الناسبة في هذا القسم وقع في عبارة كثير، وهو مستغنًى عنه؛ فإن المدار على كونه لا يخلف المقدم غيره، أي: للمساواة بينهما، بخلاف ما إذا لم يتساويَا.
يقول: هو حقيقة بلا خلاف. كما قاله الصفي الهندي.
قال بعضهم: أو يكون عندهم من العام الذي أريد به الخصوص، فيَطرُقه الخلاف في أنه هل يكون حقيقةً؟ أو مجازًا؟
وجعل أبو الخطاب -من الحنابلة- مأخذ الخلاف في كون العقل مخصصًا أوْ لا: التحسين والتقبيح العقليين.
فإنْ صح ذلك، كان أيضًا هذا من فائدة الخلاف.
لكن استدركه عليه الأصفهاني والنقشواني بما فيه نظر لا يليق التطويل فيه بهذا المختصر.
تنبيهات
الأول: إنما قدمت في الذِّكر الحِس على العقل وإنْ كان البيضاوي وغيره قدَّموا العقل؛ لأن الإمام في أول "البرهان" قال: (إنَّ اختيار الشيخ أبي الحسن الأشعري أنَّ المدرَك بالحواس مقدَّم على ما يدرَك بالعقل. وإنَّ القلانسي -مِن أصحابنا- خالف في ذلك فَقَدَّم المعقولات) (¬1). انتهى
فيؤخَذ مِن ذلك خلاف فيما إذا تَعارض في لفظ عام أنْ يكون مخصوصًا بالعقل أو بالحس، أيُّهما يكون هو المخصِّص؟
الثاني ما مَثَّلوا به المسألة من قوله تعالى: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} مبني على أمرين:
أحدهمما: أن المتكلم داخل في عموم كلامه، وهو رأْي يحتمل أن الشافعي لا يختاره؛
¬__________
(¬1) البرهان (1/ 109).
وقد يكون أَدْوَن، وذلك كسائر الأقيسة التي يتمسك بها الفقهاء في مباحثهم كما قاله الإمام الرازي.
قال: (وأما مراتب التفاوت فهي بحسب مراتب الظنون، فلا تنحصر) (¬1).
وهذا التقسيم واضح فيما إذا كان الحكم في القياس ظنيًّا.
فإنْ كان قطعيًّا، قال الإمام: (فيستحيل أن يكون الحكم في الفرع أقوى منه؛ لأنه ليس فوق اليقين درجة) (¬2).
واعترضه النقشواني بأنَّ اليقين قابل للاشتداد والضعف.
وما اعترض به مَبْنِي على أنَّ [العلوم] (¬3) تتفاوت.
واعْلَم أنه قد ظهر أنه لا منافاة بين كون القياس قطعيًّا ويين كون الحكم فيه ظنيًّا، خلافًا لمن وهم في ذلك.
الثالث:
قد سبق في تقسيم الألفاظ أن ما كان حُكم الفرع فيه أَولى مِن الأصل أو مساويًا فيه مذاهب:
أحدها: أنه مفهوم موافقة، ويسمى "فحوى الخطاب" إنْ كان أَولى، و"لحنه" إنْ كان مساويًا، وهو على ما هو الغالب في كلام الأصوليين والفقهاء.
¬__________
(¬1) انظر: المحصول في أصول الفقه (5/ 124)، لكنه قال: (وأما مراتب التفاوت فهي بحسب مراتب الظنون، ولما كانت مراتب الظنون محصورة فكذا القول في مراتب هذا التفاوت).
(¬2) المحصول في أصول الفقه (5/ 123).
(¬3) في (ق، ص): المعلوم.