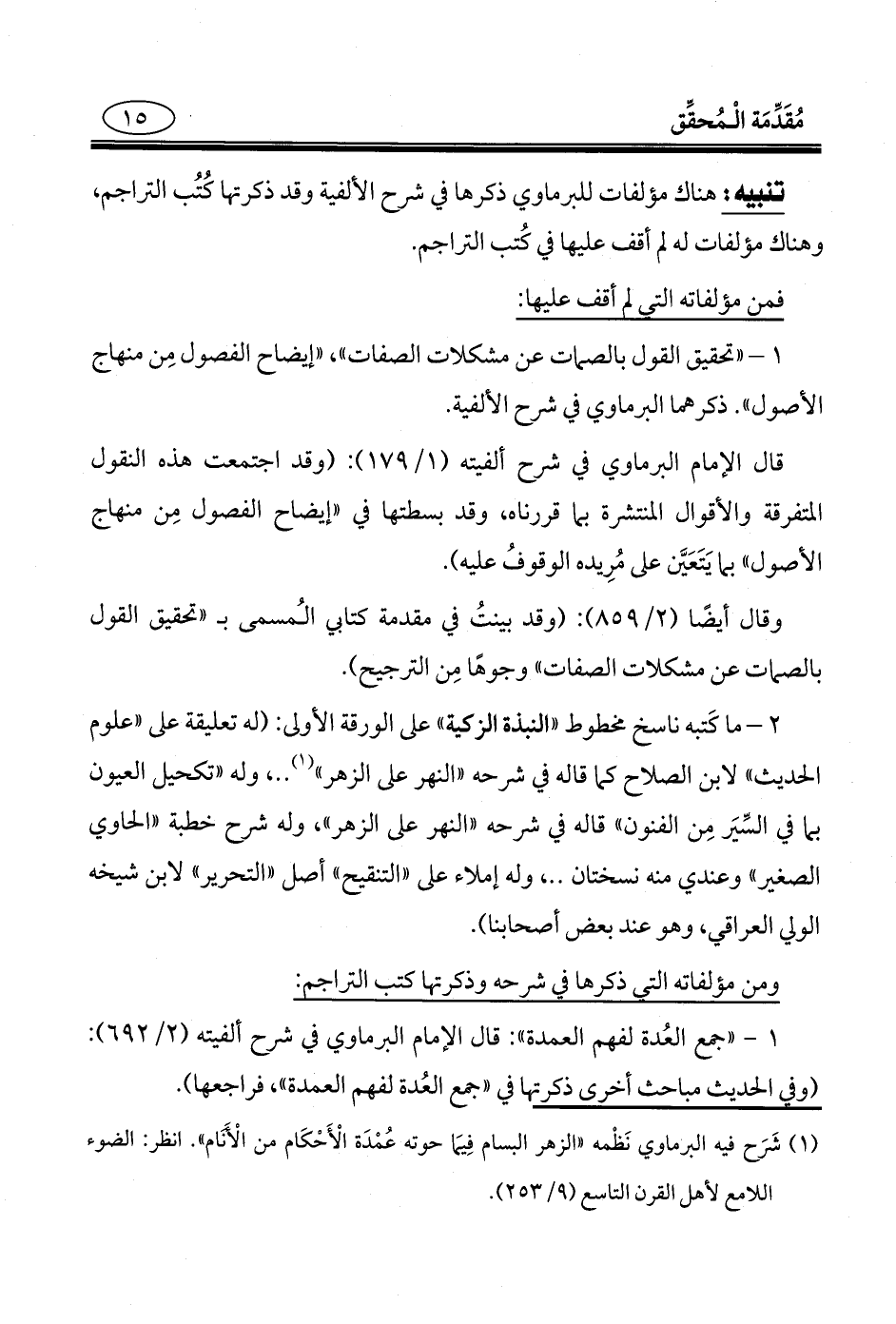
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية
تنبيه: هناك مؤلفات للبرماوي ذكرها في شرح الألفية وقد ذكرتها كُتُب التراجم، وهناك مؤلفات له لم أقف عليها في كُتب التراجم.فمن مؤلفاته التي لم أقف عليها:
1 - "تحقيق القول بالصمات عن مشكلات الصفات"، "إيضاح الفصول مِن منهاج الأصول". ذكرهما البرماوي في شرح الألفية.
قال الإمام البرماوي في شرح ألفيته (1/ 179): (وقد اجتمعت هذه النقول المتفرقة والأقوال المنتشرة بما قررناه، وقد بسطتها في "إيضاح الفصول مِن منهاج الأصول" بما يَتَعَيَّن على مُرِيده الوقوفُ عليه).
وقال أيضًا (2/ 859): (وقد بينتُ في مقدمة كتابي المُسمى بـ "تحقيق القول بالصمات عن مشكلات الصفات" وجوهًا مِن الترجيح).
2 - ما كَتبه ناسخ مخطوط "النبذة الزكية" على الورقة الأولى: (له تعليقة على "علوم الحديث" لابن الصلاح كما قاله في شرحه "النهر على الزهر" (¬1) .. ، وله "تكحيل العيون بما في السِّيَر مِن الفنون" قاله في شرحه "النهر على الزهر"، وله شرح خطبة "الحاوي الصغير" وعندي منه نسختان .. ، وله إملاء على "التنقيح" أصل "التحرير" لابن شيخه الولي العراقي، وهو عند بعض أصحابنا).
ومن مؤلفاته التى ذكرها في شرحه وذكرتها كتب التراجم:
1 - "جمع العُدة لفهم العمدة": قال الإمام البرماوي في شرح ألفيته (2/ 692): (وفى الحديث مباحث أخرى ذكرتها في "جمع العُدة لفهم العمدة"، فراجعها).
¬__________
(¬1) شَرَح فيه البرماوي نَظْمه "الزهر البسام فِيمَا حوته عُمْدَة الْأَحْكَام من الْأَنَام". انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (9/ 253).
- صلى الله عليه وسلم - معهم في القسمة ثمانية أسهم لهم ولم يحضروا؛ فنزلوا منزلة الحاضرين؛ فصارت العدة بهم " وثلاثة عشر".
وقال بعضهم: لا بُدَّ في التواتر من عدد أهل بيعة الرضوان. قال إمام الحرمين: وهُم ألف وسبعمائة. لكن الذي في "الصحيح" عن البراء وهو رواية عن جابر: ألف وأربعمائة. وقال النووي: إنه الأشهر. وعن سلمة ورواية عن جابر: ألف وخمسمائة. وعن عبد الله بن أبي أوفى: ألف وثلاثمائة. وقال الواقدي وموسى بن عقبة: ألف وستمائة. وقيل غير ذلك.
وتعيين الأعداد في التواتر بهذه الشُّبَه لا يخفَى ضعفُه، ويلزم أن يقال بمثل هذا: تسعة عشر؛ لقوله تعالى: {عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ} [المدثر: 30]، و: ثمانية؛ لقوله تعالى: {وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ} [الكهف: 22]، وأشباه ذلك مما لا ينحصر ويتكلف له مناسبة كما تكلف في هذه المذكورات، ولا قائل به، والله أعلم.
ص:
264 - كَذَاكَ مَا شَرْطُهُمُ عَدَالَهْ ... أَيْضًا وَلَا إسْلَامُهُمْ أَصَالَهْ
265 - وَلَا انْتِفَا [انْحِوَائِهِمْ] (¬1) في بَلَدِ ... مِنْ أَجْلِ ذَا الْقُرْآنُ عَالِي السَّنَدِ
الشرح:
هَذه أيضًا أقوال ضعيفة في شروط التواتر:
منها: اشتراط العدالة، وإلا فقدْ أَخبر الإمامية بالنَّص علَى إمامة عِلي -كرم الله وجهه- ولم يُقبل إخبارهم مع كثرتهم؛ لِفسقهم.
¬__________
(¬1) في (ن 3، ن 4): احتوائهم. وفي (ن 1): انحتوائهم. وفي سائر النُّسَخ: انحوائهم.
أشرتُ بقولي: (فَإِنْ تَوَقَّفَتْ) إلى آخِره.
وَجِهات التوقف ثلاثة: ما يتوقف فيه صِدق اللفظ، وما يتوقف فيه صحة الحكم عقلًا، وما يتوقف فيه صحة الحكم شرعًا.
فالأول: مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "رُفع عن أُمتي الخطأ والنسيان" (¬1)، فإنَّ ذات الخطأ والنسيان لم [ترتفع] (¬2)؛ فيُضمَر ما يتوقف عليه الصِّدق مِن لفظ "الإثم" أو "المؤاخذة" أو نحو ذلك.
والثاني: مثل قوله تعالى: {وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ}، أي: أهل القرية؛ إذْ لو لم يُقَدَّر ذلك أو نحوه، لم يصح عقلًا، إذْ هي لا تُسأل، ولا يخفَى ما في نسبة ذلك للعقل مِن المسامحة؛ ولذلك قالوا: إن هذا بِناءٌ على أنَّها لم تكن مسئولة حقيقةً من باب المعجزة له، وهو مبني أيضًا على أنَّه لم يُعَبَّر بالقرية عن أهلها؛ إذِ المجاز حينئذٍ مجاز استعارة، لا مجاز إضمار.
ومثله قوله تعالى: {أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ} [الشعراء: 63]، أي: فَضرَب؛ فانفلق.
والثالث: كقول القائل: أَعْتِق [عبدك] (¬3) عني على كذا)، أو قال: (مجانًا)، فإنه في الأول بيع ضمني، وفي الثاني هبة ضمنية لا يستحق صاحب العبد عليه شيئا جزمًا.
نعم، قال المزني: إنه لا يقع عن المستدعي. ولكن المذهب خِلافه، وكذا لو سكت على "أَعْتِق" ولم يذكر شيئًا فإنه هبة ضمنية ولا يستحق شيئًا على أصح الوجهين، وقيل: يستحق.
وإنَّما توقفت الصحة الشرعية في [ذلك] (¬4)؛ لأنَّ العتق شرعًا لا يكون إلَّا لمملوك. وهو
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.
(¬2) كذا في (ز، ص)، وفي (ت): ترفع.
(¬3) في (ت، ض): عبدي.
(¬4) في (ز، ق، ظ): الأحوال الثلاثة.
ليسَا بإخوة. فقال عثمان: لا أستطيع أن أنقض أمرًا كان قبلي وتوارثه الناس ومضى في الأمصار) (¬1).
فقال ابن عباس: (إن الأخوين ليسَا بإخوة)، فلم يُنكر عليه عثمان ذلك، بل عدل إلى الاستدلال بما ذكره؛ فدل على توافقهما عليه، وأن مَن يرى بالحجب بأخوين ليس لكون أقَل الجمع اثنين، بل للإجماع السابق، أو قول الأكثر، أو نحو ذلك.
فمَن ينقل عن الصحابة أن أقَل الجمع اثنان، فَظَنٌّ منه أن سنده في الحجب لفظ "إخوة" في الآية.
وعلى ذلك يُحمل ما رواه الحاكم في المستدرك عن زيد أنه كان يقول: "الإخوة في كلام العرب أخوان فصاعدًا" (¬2) وروي نحوه عن عمر أنما مُرادهما في هذا الموضع، لدليل قام عندهما فيه.
الثالث: الوقف. حكاه الأصفهاني في "شرح المحصول" عن الآمدي، وفي ثبوته نظر؛ لأنه إنما أَشْعر به كلام الآمدي، إذْ قال في آخِر المسألة: (وإذا عُرف مآخذ الجمع من الجانبين، فعَلَى الناظر الاجتهاد في الترجيح، وإلا فالوقف لازم) (¬3).
ولكن هذا الكلام بمجرده لا يكفي في حكاية الوقف مذهبًا.
¬__________
(¬1) مستدرك الحاكم (7960). قال الألباني: ضعيف. (إرواء الغليل: 1678).
(¬2) المستدرك على الصحيحين (رقم: 7961). قال الألباني في (إرواء الغليل: 1678): (أخرجه الحاكم .. من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه .. وقال: "صحيح على شرط الشيخين". ووافقه الذهبى، وأقول: ابن أبي الزناد لم يحتج به الشيخان، وإنما أخرج له البخارى تعليقًا، ومسلم في المقدمة، وهو حَسن الحديث).
(¬3) الإحكام للآمدي (2/ 247).
يمثلون به، والذي في "الصحيحين" جَعْله للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا (¬1).
وفي "البخاري": "للفرس سهمين وللراجل سهمًا" (¬2). ورواه الدارقطني بلفظ: "جعل للفارس سهمين وللراجل سهمًا" (¬3).
أو بِصِفةٍ مع أحد الحكمين دُون الآخَر، كحديث: "القاتل لا يرث" (¬4). رواه الترمذي وقال: (لا يصح). فإنَّ مقابِله -وهو مَن ليس بقاتل مِن الورثة- يكون محكومًا عليه بضد هذا الحكم وهو منع الإرث، فيكون وارثًا.
وفي معنى التفريق بين الحُكمين بصمة التفرقة بينهما بغايةٍ كقوله تعالى: {حَتَّى يَطْهُرْنَ}، أو استثناء كقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} [البقرة: 237]، أو شرطٍ كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اختلفت هذه الأجناس، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بِيَد" (¬5)، أو لفظٍ دال على استدراك نحو: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [المائدة: 89].
ووجه استفادة العلة من ذلك كله أن التفرقة لا بُدَّ لها من فائدة، والأصل عدم غَيْر المُدَّعَى وهو إفادة كَوْن ذلك عِلَّة.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (رقم: 2708)، صحيح مسلم (رقم: 1762).
(¬2) صحيح البخاري (رقم: 3988).
(¬3) سنن الدارقطني (4/ 106). وقال الإمام الدارقطني: (قال لنا النيسابوري: هذا عندي وَهْم من ابن أبي شيبة أو من الرمادي؛ لأن أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن بشر وغيرهما رووه عن ابن نمير خلاف هذا، وقد تَقدم ذِكره عنهما).
(¬4) سبق تخريجه.
(¬5) صحيح مسلم (رقم: 1587) بلفظ: (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد).