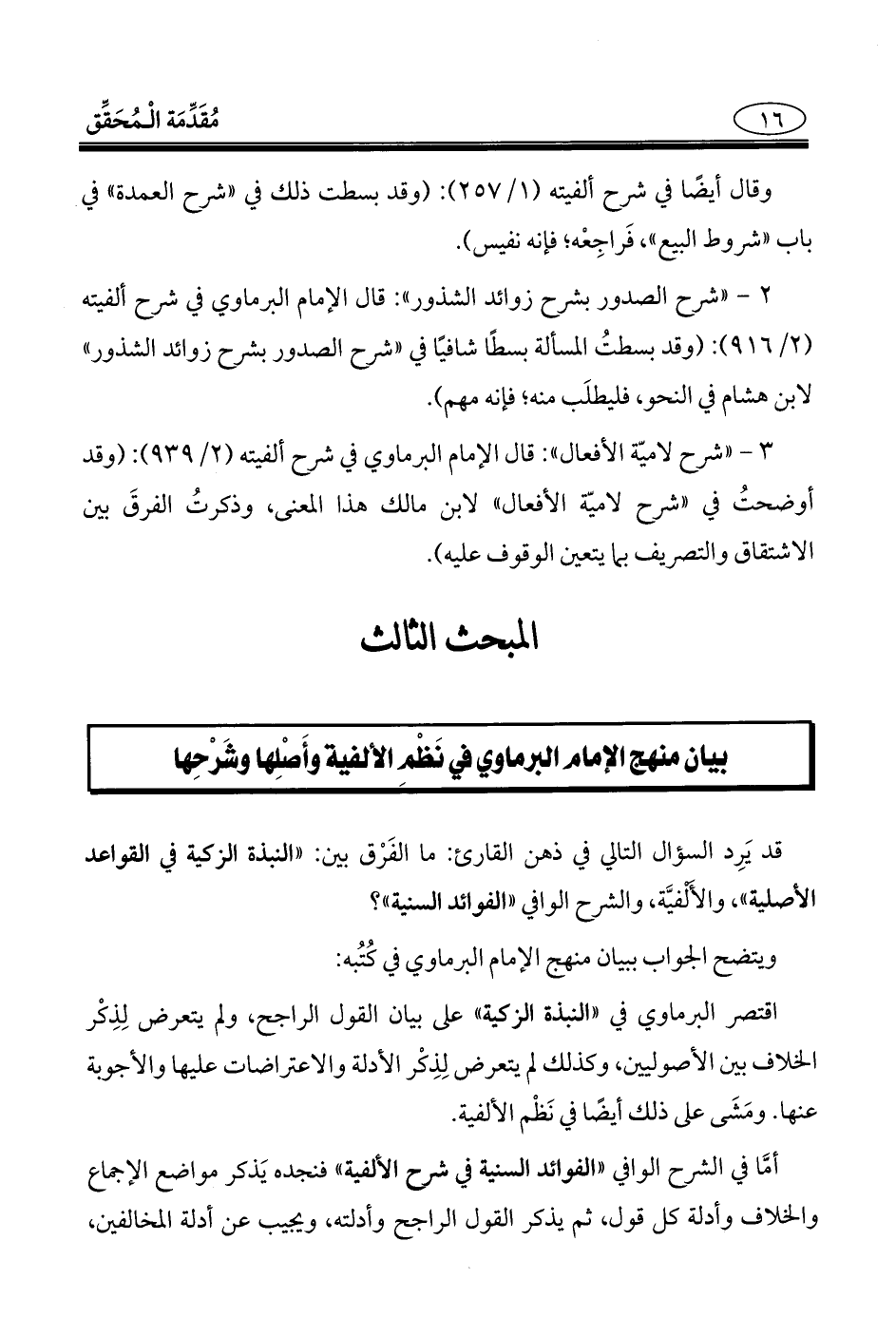
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية
وقال أيضًا في شرح ألفيته (1/ 257): (وقد بسطت ذلك في "شرح العمدة" في باب "شروط البيع"، فَراجِعْه؛ فإنه نفيس).2 - "شرح الصدور بشرح زوائد الشذور": قال الإمام البرماوي في شرح ألفيته (2/ 916): (وقد بسطتُ المسألة بسطًا شافيًا في "شرح الصدور بشرح زوائد الشذور" لابن هشام في النحو، فليطلَب منه؛ فإنه مهم).
3 - "شرح لاميّة الأفعال": قال الإمام البرماوي في شرح ألفيته (2/ 939): (وقد أوضحتُ في "شرح لاميّة الأفعال" لابن مالك هذا المعنى، وذكرتُ الفرقَ بين الاشتقاق والتصريف بما يتعين الوقوف عليه).
المبحث الثالث: بيان منهج الإمام البرماوي في نَظْم الألفية وأَصْلِها وشَرْحِها
قد يَرِد السؤال التالي في ذهن القارئ: ما الفَرْق بين: "النبذة الزكية في القواعد الأصلية"، والأَلْفيَّة، والشرح الوافي "الفوائد السنية"؟
ويتضح الجواب ببيان منهج الإمام البرماوي في كُتُبه:
اقتصر البرماوي في "النبذة الزكية" على بيان القول الراجح، ولم يتعرض لِذِكْر الخلاف بين الأصوليين، وكذلك لم يتعرض لِذِكْر الأدلة والاعتراضات عليها والأجوبة عنها. ومَشَى على ذلك أيضًا في نَظْم الألفية.
أمَّا في الشرح الوافي "الفوائد السنية في شرح الألفية" فنجده يَذكر مواضع الإجماع والخلاف وأدلة كل قول، ثم يذكر القول الراجح وأدلته، ويجيب عن أدلة المخالفين،
ومنها: اشتراط الإسلام، وإلا فقد أَخبر النصارى مع كثرةٍ بقتل عيسى -عليه السلام- ولم يصح ذلك؛ لكفرهم.
وجوابه فيهما: أن عدد التواتر فيما ذُكر ليس في كل طبقة، فقد قَتل بختنصر النصارى حتى لم يبق منهم إلا دُون عدد التواتر.
واعْلم أن كلام الآمدي يوهم أن الشارطين للإسلام والعدالة واحد، وليس كذلك، وإلا فكان الاقتصار على العدالة كافيًا، ولأجل ذلك قدمتُ مسألة العدالة على الإسلام في النَّظم؛ دفْعًا لهذا الإيهام الواقع في لفظ "المختصر" وغيره.
ومنها: اشتراط أن لا يحويهم بلد؛ لاحتمال أن يتواطئوا على الكذب.
ورُدَّ بأن أهل الجامع لو أخبروا عن سقوط الخطيب، لأفاد خبرُهم العِلمَ فضلًا عن أهل بلد.
ومنها: اشتراط اختلاف أنسابهم أو دينهم أو وطنهم؛ لِمَا ذكرناه. وردُّه واضح أيضًا.
ومنها: اشتراط الشيعة الإمام المعصوم. وهو أَفْسَد الكل؛ لأن قول المعصوم كافٍ، فَأَيُّ حاجة إلى انضمام أحدٍ معه؟ !
ومنها: اشتراط أن يبلغوا مَبْلغًا لا يحويهم بلد ولا يحصرهم عدد، أيْ: لكثرتهم. وهو غير ما سبق مِن نفي انحوائهم في بلد.
وقال ضِرار بن عمرو: لا بُدَّ من خبر قول كل الأُمة، وهو الإجماع. حكاه القاضي في "مختصر التقريب".
وقيل غير ذلك من الشروط الفاسدة، والله أعلم.
وقولي: (مِنْ أَجْلِ ذَا الْقُرْآنُ عَالِي السَّنَدِ) تمامه قولي بعده:
معنى قولي في النظم: (وَ"أَعْتِق الْعَبْدَ عَلَيَّ"، فَاقْبَلِ) أي: فَقُل: (أعتقته)، فيشمل الثلاثة.
تنبيه:
جَعْلُ الأقسام [الثلاثة] (¬1) اقتضاء هو قول أصحابنا، وذهب جَمعٌ من الحنفية - كالبزدوي - إلى أن "المقتضِي" ما تَوقَّف فيه الصحة شرعًا، وسَموا الأول والثاني "محذوفًا" أو "مضمرًا"، وفرقوا بين المحذوف والمقتضَى بأنَّ "المقتضَى" لا يتغير فيه ظاهر الكلام عن حاله ولا إعرابه عند التصريح به، بل يبقى كما كان قبله، بخلاف المحذوف كَـ {اسْأَلِ الْقَرْيَةِ} و"رُفع عن أمتي الخطأ" ونحوه، والله أعلم.
ص:
460 - وَمَا يَدُلُّ وَبِلَفْظٍ مَا قُصِدْ ... "إشَارَةٌ" في "الْآنَ بَاشِرُوا" تَجِدْ
الشرح:
هذا هو القسم الثالث مما ذكره ابن الحاجب مِن أقسام غير الصريح.
وأما القسم الثاني وهو "الإيماء": وهو ما فيه قصد المتكلم ولا يتوقف على إضمار شيء ولكنه اقترن بحكم لو لم يكن اقترانه به عِلةً له لكان بعيدًا مِن الشارع أن يقرنه به وهو أجنبي، ويُسمى "تنبيهًا" و"إيماء"، وسيأتي بمثاله في "باب القياس" من جملة الطُّرق الدالة على العِلية؛ ولهذا أسقطته من النَّظم هنا، ولأن الحكم ليس منسوبًا لدلالة اللفظ عليه البتَّة.
وأما هذا الثالث الذي ذكرته هنا في النظم (وهو: ما له عليه دلالة ولكن لم تقصد دلالته) فيُسمى "إشارة"، كقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ}
¬__________
(¬1) في (ز، ظ، ق): الأصلية الثلاثة.
الرابع: أن أقَل ما يُطلق الجمع عليه واحد. وربما ينقل ذلك عن إمام الحرمين كما عزاه ابن الحاجب له، إذْ قال في "مختصره الصغير": (مسألة: أبنية الجمع لاثنين تصح، وثالثها: مجازًا. الإمام: ولواحد) (¬1).
فإن كلامه يقتضي أن لنا قولًا أن الجمع لا يصح إطلاقه على الاثنين، لا حقيقة ولا مجازًا. ولكن لا يُعرف ذلك. ويقتضي أن الإمام يقول: إنَّ أقَل الجمع واحد. فإنْ أراد حقيقةً فلا قائل به أصلًا، أو مجازا فلا يمنعه أحد، لا الإمام ولا غيره.
والذي غَرَّ ناقل ذلك عن الإمام أنه قال في "البرهان" عقب مسألة: "التخصيص إلى ماذا ينتهي؟ " وذكر صيغة الجمع، ثم قال: (والذي أراه أن الرد إلى واحد ليسِ بدعًا، ولكنه أَبْعَد مِن الرد إلى اثنين) (¬2).
لكن كلام الإمام إنما هو منحط على ما قبله، وهو ما ينتهي إليه التخصيص. ومراده بقوله: (ليس بِدعًا) أن الانتهاء إلى واحد في التخصيص ليس بِدعًا وإنْ كان مجازًا.
ولهذا قال عقبه: (وهو أبْعد من الرد إلى اثنين)؛ لأن المجازات قد تتفاوت بها القُرب والبُعد من الحقيقة، ولو كان مراده أن ذلك يكون حقيقة، لَمَا قال: (وهو أبعد من الرد لاثنين)؛ لأن الحقيقة لا تتفاوت جزئياتها من حيث كونها حقيقة.
فالذي يقتضيه قول الإمام أو، وآخِرًا أن أقَل الجمع ثلاثة حقيقةً، وأنه في دُونها مجاز.
فمن أمثلة الإطلاق على الواحد: ما سبق في قوله تعالى: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ} [آل عمران: 173]، ونحوه.
ومثَّله ابن فارس بها "فقه العربية" بقوله تعالى: {فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ} [النمل:
¬__________
(¬1) مختصر المنتهى مع شرحه (2/ 122).
(¬2) البرهان (1/ 241).
الرابع:
مِن وجوه الإيماء: أنْ يذكر مع الحكم وصفًا مناسبًا كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقضي القاضي وهو غضبان" (¬1). رواه الشافعي - رضي الله عنه - بلفظ: "لا يحكم الحاكم أو لا يقضي بين اثنين" (¬2). ورواه أصحاب الكتب الستة بلفظ: "لا يقضِين حاكم بين اثنين وهو غضبان" (¬3). ففيه التنبيه على أن علة ذلك ما فيه من تشويش الفكر، ثم يطرد ذلك في كلِّ مُشَوِّش؛ لأن خصوص كونه غضبان ليس هو المناسب للحكم؛ فيلحق به الجائع والحاقن ونحو ذلك.
وقال الإمام الرازي: (لا مُلازَمَة بين التشويش والغضب) (¬4).
لأن التشويش إنما ينشأ عن الغضب الشديد، لا مُطْلَق الغضب.
وأجيب عنه بأن الغضب مظنة التشويش؛ فكان هو العلة، كالسفر مع المشقة. وكل ما كان مظنة من جوع ونحوه يكون كذلك.
واعلم أن هذا سبق التمثيل به لِمَا أجمعوا على أنه علة، فالمراد بالتمثيل به هنا أن يكون في الابتداء قبل أن يُجْمِعوا.
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.
(¬2) مسند الإمام الشافعي (ص 276).
(¬3) صحيح البخاري (رقم: 6739) بلفظ: (لَا يَقْضِيَنَّ حَكَم بين اثْنَيْنِ وهو غَضْبَانُ)، صحيح مسلم (1717) وسنن النسائي (5406) بلفظ: (لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان)، سنن أبي داود (3589) بلفظ: (لا يقضي الحكم بين اثنين وهو غضبان)، سنن الترمذي (رقم: 1334) بلفظ: (لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان)، سنن ابن ماجه (2316) بلفظ: (لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان). وانظر: إرواء الغليل (2626).
(¬4) المحصول في أصول الفقه (5/ 157).