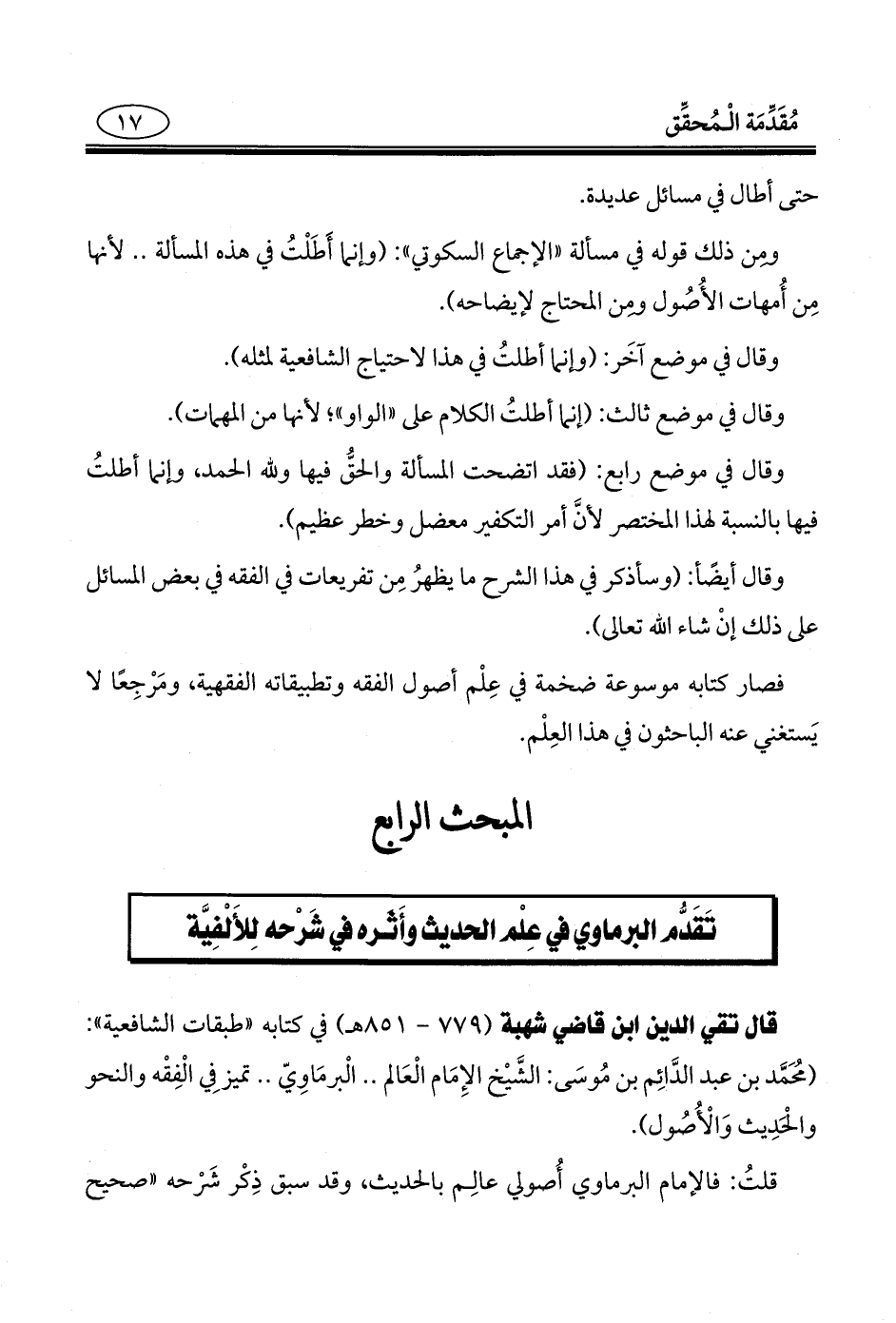
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية
حتى أطال في مسائل عديدة.ومِن ذلك قوله في مسألة "الإجماع السكوتي": (وإنما أَطَلْتُ في هذه المسألة .. لأنها مِن أُمهات الأُصُول ومِن المحتاج لإيضاحه).
وقال في موضع آخَر: (وإنما أطلتُ في هذا لاحتياج الشافعية لمثله).
وقال في موضع ثالث: (إنما أطلتُ الكلام على "الواو"؛ لأنها من المهمات).
وقال في موضع رابع: (فقد اتضحت المسألة والحقُّ فيها ولله الحمد، وإنما أطلتُ فيها بالنسبة لهذا المختصر لأنَّ أمر التكفير معضل وخطر عظيم).
وقال أيضًا: (وسأذكر في هذا الشرح ما يظهرُ مِن تفريعات في الفقه في بعض المسائل على ذلك إنْ شاء الله تعالى).
فصار كتابه موسوعة ضخمة في عِلْم أصول الفقه وتطبيقاته الفقهية، ومَرْجِعًا لا يَستغني عنه الباحثون في هذا العِلْم.
المبحث الرابع: تَقَدُّم البرماوي في عِلْم الحديث وأَثَره في شَرْحه لِلأَلْفِيَّة
قال تقي الدين ابن قاضي شهبة (779 - 851 هـ) في كتابه "طبقات الشافعية": (مُحَمَّد بن عبد الدَّائِم بن مُوسَى: الشَّيْخ الإِمَام الْعَالم .. الْبرمَاوِيّ .. تميز فِي الْفِقْه والنحو والْحَدِيث وَالْأُصُول).
قلتُ: فالإمام البرماوي أُصولي عالِم بالحديث، وقد سبق ذِكْر شَرْحه "صحيح
ص:
266 - لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ تَوَاتُرٍ سِوَى ... مَا كَانَ حُكْمِيًّا [فَوَاحِدٌ] (¬1) رَوَى
267 - كَالْبَدْءِ في فَاتِحَةٍ بِالْبَسْمَلَهْ ... وَكررهَا [لَا في] (¬2) [بَرَاءَةَ] (¬3) الصِّلَهْ (¬4)
الشرح: أيْ: من أجل أن التواتر يفيد القطْع كان ثبوت القرآن لا بُدَّ فيه من التواتر؛ لكونه مقطوعًا به؛ لأنه معجزٌ عظيم، فكان مما تتوفر الدواعي عادةً على نقل جُمله وتفاصيله؛ لدوران الإسلام عليه، فلا بُدَّ من تواتره والقطع به. فما لم يتواتر، لا يثبت كوْنه قرآنًا إلا فيما أُعطي حُكم القرآن فإنه لا يحتاج إلى التواتر، وذلك مفروض في البسملة من أول الفاتحة ومن أول كل سورة بعدها سوَى براءة.
والحاصل في المسألة أن "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" متواترة في سورة النمل، فهي قرآن قطعًا، وليست في أول سورة براءة إجماعًا:
- إما لكون البسملة أمانًا، وهذه السورة نزلت بالسيف كما قاله ابن عباس، وقد كشفت أسرار المنافقين؛ ولذلك تسمى "الفاضحة"، وتسمى "البَحُوث".
- وإما لأنها متصلة بالأنفال سورةً واحدةً.
- وإما لغير ذلك كما سيأتي في كونها [توصل بما] (¬5) قبلها.
¬__________
(¬1) كذا في (ص، ظ، ض، ق، ت، ش). وفي (ن): فآحاد.
(¬2) في (ز): سوى.
(¬3) أي: سورة التوبة.
(¬4) أي: التي توصل بما قبلها مِن غير فَصْل بالبسملة.
(¬5) كذا في (ش). وفي (ز): كوصلة لما. وفي (ظ): مؤصّلة لما. وفي (ض، ق، ت): مُوصلةً لما.
[البقرة: 187]، فإنه يدل بالصريح على جواز المباشرة إلى الصبح ولكن يلزم منه صحة الصوم جُنبًا، فلو لم يكن ما بين الفجر إلى تمام الغسل صيامًا لَكان مستثنًى مقداره قبل الفجر مِن المباشرة في الليل، وهو معنى قولي: (في "الْآنَ بَاشِرُوا" تَجِدْ)، أي: في قوله تعالى: {فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ} [[البقرة: 187]]، الآية - تجد المثال للمسألة.
وكذلك تقدير مدة الحمل بستة أشهر مِن قوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15]، مع قوله تعالى: " {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [لقمان: 14].
وجمن أمثلة ابن الحاجب قوله - صلى الله عليه وسلم - في النساء: "إنهن ناقصات عقل ودين" (¬1)، ثم قال في نقصان دينهن: "تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي" (¬2).
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (رقم: 298)، صحيح مسلم (رقم: 79) بلفظ: (ما رأيت من نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحْازِمِ من إِحْدَاكُنَّ).
(¬2) لم أجد رواية بهذا اللفظ، وقال السخاوي في (المقاصد الحسنة، ص 267): (حَدِيث: "تمَكُثُ إِحْدَاكُنَّ شَطْرَ دَهْرِهَا لا تُصَلِّي" لا أَصل له بهذا اللفظ، فقد قال أَبو عبد الله ابن منده فيما حكاه عنه ابن دقيق العيد في "الإمام": ذكر بعضهم هذا الحديث، ولا يثبت بوجه من الوجوه. وقال البيهقي في "المعرفة": هذا الحديث يذكره بعض فقهائنا، وقد تطلبته كثيرًا، فلم أجده في شيء من كتب الحديث، ولم أجد له إسنادًا. وقال ابن الجوزي في "التحقيق": هذا لفظ يذكره أصحابنا ولا أعرفه. وقال الشيخ أَبو إسحاق في "المهذب": لم أجده بهذا اللفظ إلَّا في كتب الفقهاء. وقال النووي رحمه الله في شرحه: باطل لا يُعرف. وفي "الخلاصة": باطل لا أصل له. وقال المنذري: لم يوجد له إسناد بحال. وأغرب الفخر ابن تيمية في شرح "الهداية" لأبي الخطاب، فنقل عن القاضي أبي يعلى أنَّه قال: ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم البستي في كتاب "السنن" له. كذا قال! وابن حاتم ليس بُستيًّا، وإنَّما هو رازيّ، وليس له كتاب يقال له "السنن").
والرواية التي في صحيح مسلم (رقم: 79) بلفظ: (وَتمَكُثُ اللَّيَالِي ما تُصَلِّي).
35]؛ لأن المراد بالمرسلين سليمان.
وفيه نظر؛ لاحتمال إرادتها جنس المرسلين الذين سليمان -عليه السلام- منهم.
ونحوه قول الزمخشري (¬1) في: {كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ} [الشعراء: 105]؛ لأنه
نوح.
وفيه أيضًا نظر؛ لأنَّ مَن كذَّب رسولًا فقد كذّب الرسُل كلهم، كما يقال: فلان يركب الدواب. أي: شأنه ذلك. وعلى هذا فهو حقيقة خلاف، فقول الغزالي وغيره: (إنَّ مثل ذلك مجاز بالاتفاق) إنما نظروا في ذلك للواقع، لا للمفهوم.
نعم، إمام الحرمين مَثَّله بأن يرى امرأة تبرجت لرجلٍ فيقول لها: (أتتبرجين للرجال؟ ! )، فإن كان مراده أنه يكون حينئذٍ مجازًا -وقد نقله عنه كذلك إلْكِيا- فهو مما لا نزاع فيه كما سبق؛ لأنه مِن إطلاق الكل على البعض. وإنْ كان حقيقةً، فهو نظر إلى المفهوم، لا إلى الواقع، أي: شأنك أن تتبرجي لجنس الرجال.
ويدل عليه قرينة خصوص الرجل المرئي، لا أن قصد قَصْر الرجال عليه.
نعم، من إطلاق الجمع وإرادة الواحد مجازًا إذا أطلق ذلك في مقام التعظيم برفع قَدْرِه عن رُتبة الواحد وضعًا ومحلًّا، كما يقال للكبير: (أنتم فعلتم ذلك). وقول المعظِّم نفسه: (فَعَلْنا ذلك). كما صرح أهل العربية بأن ذلك للمشارك أو المعظِّم نفسه كما في قوله تعالى حكايةً عمن قال: {رَبِّ ارْجِعُونِ} [المؤمنون: 99]، وقوله تعالى: {وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [يوسف: 12]، {فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ} [المرسلات: 23]، {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ} [الحجر: 9]. وهو أمر لا ينحصر.
ومنهم من أَوَّل كلام الإمام السابق على أن إطلاق الجمع للواحد جائز اتفاقًا.
¬__________
(¬1) قال الزمخشري في تفسيره (الكشاف، 3/ 328): (قوله: {الْمُرْسَلِينَ} والمراد نوح عليه السلام).
الخامس:
إذا نُهي عن فِعل (ذلك الفعل يكون مانعًا من فِعل واجب)، كان إيماءً إلى أنَّ عِلة النهي عنه كونه مانعًا من الإتيان بالواجب. فكل ما منع من الإتيان بالواجب يكون كذلك، كقوله تعالى: {وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9]، فإنه نهى في المعنى عن إيجاد البيع وقت النداء؛ لأنه يمنع مِن السعي المأمور به في قوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9]. فلو لم يكن علة لَمَا كان لِذِكره فائدة.
وقال القرافي: إنما استُفيد ذلك من السياق، فإنَّ الآية لم تنزل لبيان أحكام البياعات، بل لتعظيم شأن الجمعة.
وهذه الأقسام الخمسة كلها داخلة تحت قولي في النَّظم: (أَنْ يُقْرَنَ الْوَصْفُ بِحُكْمٍ) إلى آخِره.
ومدارها كلها على تجنب الحشو وعدم الفائدة في كلام الشارع. وهو معنى قولي أولًا: ("الْإيمَاءُ" في التَّجَنُّبِ).
وقولي: (وَلَوْ مُسْتَنْبَطًا) إشارة إلى أن الحكم المقرون به الوصف لا يُشترط في واحد منهما أن يكون مذكورًا، بل قد يكون واحد منهما مستنبطًا.
مثال كون الوصف مذكورًا والحكم مستنبطًا قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275]. فإن الوصف الذي هو حِل البيع مُصرَّح به، والحكم وهو الصحة مستنبط من الحِل؛ فإنه يَلزم مِن حِله صحتُه.
وأما عكسه وهو كون الحكم مذكورًا والوصف مستنبطًا فهو الذي في أكثر العِلل المستنبطة.