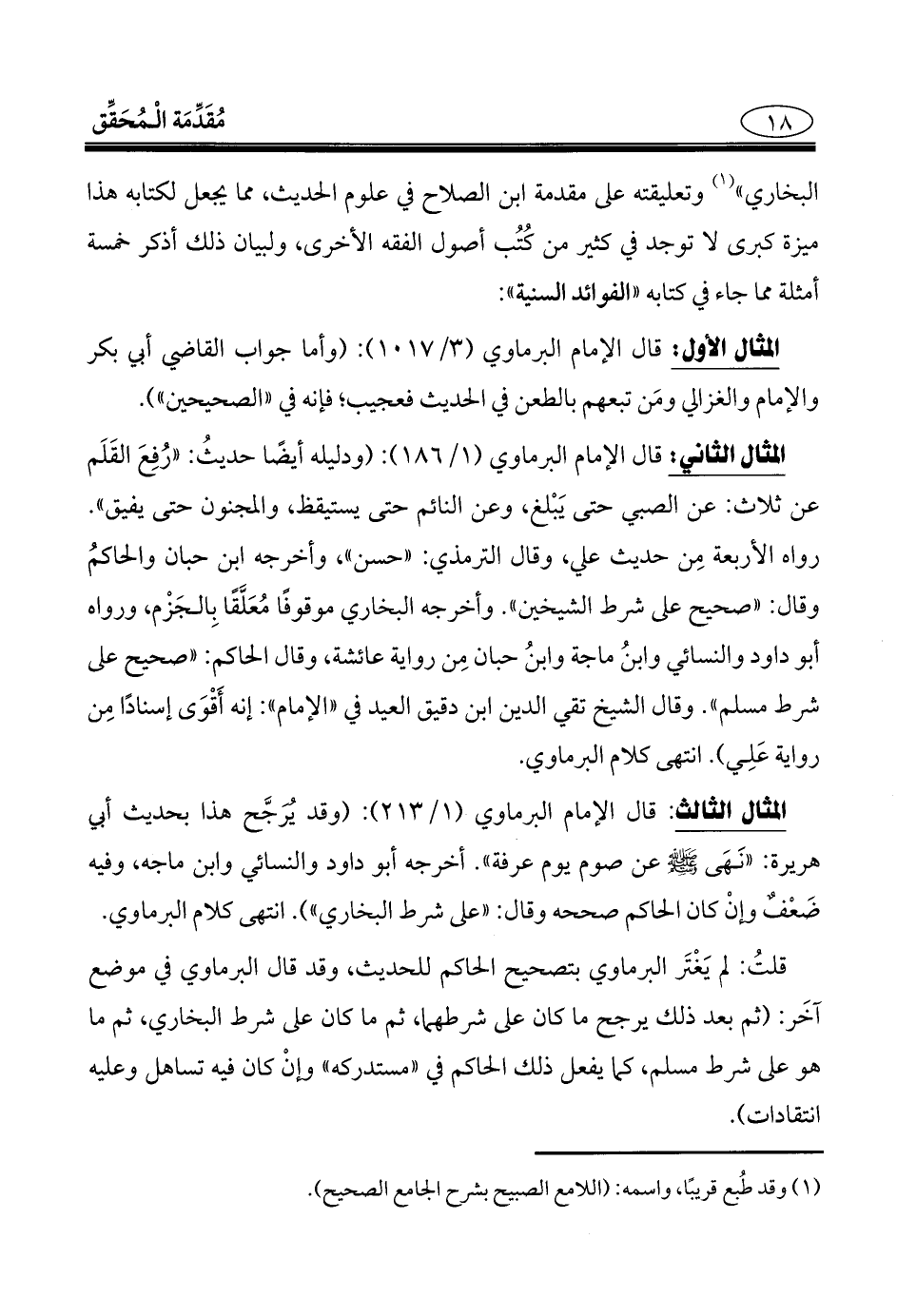
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية
البخاري" (¬1) وتعليقته على مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث، مما يجعل لكتابه هذا ميزة كبرى لا توجد في كثير من كُتُب أصول الفقه الأخرى، ولبيان ذلك أذكر خمسة أمثلة مما جاء في كتابه "الفوائد السنية":المثال الأول: قال الإمام البرماوي (3/ 1017): (وأما جواب القاضي أبي بكر والإمام والغزالي ومَن تبعهم بالطعن في الحديث فعجيب؛ فإنه في "الصحيحين").
المثال الثاني: قال الإمام البرماوي (1/ 186): (ودليله أيضًا حديثُ: "رُفِعَ القَلَم عن ثلاث: عن الصبي حتى يَبْلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق". رواه الأربعة مِن حديث علي، وقال الترمذي: "حسن"، وأخرجه ابن حبان والحاكمُ وقال: "صحيح على شرط الشيخين". وأخرجه البخاري موقوفًا مُعَلَّقًا بِالجَزْم، ورواه أبو داود والنسائي وابنُ ماجه وابنُ حبان مِن رواية عائشة، وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم". وقال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في "الإمام": إنه أَقْوَى إسنادًا مِن رواية عَلِي). انتهى كلام البرماوي.
المثال الثالث: قال الإمام البرماوي (1/ 213): (وقد يُرَجَّح هذا بحديث أبي هريرة: "نَهَى - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم عرفة". أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وفيه ضَعْفٌ وإنْ كان الحاكم صححه وقال: "على شرط البخاري"). انتهى كلام البرماوي.
قلتُ: لم يَغْتَر البرماوي بتصحيح الحاكم للحديث، وقد قال البرماوي في موضع آخَر: (ثم بعد ذلك يرجح ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما هو على شرط مسلم، كما يفعل ذلك الحاكم في "مستدركه" وإنْ كان فيه تساهل وعليه انتقادات).
¬__________
(¬1) وقد طُبع قريبًا، واسمه: (اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح).
وأما في أوائل غير براءة من السُّوَر فقطع الشافعي قوله بأنها آية من أول الفاتحة، واختلف قوله فيما سواها، ففي قول: إنها آية من أول كل سورة. وفي قولٍ: بعض آية. وفي قولٍ: لا آية ولا بعض آية. وعُزي للأئمة الثلاثة، بل لا يثبتها أحدٌ منهم في أول سورة. وفي قول رابع: إنها آية مقروءة للفصل بين السور. وهو غريب لم ينقله أحد من الأصحاب عن الشافعي، ولكنه في "الطارقيات" لابن خالويه عن الربيع، قال: سمعت الشافعي يقول: أولُ الحمد "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ"، وأول البقرة {الم}.
قال ابن الصلاح: وله حُسْنٌ، وهو أنها لَمَّا ثبتت أولًا في سورة الفاتحة، كانت في باقي السور إعادةً لها وتكرارًا، فلا تكون من تلك السورة ضرورة؛ ولذلك لا يقال: هي آية مِن أول كل سورة، بل هي آية في أول كل سورة.
قال بعض المتأخرين: وهذا أحسن الأقوال، وبه تنجمع الأدلة، فإن إثباتها في المصحف بين السُّوَر من سواده، وأجمع الصحابة - صلى الله عليه وسلم - أن لا يُكتب في المصحف ما ليس بِقُرآن، وأن ما بين دفتَي المصحف كلام الله، فإن في ذلك دليلًا واضحًا على ثبوتها.
قال القاضي حسين والغزالي والنووي وغيرهم: هو من أحسن الأدلة، ولم يَقُم دليل على كونها آية من أول كل سورة.
وكذلك ذهب أبو بكر الرازي من الحنفية إلى أنها آية مفردة أُنزلت للفصل بين السوَر. حكاه عنه ابن السمعاني في "الاصطلام".
وحكى المتولى من أصحابنا [وجهًا] (¬1): أنه إنْ كان الحرف الأخير من السورة قبله ياء ممدودة كالبقرة، فالبسملة آية كاملة منها، وإن لم يكن كذلك كما في {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ} [القمر: 1]، فبعض آية.
¬__________
(¬1) في (ز): طريقةً.
[ففيه] (¬1) أن أكثر الحيض خمسة عشر يومًا مع أنَّه غير مقصود من الحديث، بل من حيث إن لفظ "الشطر" يُشْعِر به؛ لأن المبالغة تقتضي أن أكثر ما يتعلق به الغرض ذلك، ولو كان زمان الحيض الذي تترك فيه الصلاة أكثر من ذلك لَذَكره.
نعم، [ذكر] (¬2) ابن دقيق العيد في كتاب "الإمام" عن البيهقي أنَّه قال: تتبعتُ هذا اللفظ - أي: لفظ "الشطر" - فلم أجده في شيء من كتب الحديث. وحينئد فيتعجب من القاضي أبي الطيب في اعتماده عليه في كتاب "المنهاج" في الاستدلال على أقَل الطهر مع معرفته بالحديث.
وقد أجاد تلميذه الشيخ أَبو إسحاق حيث لم يذكره في كتاب "النكت"، وقال في كتاب "المهذب": (لم أره إلَّا في كتب الفقه) (¬3). ولعله رأَى في كلام البيهقي ذلك.
نعم، في بعض كتب الحنابلة أن القاضي أبا يعلى عزاه إلى "السنن" لابن أبي حاتم، أما لفظ رواية البخاري في ذلك: "أليس إذا حاضت لم تُصل ولم تَصُم؟ [قال] (¬4): بلى. قال: فذلك من نقصان دينها" (¬5). ولمسلم نحوه، وفيه: "وتمكث الليالي ما تصلي، وتفطر في رمضان" (¬6). في جمع "ليلة"؛ حتَّى لا يُقْصَر على يوم وليلة.
¬__________
(¬1) في (ز): يفهم. وفي (ظ): نفهم.
(¬2) كذا في (ز، ظ). وفي سائر النسخ: قال.
(¬3) المهذب في فقه الإمام الشَّافعي (1/ 39).
(¬4) كذا في جميع النسخ، لكن لفظ البخاري: قُلْن.
(¬5) صحيح البخاري (رقم: 298).
(¬6) صحيح مسلم (79).
وإنْ حَمل السامع الجمع على واحد، الأكثر على المنع؛ لأنَّ المعْظَم على أن ألفاظ الجموع العامة نَصٌّ في أقَل الجمع وإنِ اختُلف في أنه اثنان أو ثلاثة.
وذهب الإمام إلى أنه يصح، فمسألة الإطلاق غير مسألة الحمل؛ كنظيره في المشترك في إطلاقه على معنييه وحَمْله عليهما.
قلتُ: وهذا عائد إلى ما سبق من أن كلام الإمام فيما ينتهي إليه التخصيص، فإن التخصيص إذا انتهى لواحد، [حمله] (¬1) السامع عليه.
وقد تحررت المسألة وكلام ابن الحاجب عن الإمام، ولله الحمد.
تنبيهات
الأول: في تحرير محل الخلاف:
فليس الخلاف في لفظ "جَمْع" الذي هو مَصْدر جمَع يَجمَعُ جَمْعًا؛ فإنَّ معنى ذلك لغةً: الضم، وهو صادق على اثنين اتفاقًا.
ولا في لفظ "جماعة"؛ فإن ذلك لاثنين فصاعدًا قطعًا، كما في حديث أبي موسى الأشعري كما رواه ابن ماجه لكن بطريق ضعيف، وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيما رواه الدارقطني من حديث عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي، وهو ضعيف وإنْ كان "عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده" محتجًّا به على الراجح.
نعم، للحديث طرق ضعيفة قد يتقوى بعضها ببعض أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الاثنان فما فوقهما جماعة" (¬2)، فإن القصد بذلك أيضًا الاجتماع؛ لحكمة تألُّف القلوب وغيرها.
¬__________
(¬1) كذا في (ص، ق)، لكن في (س): حمل.
(¬2) سنن ابن ماجه (972)، سنن الدارقطني (1/ 280)، المستدرك على الصحيحين (رقم 7957)، =
نحو: "لا تبيعوا البُر بالبُر إلا مِثلًا بِمِثل" (¬1). فالضمير في قولي: (وَلَوْ مُسْتَنْبَطًا) عائد لكل من الوصف والحكم.
نعم، في هذين خلاف، ففي قول: إنهما إيماء. وقول بالمنع. وفي ثالث اختاره الهندي: أن الأول -وهو التلفظ بالوصف- إيماء إلى تعليل الحكم المصرَّح به، لا العكس. بل ادَّعَى بعضهم الاتفاق على أن الثاني ليس بإيماء، ومال إليه الهندي وقال: الخلاف فيه بعيد نقلًا ومعنًى؛ لأنه يقتضي أن تكون العلة والإيماء متلازمين لا ينفك أحدهما عن الآخر.
وقولي: (أَوْ مَا رَأَوْا نَظِيرَهُ) المراد أن يرى القائس أن ذلك نظير الحكم المعلل بذلك الوصف كما سبق في قضاء الدَّين ونحوه.
وقولي: (عِلِّيَّةً) بالنصب مفعول الفعل في "لَوْ لَمْ يُفِدْ".
وقولي: (لَبَعُدَا) أي: لَبَعُدَ وقوع ذلك في لفظ الشارع الذي هو في غاية الفصاحة.
وقولي: (وَذَا كَتَفْرِيقٍ) هو تمثيل بأحد الأقسام الخمسة السابقة، وهو القسم الثالث كما مثلنا المذكورين فيه بأنَّ للفارس سهمين وللراجل سهمًا. والمذكور فيه أحد الحكمين أي مع ذكر وصف ويكون المحذوف مقابل الحكم مع علته وهو ضد الوصف.
نعم، هذه الأقسام من حققها يجد فيها بعض تداخل؛ لأنه يمكن رَدُّ بعض منها لبعض؛ فلذلك لم أتعرض لجميعها في النَّظم.
¬__________
(¬1) مصنف ابن أبي شيبة (22484) والسنن الكبرى للبيهقي (10261) بلفظ: (لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر ... إلا مثلا بمثل. .) الحديث. وبنحوه في: سنن النسائي (4560)، صحيح ابن حبان (5015)، وغيرهما.