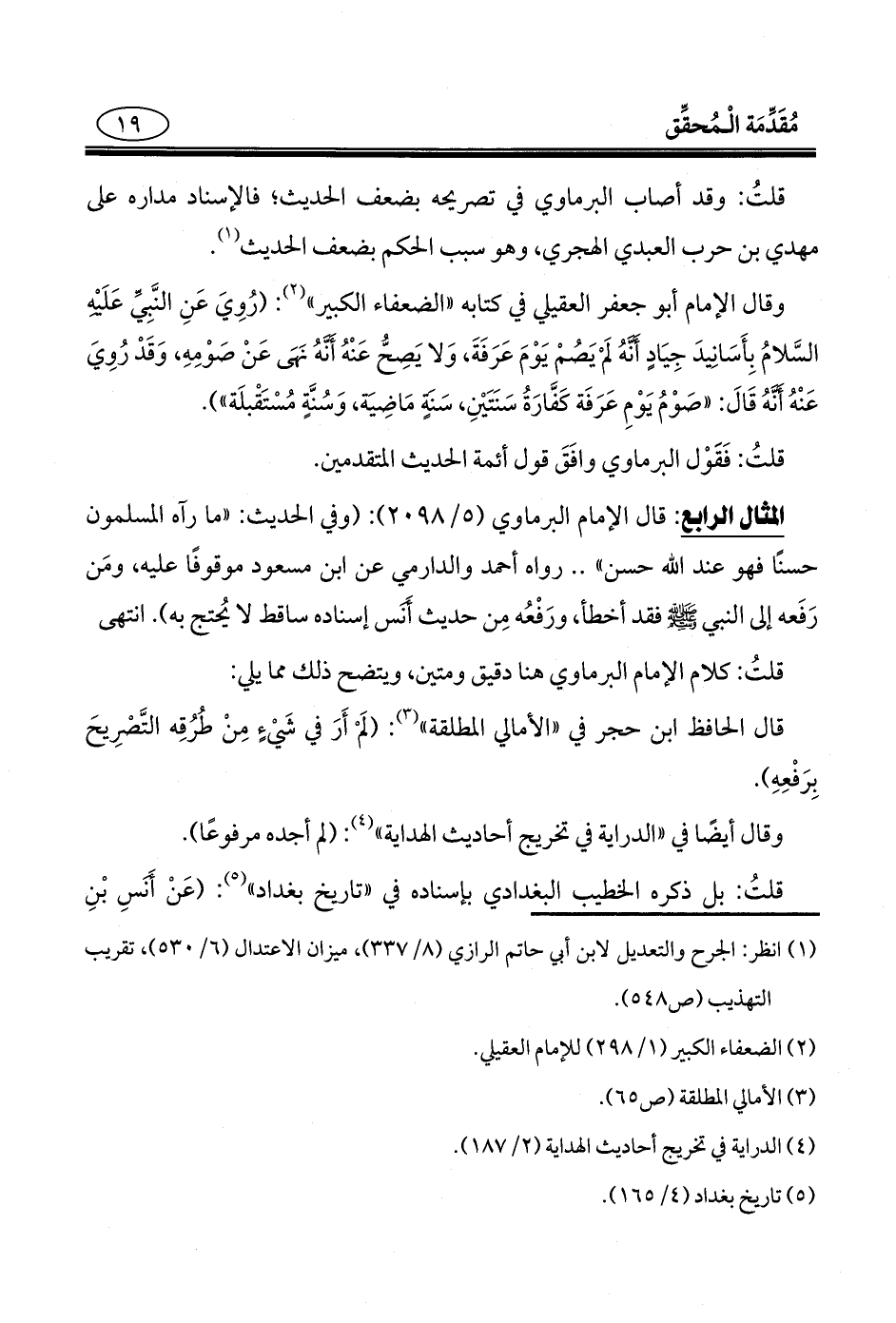
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية
قلتُ: وقد أصاب البرماوي في تصريحه بضعف الحديث؛ فالإسناد مداره على مهدي بن حرب العبدي الهجري، وهو سبب الحكم بضعف الحديث (¬1).وقال الإمام أبو جعفر العقيلي في كتابه "الضعفاء الكبير" (¬2): (رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلامُ بِأَسَانِيدَ جِيَادٍ أَنَّهُ لَمْ يَصُمْ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَلا يَصِحُّ عَنْهُ أَنَّهُ نَهَى عَنْ صَوْمِهِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: "صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَة كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ، سَنَةٍ مَاضِيَة، وَسَنَةٍ مُسْتَقْبلَة").
قلتُ: فَقَوْل البرماوي وافَقَ قول أئمة الحديث المتقدمين.
المثال الرابع: قال الإمام البرماوي (5/ 2098): (وفي الحديث: "ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن" .. رواه أحمد والدارمي عن ابن مسعود موقوفًا عليه، ومَن رَفَعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد أخطأ، ورَفْعُه مِن حديث أَنَس إسناده ساقط لا يُحتج به). انتهى
قلتُ: كلام الإمام البرماوي هنا دقيق ومتين، ويتضح ذلك مما يلي:
قال الحافظ ابن حجر في "الأمالي المطلقة" (¬3): (لَمْ أَرَ في شَيْءٍ مِنْ طُرُقِه التَّصْرِيحَ بِرَفْعِهِ).
وقال أيضًا في "الدراية في تخريج أحاديث الهداية" (¬4): (لم أجده مرفوعًا).
قلتُ: بل ذكره الخطيب البغدادي بإسناده في "تاريخ بغداد" (¬5): (عَنْ أَنَسِ بْنِ
¬__________
(¬1) انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي (8/ 337)، ميزان الاعتدال (6/ 530)، تقريب التهذيب (ص 548).
(¬2) الضعفاء الكبير (1/ 298) للإمام العقيلي.
(¬3) الأمالي المطلقة (ص 65).
(¬4) الدراية في تخريج أحاديث الهداية (2/ 187).
(¬5) تاريخ بغداد (4/ 165).
ومما استُدل به على أنها من الفاتحة - غير ما سبق من تَضَمُّن مصاحف الصحابة فمن بعدهم لها بل وفي سائر السور غير براءة - ما صح عن أُم سلمة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ البسملة في أول الفاتحة، وعَدَّها آية" (¬1). وعن ابن عباس في قوله تعالى: {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي} [الحجر: 87] قال: هي فاتحة الكتاب. قيل: فأين السابعة؟ قال: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (¬2). أخرجهما ابن خزيمة في "الصحيح" وغيره.
وعن ابن عباس قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" (¬3). رواه أبو داود، والحاكم وقال: على شرط الشيخين. وعن علي وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم أن الفاتحة هي السَّبع المثاني وهي سبع آيات، والبسملة السابعة. وفي بعض الروايات عن أبي هريرة ذلك مرفوعًا. رواه البيهقي والدارقطني، والروايات في ذلك كثيرة.
ونحن لا ندَّعِي في ذلك أنه تواتر، بل إما أن نقول: أفاد القطع بانضمام القرائن إليه؛ فإنَّ خبر الآحاد إذا احتفت به القرائن الموجِبة للقطع، أفاد القَطْع.
أو نقول: إنه وإن لم يتواتر عندنا فقد تواتر عند مَن نُقلده، وهو الإمام الشافعي - رضي الله عنه -، ورُب تواتر يكون في زمن دُون آخَر، ولشخص دون آخر، وإثباته ذلك قرآنا والقرآنُ لا يَثْبت إلا بالتواتر - يدل على تواترها عنده.
أو نقول: إنها ليست من القرآن القطعي، بل من الحكمي، وهو أصح الوجهين الذين
¬__________
(¬1) صحيح ابن خزيمة (493)، مستدرك الحاكم (848)، السنن الكبرى للبيهقي (رقم: 2214).
(¬2) السنن الكبرى للبيهقي (رقم: 2216)، مستدرك الحاكم (2024) وغيرهما.
(¬3) سنن أبي داود (رقم: 788)، السنن الكبرى للبيهقي (2206). قال الألباني: صحيح. (صحيح سنن أبي داود: 788).
تنبيهات
الأول: جَعْلُ الاقتضاء والإشارة مِن أقسام المنطوق وكذا التنبيه والإيماء اللذان سبق ذِكرهما - هو طريقة ابن الحاجب، على خلاف ما صرح به الغزالي في "المستصفى" وجَرى عليه البيضاوي وغيره مِن كونها أقسامًا للمفهوم، وقَوَّى هذا بعضهم.
وتُعُقِّب على ابن الحاجب ما صَنَع مع قوله: (إن "المنطوق" ما دل في محل النطق، و"المفهوم" في غير محل النطق) (¬1)، فأين دلالة محل النطق في هذه؟
وأما الآمدي فمقتضى ما ذكره في "إحكامه" أن ذلك ليس مِن المنطوق ولا من المفهوم.
وقد وقع بين الشيخين علاء الدين القونوي وشمس الدين الأصفهاني بحث في ذلك، وكتبَا فيه رسالتين، وانتصر الأصفهاني لابن الحاجب، وهو الظاهر؛ لأنَّ لِلَّفظ دلالة عليها من حيث هو منطوق كما قررناه، بخلاف المفهوم كما سيأتي، فإنه إنما يدل من حيث [هو] (¬2) قضية عقلية خارجة عن اللفظ.
قال بعض شيوخنا: ويمكن أن يجعل ذلك واسطة بين المنطوق والمفهوم؛ ولهذا اعترف بها مَن يُنكر "المفهوم".
الثاني - مِن مُثُل (¬3) الحنفية [لدلالة] (¬4) الإشارة قوله تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ} [الحشر: 8]، الآية، قالوا: تدل على أن الكفار يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء مع أنَّها إنما
¬__________
(¬1) مختصر المنتهى (2/ 431) مع (بيان المختصر).
(¬2) من (ز، ظ).
(¬3) جمع "مِثال".
(¬4) كذا في (ص). لكن في سائر النُّسخ: دلالة.
ونحوه حديث النهي عن السفر إلا في جماعة (¬1)؛ لِمَا في الاجتماع من الأُنس والأمن وغير ذلك.
وليس الخلاف أيضًا في نحو: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4] وإنِ استدل به بعض من يرى أن أقَل الجمع اثنان، وهو مردود؛ لأن ذلك إنما هو لأن قاعدة اللغة أن كل اثنين أُضيفَا إلى مُتَضَمِّنيهما يجوز فيه ثلاثة أَوْجُه:
- الجمع على الأفصح، نحو: "قطعت رؤوس الكبشين".
- ثم الإفراد، كَـ"رأس الكبشين".
- ثم التثنية، كَـ"رأسَي الكبشين".
وإنما رُجح الجمع استثقالًا لتوالي دالَّين على شيءٍ واحد وهو التثنية، وتضمن الجمع التعدد، بخلاف ما لو أُفْرِد.
فالخلاف حينئذٍ إنما هو في الدال على الجمعية لا بطريق التثنية، وهي صِيَغ الجموع وما في معناها من أسماء الجموع، كَـ"قوم، ورهط، وخيل، ونساء، وبقر، وتمر"، ونحو: "أُولي،
¬__________
=وغيرها. قال الألباني: ضعيف. (إرواء الغليل: 489).
(¬1) في مسند أحمد (5650): (عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْوَحْدَةِ، أَنْ يَبِيتَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ، أَوْ يُسَافِرَ وَحْدَهُ). قال الحافظ العراقي في (تخريج أحاديث الإحياء، ص 721): (أخرجه أحمد من حديث ابن عمر بسند صحيح).
وفي: مصنف ابن أبي شيبة (26388)، المراسيل لأبي داود (ص 237، رقم: 311)، وغيرهما: عَنْ عَطَاء، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُسَافِرَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ، أَوْ يَبِيتَ فِي بَيْتٍ وَحْدَهُ".
وفي صحيح البخاري (2836) عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوحْدَةِ مَا أَعْلَمُ، مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ".
تنبيه:
لم أتعرض في الإيماء في النَّظم لاعتبار المناسبة في الوصف؛ لأنه لا يعتبر إلا في القسم الرابع فقط.
وقد حكى ابن الحاجب وغيره في ذلك ثلاثة مذاهب:
أحدها: اشتراط المناسبة في الوصف في كل قسم من أقسام الإيماء، وهو ما اختاره الغزالي؛ لأن تصرف العقلاء المستند للتعليل لا بُدَّ في علته من حِكمة؛ لقبح "أكرِم الجاهل وأَهِن العالم".
وثانيها: لا يشترط مطلقًا، أي: في غير القسم الرابع؛ لأنَّ العلة بمعنى المعرِّف. وهذا هو المعْزي للأكثرين؛ فلذلك لم أُقيِّد المسألة في النَّظم بالوصف المناسب.
والثالث واختاره ابن الحاجب: إن كان التعليل فُهِم مِن المناسبة مثل: "لا يقضي القاضي وهو غضبان"، اشتُرطت، وإلا فلا. وغايته ما ذكرته من اعتبار المناسبة في القسم الرابع دُون بقية الأقسام.
فإنْ قلت: فمِن أين يخرج القسم الرابع الذي في المناسبة مِن الذي ذكرته في النَّظم.
قلت: لأنه لَّمَا كان راجعًا إلى استنباط كونه علة بما فيه من المناسبة، كان داخلًا فيما سيأتي مِن طُرق العلة وهو "المناسبة". وإنما ذكرته مِن أقسام الإيماء هنا تبعًا لابن الحاجب وغيره في ذِكرهم له من الإيماء مِن حيث اشتماله على معنى مُومَأ إليه، وقد تقدم إيضاحه. والله أعلم.