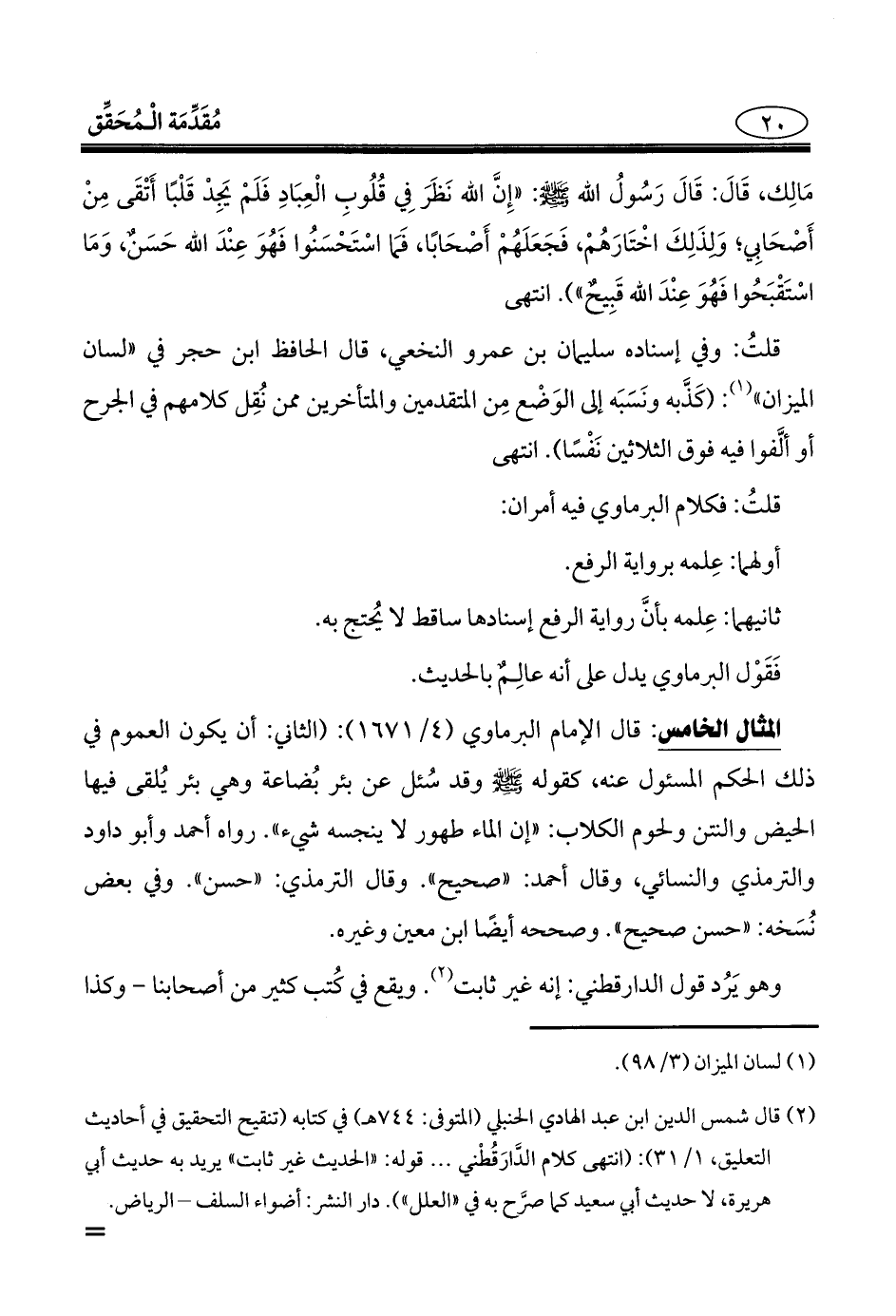
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية
مَالِك، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الله نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَلَمْ يَجِدْ قَلْبًا أَتْقَى مِنْ أَصْحَابِي؛ وَلِذَلِكَ اخْتَارَهُمْ، فَجَعَلَهُمْ أَصْحَابًا، فَمَا اسْتَحْسَنُوا فَهُوَ عِنْدَ الله حَسَنٌ، وَمَا اسْتَقْبَحُوا فَهُوَ عِنْدَ الله قَبِيحٌ"). انتهىقلتُ: وفي إسناده سليمان بن عمرو النخعي، قال الحافظ ابن حجر في "لسان الميزان" (¬1): (كَذَّبه ونَسَبَه إلى الوَضْع مِن المتقدمين والمتأخرين ممن نُقِل كلامهم في الجرح أو ألَّفوا فيه فوق الثلاثين نَفْسًا). انتهى
قلتُ: فكلام البرماوي فيه أمران:
أولهما: عِلمه برواية الرفع.
ثانيهما: عِلمه بأنَّ رواية الرفع إسنادها ساقط لا يُحتج به.
فَقَوْل البرماوي يدل على أنه عالِمٌ بالحديث.
المثال الخامس: قال الإمام البرماوي (4/ 1671): (الثاني: أن يكون العموم في ذلك الحكم المسئول عنه، كقوله - صلى الله عليه وسلم - وقد سُئل عن بئر بُضاعة وهي بئر يُلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء". رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وقال أحمد: "صحيح". وقال الترمذي: "حسن". وفي بعض نُسَخه: "حسن صحيح". وصححه أيضًا ابن معين وغيره.
وهو يَرُد قول الدارقطني: إنه غير ثابت (¬2). ويقع في كُتب كثير من أصحابنا - وكذا
¬__________
(¬1) لسان الميزان (3/ 98).
(¬2) قال شمس الدين ابن عبد الهادي الحنبلي (المتوفى: 744 هـ) في كتابه (تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، 1/ 31): (انتهى كلام الدَّارَقُطْني ... قوله: "الحديث غير ثابت" يريد به حديث أبي هريرة، لا حديث أبي سعيد كما صرَّح به في "العلل"). دار النشر: أضواء السلف - الرياض. =
حكاهما الماوردي في أنها هل هي قرآن على سبيل القطع كسائر القرآن؟ أو على سبيل الحكم؛ لاختلاف العلماء فيها؟
ومعنى "سبيل الحكم" أنه لا تصح الصلاة إلا بها في أول الفاتحة، ولا تكون قراءتها بكمالها إلا بها. قال: وجمهور أصحابنا على أنها قرآن حُكمًا، لا قطعًا.
قال ابن السمعاني: فيكون قرآنا عملًا، لا عِلمًا. قال: كالحجر من البيت في الطواف لا في الاستقبال، فهو حُكمي، لا قطعي.
وكذا ضعَّف الإمامُ القولَ بأنها قرآن قطعي، وقال: إنه غباوة عظيمة من قائله؛ لأن ادِّعاء العِلم حيث لا قاطع مُحَالٌ.
وصحح أيضا النووي القول بأنها حُكمي، واستند إلى منع تكفير النافي لها إجماعًا كما هو المعروف. وإن كان العمراني حكى في "زوائده" عن صاحب "الفروع" أنَّا إذا قلنا: إنها من الفاتحة قطعًا، كفَّرنا نافِيها، وفسَّقنا تاركها.
لكن لا التفات لذلك، ومن أجل ذلك قال ابن الحاجب: (وقوة الشبهة في "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" منعت من التكفير من الجانبين) (¬1).
أيْ: جانب المثبتين لها (كالشافعية) والنافين لها (كالأئمة الثلاثة والقاضي أبي بكر).
لكن هذا إنما هو إذا أثبتناها قرآنًا قطعيًّا، أما إذا أثبتناها حكميًّا، فليس هنا مُقْتَضٍ للتكفير حتى يُدْفع بالشُّبهة، وكذا إذا قُلنا: إنه قطع بتواترها عند القائل به دُون غيره، أو: إنَّ القطع بالقرائن كما سبق.
على أن القطع وحده لا يوجب تكفير النافي، بل لا بُدَّ أن يكون المقطوع به مجمعًا عليه
¬__________
(¬1) مختصر المنتهى مع شرح الأصفهاني (1/ 457).
سيقت لبيان استحقاقهم مِن الغنيمة، ووجه الإشارة إلى أنهم يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء أن الله سماهم"فقراء" مع إضافة الأموال إليهم، والفقير مَن لا مال له، لا مَن لا تصل يده إلى المال وإنْ كان مِلْكًا له، فلو كانت باقية على ملكهم، لزم المجاز وهو خِلَاف الأصل.
وضُعِّف بأن التسمية وإن دَلَّت على ما ذكروه لكن إضافة الأموال إليهم تدل على بقاء ملكهم؛ إذِ الأصل في الإضافة الملك، فليس حملهم الإضافة على المجاز وإجراء التسمية المذكورة على الحقيقة بأوْلى مِن العكس، والله أعلم.
ص:
461 - وَإنْ يَكُنْ لَا في مَحَلِّ النُّطْقِ ... دَلَّ، فَـ "مَفْهُومٌ "يُرَى بِصِدْقِ
الشرح:
هذا مقابل ما سبق مِن دلالة اللفظ بمنطوقه.
فَـ "المفهوم": ما دَلَّ لا في محل النطق. وسبق وجه تسميته "مفهومًا".
واختلفوا في وجه استفادة الحكم منه: هل هو بدلالة العقل مِن جهة التخصيص بالذِّكْر؟ أو مستفاد مِن اللفظ؟ على قولين:
قطع إمام الحرمين في "البرهان" بالثاني. و [رَدَّه] (¬1) أَبو الفرج في "نكته"؛ فإنَّ اللفظ لا يُشعر بذاته، وإنَّما دلالته بالوضع، ولا شك أن العرب لم تضع اللفظ ليدل على شيء مسكوت عنه؛ لأنه إما أن يُشعر به بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز، وليس "المفهوم" واحدًا منهما.
¬__________
(¬1) كذا في (ص). لكن في سائر النُّسخ: رواه.
وأولات"، ونحو: "الذين، واللاتي"، ونحو: "هؤلاء"، ونحو: "فعلوا، وفعلنا" كما سبقت الإشارة إليه.
فالخلاف في ذلك كله مطَّرد كما يُفهم من أمثلِتهم واستدلالاتهم، كاستدلال الإمام الرازي وأتباعه بقوله تعالى: {وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ} [الأنبياء: 78] لمن قال: أقَل الجمع اثنان. وأجابوا عنه بأن المتقدم وإنْ كان داود وسليمان فقط لكن ضُم معهما المحكوم فيهما وهُما الخصمان.
نعم، رُدَّ هذا الجواب بأن المصدر إنما يضاف إلى فاعِله تارةً وإلى مفعوله أخرى، أما لهما معًا فلا، حتى [قال] (¬1) أبو حيان: سمعتُ شيخنا أبا جعفر بن الزبير يقول: إنه جواب مَن لا يعرف شيئًا من العربية.
نعم، أشار ابن الحاجب في "مختصره الكبير" إلى تصحيحه بأنَّ "حُكم" هنا ليس مصدرًا حتى يُرَدَّ بذلك، بل المراد به "الأمر"، أي: أَمْر داود وسليمان والخصمين؛ فصَحَّ إضافته للكل، فاستقام الجواب.
قيل: وفيه تَكَلُّف.
قلتُ: لكنه أَوْلى مِن نِسبة هؤلاء الأئمة إلى جهل مِثل هذا، ويؤيد ذلك أنه يقال: (حضرت حكومة القاضي فلان وفلان وفلان المتحاكمين عنده). والإضافة تَصدُق بأدنى ملابسة، فإذا كان الحكم المراد به المحاكمة الصادرة بين الحاكم والمحكوم عليه، وضح ذلك.
الثاني:
قد سبق الفرق بين جَمعَي القِلة والكثرة، فإطلاق الخلاف حتى يشملهما مما يُستشكَل
¬__________
(¬1) في (ص): قال شيخنا.
ص
809 - وَالرَّابِعُ: "السَّبْرُ" مَعَ "التَّقْسِيمِ" ... بِحَصْرِهِ الْأَوْصَافَ بِالتَّتمِيمِ
810 - في الْوَصْفِ مَعْ إبْطَالِ مَا لَا يَصْلُحُ ... مِنْهَا؛ فَبَاقِيهَا الَّذِي يُسْتَصْلَحُ
811 - فَمَا يَكُونُ حَصْرُهُ قَطْعِيَّا ... قَطْع، وَغَيْرُهُ يُرَى ظَنِّيَّا
812 - وَكُلُّ هَذَا حُجَّة لِلنَّاظِرِ ... وَهَكَذَا يَكُونُ لِلْمُنَاظِرِ
الشرح:
الرابع من الطُّرق الدالة على العِلة "السبر والتقسيم"، وهو ذِكر أوصاف في الأصل المقيس محصورة، وإبطال بعضها بدليل؛ فَيَتَعَيَّن الباقي للعِلية. سُمي بذلك؛ لأن الناظر يقسم الصفات ويختبر صلاحية كل واحد منها للعلية، فيُبْطِل ما لا يَصْلح ويُبقِي ما يصلح.
و"السبر" في اللغة هو: الاختبار. وكان الأَوْلى أن يقال: "التقسيم والسبر"؛ لأن "الواو" وإنْ لم تدل على الترتيب لكن البداءة بالمقدَّم أَجْوَد.
وأجاب بعضهم عن ذلك بأنه أول ما يسبر أنَّ له علة، ثم يقسم، ثم يعود فيسبر الأوصاف.
قلنا: بهذا الاعتبار سَبْر سابِق به سُمي هذا النوع "سبرًا وتقسيمًا"، ولا مدخل للسبر المتأخر في التسمية.
وفي ذلك نظر؛ لأن لنا تقسيمًا سابقًا على هذا السبر المدَّعَى وهو أن نقول: إنَّ هذا الحكم إما له علة أو تعبُّدي لا علة له. ثم نسبر؛ [لنفي] (¬1) كونه تعبُّدًا، ثم نقسم الأوصاف، فكونه
¬__________
(¬1) كذا في (ت)، لكن في (ص، ق، ش): بنفي.