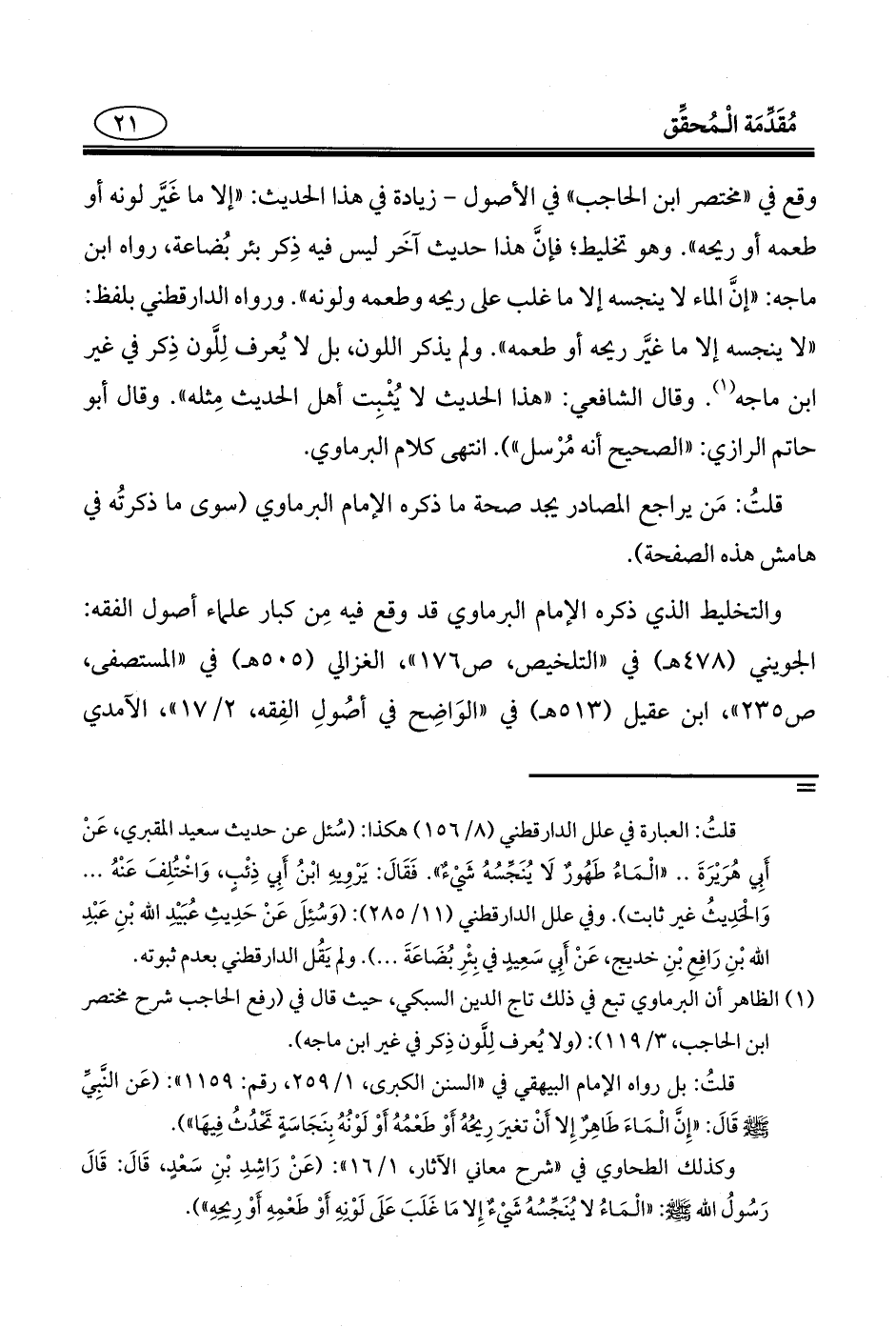
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية
وقع في "مختصر ابن الحاجب" في الأصول - زيادة في هذا الحديث: "إلا ما غَيَّر لونه أو طعمه أو ريحه". وهو تخليط؛ فإنَّ هذا حديث آخَر ليس فيه ذِكر بئر بُضاعة، رواه ابن ماجه: "إنَّ الماء لا ينجسه إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه". ورواه الدارقطني بلفظ: "لا ينجسه إلا ما غيَّر ريحه أو طعمه". ولم يذكر اللون، بل لا يُعرف لِلَّون ذِكر في غير ابن ماجه (¬1). وقال الشافعي: "هذا الحديث لا يُثْبِت أهل الحديث مِثله". وقال أبو حاتم الرازي: "الصحيح أنه مُرْسل"). انتهى كلام البرماوي.قلتُ: مَن يراجع المصادر يجد صحة ما ذكره الإمام البرماوي (سوى ما ذكرتُه في هامش هذه الصفحة).
والتخليط الذي ذكره الإمام البرماوي قد وقع فيه مِن كبار علماء أصول الفقه: الجويني (478 هـ) في "التلخيص، ص 176"، الغزالي (505 هـ) في "المستصفى، ص 235"، ابن عقيل (513 هـ) في "الوَاضِح في أصُولِ الفِقه، 2/ 17"، الآمدي (631 هـ)
¬__________
= قلتُ: العبارة في علل الدارقطني (8/ 156) هكذا: (سُئل عن حديث سعيد المقبري، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .. "الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ". فَقَالَ: يَرْوِيهِ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ ... وَالْحَدِيثُ غير ثابت). وفي علل الدارقطني (11/ 285): (وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ رَافِعِ بْنِ خديج، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ في بِئْرِ بُضَاعَةَ ... ). ولم يَقُل الدارقطني بعدم ثبوته.
(¬1) الظاهر أن البرماوي تبع في ذلك تاج الدين السبكي، حيث قال في (رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب، 3/ 119): (ولا يُعرف لِلَّون ذِكر في غير ابن ماجه).
قلتُ: بل رواه الإمام البيهقي في "السنن الكبرى، 1/ 259، رقم: 1159": (عَن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ الْمَاءَ طَاهِرٌ إِلا أَنْ تغيرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهَا").
وكذلك الطحاوي في "شرح معاني الآثار، 1/ 16": (عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الْمَاءُ لا يُنَجَّسُهُ شَيْءٌ إِلا مَا غَلَبَ عَلَى لَونهِ أَوْ طَعْمِهِ أَوْ رِيحِهِ").
معلومًا من الدين بالضرورة.
ثم قال ابن الحاجب: (والقطع أنها لم تتواتر) (¬1) إلى آخِره.
وهو عجيب، فأيُّ قَطْع مع قوة الشُّبهة - على قوله؟ ! وكذلك مبالغة القاضي في تخطئة القول بأنها من القرآن - لا يلاقي مُدَّعَى أنَّ ذلك حُكمي لا قطعي، أو بتواتر حصل له، أو بقطع بقرائن كما سبق بيانه.
نعم، كونه قرآنًا حكميًّا هو [أوضح] (¬2) الأوجُه الثلاثة؛ فلذلك اقتصرتُ عليه في النَّظم بقولي: (سِوَى مَا كَانَ حُكْمِيًّا). أي: فإنَّ الحكمي لا يحتاج لتواتر، وبه تندفع الإشكالات كلها إن شاء الله تعالى.
وقولي: (بَرَاءَةَ الصِّلَهْ) أيْ التي توصل بما قبلها مِن غير فصل بالبسملة، كما قال ابن عباس: قلت لعثمان: ما حملَكم على أنْ قرنتم بين الأنفال وهي في المثاني وبراءة وهي من المئين، فلم تكتبوا بينهما تسمية ووضعتموها في السبع الطوَل؟ فقال: الأنفال نزلت بالمدينة، وبراءة من أواخر ما نزل، فكانت القصة تشبه بعضها بعضًا، وقُبض - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، فقَرنَّا بينهما (¬3).
وهذه المسألة في الحقيقة من مسائل الفقه، وإنما ذكرناها تفريعًا على ما بيناه في الأدلة الثلاثة من أنه لا بُدَّ من ثبوته بالسند، فهو تقسيم [لسندها] (¬4)، فالكتاب بالتواتر، وكُل من
¬__________
(¬1) مختصر المنتهى مع شرحه (1/ 462).
(¬2) في (ز): أصح.
(¬3) سنن أبي داود (786)، وسنن الترمذي (رقم: 3086) وغيرهما. قال الألباني: ضعيف. (ضعيف سنن أبي داود: 786).
(¬4) كذا في (ص، ت)، لكن في (ز): لسندهما.
وبنى على هذا أنَّه لا يصح الاستدلال بِكَون أهل العربية صاروا إلى المفهوم، فإنهم إنما أخذوه بطريق الاستدلال بالعقل، وقد يخطئون فيكونون كغيرهم.
نعم، لا خلاف أن دلالته ليست وضعية، إنما هي انتقالات ذهنية من باب التنبيه بشيء على شيء، وبالجملة فالمفاهيم التركيبية مِن عوارضه.
قولي: (فَـ "مَفْهُومٌ " يُرَى بِصِدْقِ) هو جواب الشرط، فيُقرأ "مفهوم" بالرفع خبر مبتدأ محذوف، أي: فهو مفهوم. ويجوز أن يقرأ بالنصب مفعولا ثانيًا لـ "يُرى"؛ لأن "رأَى" بمعنى "عَلِم" يتعدى لمفعولين، و"بصدق" في محل نصب على الحال. والله أعلم.
ص:
462 - فَإنْ يَكُنْ مَسْكُوتُه قَدْ وَافَقَا ... مَذْكُورَهُ حُكْمًا، يَكُنْ "مُوَافِقَا"
463 - "فَحْوَى الْخِطَابِ" إنْ يَكُنْ بِالْأَوْلَى ... وَ"لَحْنه" عِنْدَ اسْتِوَاءٍ يُجْلَى
464 - وَالشَّافِعِيُّ قَدْ رَأَى "الْمُوَافَقَهْ" ... مِنَ الْقِيَاسِ، لَا بِلَفْظٍ وَافَقَه
465 - فَهْمًا، وَلَا بِنَقْلِ لَفْظٍ لِلْأَعَمْ ... عُرْفًا، وَلَا قَرَائِنٍ بِتِلْكَ عَمْ
الشرح:
إذا عُلم معنى المفهوم، فهو على ضربين: مفهوم موافقة، ومفهوم مُخَالَفَةُ.
فالأول: ما وافق فيه حُكمُ المسكوت حكمَ المذكور. وهو معنى قولي: (يَكُنْ "مُوَافِقَا")، أي: يُسمى ذلك المسكوت في الاصطلاح "مواففا"، ويُسمى المفهوم فيه "موافقة"؛ لوفق التنبيه المراد المعنى اللغوي.
فَقَولي: (قَدْ وَافَقَا) المراد به المعنى اللغوي، وقولي: ("مُوَافِقَا") آخِر البيت - المراد به المعنى الاصطلاحي حتَّى لا يتحد الشرط والجزاء، والضمير المخفوض في "مسكوته" عائد
باتفاق النحاة على أنَّ جمع الكثرة مِن أحد عشر فصاعدًا. فإنْ كان الخلاف في جمع القِلة فكيف يُطلِقون؟ وكيف يأتون في مُثُلهم واستدلالهم بكثير من جموع الكثرة؟ ! فإنْ كان ذلك لأن كُلًّا منهما يُطلق في معنى الآخَر، فمجاز كما سبق وصرح به الزمخشري وغيره، والكلام إنما هو في الإطلاق حقيقةً، حتى قال القرافي في بعض كُتبه أنَّ له نحوًا من عشرين سَنة يُورده ولم يتحصل عنه جواب.
قلتُ: إذا كان جمع القِلة يجري فيه الخلاف لا محالة، فالتجوز باستعمال "جمع الكثرة" في "جمع القِلة" يُصَيِّره كأنه مِن جموع القِلة، لا سيما إذا استُغنِي به عنه طرَقَهُ الخلافُ مِن حيث كونه صار مِن هذا النوع، فيُحكم عليه بما يُحكم على جمع القِلة، ويقع به التمثيل، وتترتب الأحكام كما ستراه في الفروع الآتية.
ونظير ذلك اليَدُ في السَّوْم والبيع الفاسد يَدُ غَصْبٍ مجَازًا، ويترتب عليها أحكام الغصب من الضمان بأقصى القيم من الغصب إلى التلف.
وكذا ما ذكر في الممْسِك في رمضان هل يُكره له السواك بعد الزوال كالصوم وإن أُطلق عليه صائم مجَازًا؟ ونحو ذلك.
بل قد يُدَّعَى أنَّ التجوز باستعمال "جمع الكثرة" موضع "جمع القِلة" إنما هو في الأصل، ثُم غلب في الاستعمال حتى صار حقيقة عُرفية.
كما قالوا في "غَنَم يَغْنَم": إنه أَخْذُ الغنم. ثم استُعمل في أَخْذ كل مال وغَلَبَ في كل نماء، كما في حديث: "له غنمه وعليه غرمه" (¬1).
ونحوه في "السلب"، أصله فيما يلبسه، ثم عدوه إلى الفرس وآلة السلاح وغير ذلك،
¬__________
(¬1) صحيح ابن حبان (5934)، المستدرك على الصحيحين (رقم: 2315)، سنن البيهقي الكبرى (رقم: 11002). قال الألباني: ضعيف. (التعليقات الحسان: 5934).
علما باعتبار السبر الأول والتقسيم مِن غير نظر إلى السبر الثاني خِلاف الظاهر.
وإنما ينبغي أن يجاب بأنَّ المؤثِّر في عِلْم العِلية إنما هو السبر، وأما التقسيم فإنما هو لاحتياج السبر إلى شيء يُسْبَر. وربما سُمي ذلك بِـ "التقسيم الحاصر" كما هو عبارة البيضاوي.
وهو ضربان:
أحدهما: ما يكون الحصر في الأوصاف وإبطال ما يبطل منها قطعيًّا، فيكون دلالة قطعية بلا خلاف. ولكن هذا قليل في الشرعيات.
ثانيهما: ما يكون حصر الأوصاف ظنيًّا أو السبر ظنيًّا أو كلاهما وهو الأغلب، فلا يفيد إلا الظن. ويُعمل به فيما لا يُتعبَّد فيه بالقَطْع من العقائد ونحوها.
كقول الشافعي مثلًا: ولاية الإجبار على النكاح إما أن لا تُعَلل أو تُعَلل. وحينئذٍ فإما أن تكون العِلة البكارة أو الصغر أو غيرهما. وما عدا القِسم الثاني باطل. الأول والرابع بالإجماع. وأما الثالث فلأنه لو كانت العلة الصغر لَثبت على الثيب الصغيرة، وذلك باطل؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الأيم أحق بنفسها" (¬1). أخرجه مسلم. والأيم: هي الثيب.
وأما ما استُفيد الحصر فيه مِن كون الأصل عدم ذلك فيسمى "التقسيم المنتشر"، ويحتج به باعتبار استناده للأصل.
مثاله: أنْ يقال في علة الربا فيما عدا النقدين من الربويات: إنها إما الطعم أو الكيل أو القوت. والثاني والثالث باطلان؛ فَتَعَيَّن الطعم؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "الطعام بالطعام" (¬2) الحديث، فعلق بالطعام وهو مشتق من الطعم، فيكون مُعللًا بما منه الاشتقاق. وهذا دليل على أن غير
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.
(¬2) صحيح مسلم (1592).