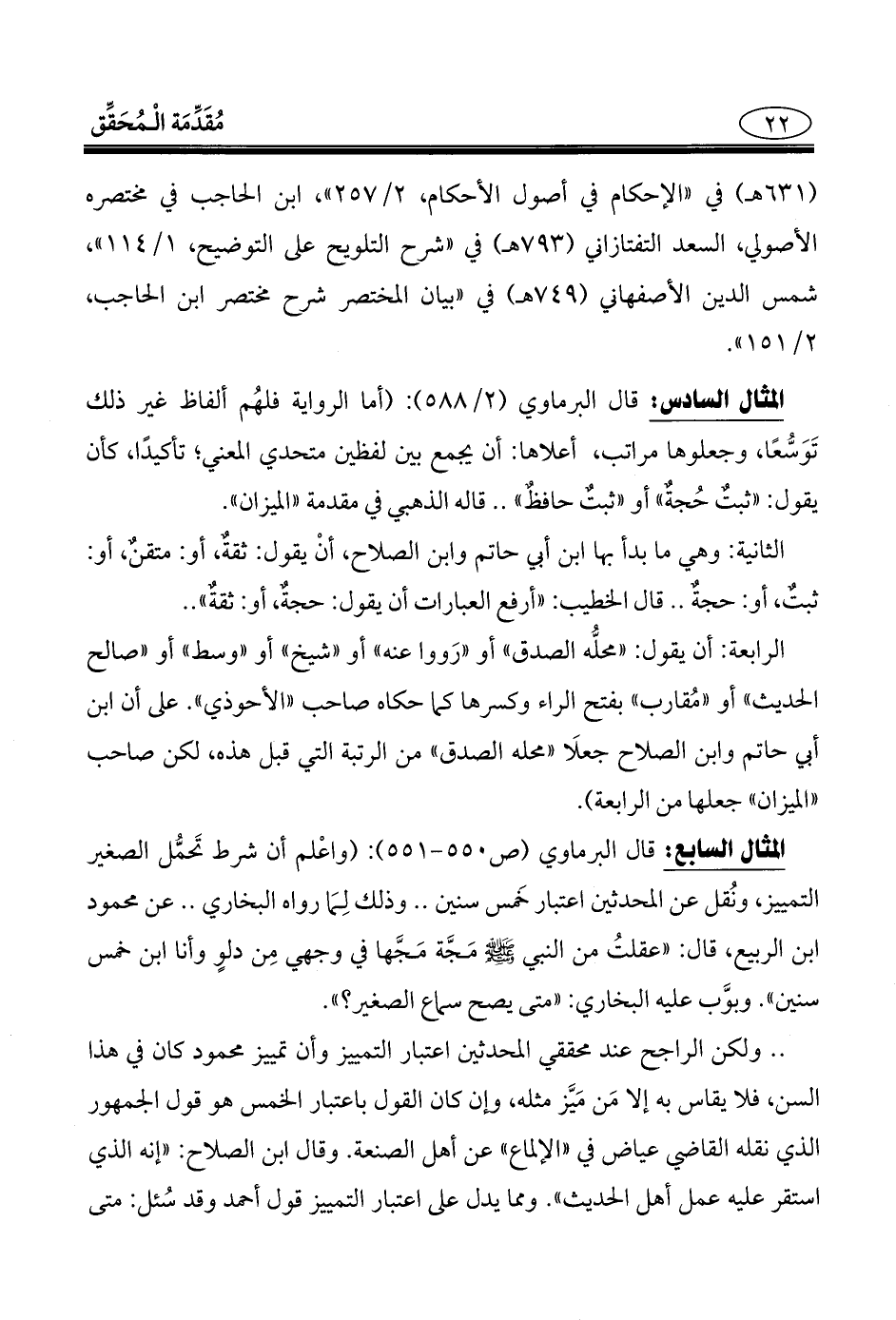
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية
في "الإحكام في أصول الأحكام، 2/ 257"، ابن الحاجب في مختصره الأصولي، السعد التفتازاني (793 هـ) في "شرح التلويح على التوضيح، 1/ 114"، شمس الدين الأصفهاني (749 هـ) في "بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، 2/ 151".المثال السادس: قال البرماوي (2/ 588): (أما الرواية فلهُم ألفاظ غير ذلك تَوَسُّعًا، وجعلوها مراتب، أعلاها: أن يجمع بين لفظين متحدي المعني؛ تأكيدًا، كأن يقول: "ثبتٌ حُجةٌ" أو "ثبتٌ حافظٌ" .. قاله الذهبي في مقدمة "الميزان".
الثانية: وهي ما بدأ بها ابن أبي حاتم وابن الصلاح، أنْ يقول: ثقةٌ، أو: متقنٌ، أو: ثبتٌ، أو: حجةٌ .. قال الخطيب: "أرفع العبارات أن يقول: حجةٌ، أو: ثقةٌ" ..
الرابعة: أن يقول: "محلُّه الصدق" أو "رَووا عنه" أو "شيخ" أو "وسط" أو "صالح الحديث" أو "مُقارب" بفتح الراء وكسرها كما حكاه صاحب "الأحوذي". على أن ابن أبي حاتم وابن الصلاح جعلَا "محله الصدق" من الرتبة التي قبل هذه، لكن صاحب "الميزان" جعلها من الرابعة).
المثال السابع: قال البرماوي (ص 550 - 551): (واعْلم أن شرط تَحمُّل الصغير التمييز، ونُقل عن المحدثين اعتبار خَمس سنين .. وذلك لِمَا رواه البخاري .. عن محمود بن الربيع، قال: "عقلتُ من النبي - صلى الله عليه وسلم - مَجَّة مَجَّها في وجهي مِن دلوٍ وأنا ابن خمس سنين". وبوَّب عليه البخاري: "متى يصح سماع الصغير؟ ".
.. ولكن الراجح عند محققي المحدثين اعتبار التمييز وأن تمييز محمود كان في هذا السن، فلا يقاس به إلا مَن مَيَّز مثله، وإن كان القول باعتبار الخمس هو قول الجمهور الذي نقله القاضي عياض في "الإلماع" عن أهل الصنعة. وقال ابن الصلاح: "إنه الذي استقر عليه عمل أهل الحديث". ومما يدل على اعتبار التمييز قول أحمد وقد سُئل: متى
السُّنة والإجماع يكون بالتواتر و [بالآحاد] (¬1) كما سيأتي بيانه، والله أعلم.
ص:
268 - وَمَا [قَرَاهُ] (¬2) السَّبع ذُو تَوَاتُرِ ... لأَنَّهُ مِنْهُ بِقَطْعٍ سَائِرِ
269 - لَا الِاخْتِلَافُ في وُجُوهِ التَّأْدِيَه ... مِثْلُ مَقَادِيرِ [مُدُودٍ مُنْهِيَهْ] (¬3)
270 - كَذَا إمَالَةٌ وَهَمْزٌ سَهَّلُوا ... أَوْ حَقَّقُوا، وَوَصْفُ حَرْفٍ يُسْهَلُ
271 - لَا أَصْلُ كُلٍّ؛ فَهْوَ قَدْ تَوَاترَا ... أَمَّا الشُّذُوذُ في قِرَاءَاتٍ تُرَى
الشرح:
أي: إذا تَقرر أن القرآن يُعتبر في ثبوته التواترُ، انبنى على ذلك مسألتان: القراءات السبعة، و [القراءات] (¬4) الشاذة.
فأما الأُولى: وهي ما قرأ به الأئمة السبعة المشهورة وتواترت عنهم من القرآن فيجب أن [تكون متواترة] (¬5) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ [لكونها] (¬6) قرآنًا، ولا يكون إلا متواترًا كما سبق.
واحترزتُ بقولي: (وتواترت) عما يُحكَى عن بعضهم آحادًا، فإنَّ ذلك من الشاذ الآتي بيانه، كما لو قرأ بها غيرهم.
¬__________
(¬1) كذا في (ز). وفي (ش): الآحاد. وفي سائر النُّسخ: إلى آحاد.
(¬2) ينضبط الوزن هكذا ولا ينضبط مع: قَرَأَه.
(¬3) في (ز): المدود المنهية. وفي (ظ): ممدود منهية.
(¬4) في (ز، ظ، ش): القراءة.
(¬5) كذا في (ز).
لكن في سائر النُّسخ: يكون متواترا.
(¬6) كذا في (ز). لكن في سائر النُّسخ: لكونه.
على اللفظ المذكور في صَدر التقسيم موردًا له.
وقولي: ("فَحْوَى الْخِطَابِ") إلى آخِره - إشارة إلى أن مفهوم الموافقة نوعان: ما هو موافق بطريق الأَوْلى، وما هو موافق بطريق المساواة.
والأول يُسمى "فحوى الخطاب"، أي: معناه المفهوم على سبيل القطع، قال الجوهري: إنه بالقصر والمد (¬1). قال الزمخشري في "الأساس": "فحوى الكلام" ما تُنُسِّم فيه (¬2). مِن "الفَحَا" وهو أبزار (¬3) القِدْر.
مثاله: قوله تعالى: {فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: 23 [مفهومه النهي عن الضرب ونحوه مِن باب أَوْلى.
وقوله تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} [الزلزلة: 7]، الآية، مفهومه أن ما فوق الذرَّة مِن باب أَوْلى.
وقوله تعالى: {[وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ] (¬4) مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ} [آل عمران: 75]، فإنَّ مفهوم الأول أن ما دُون القنطار من باب أَوْلى، ومفهوم الثاني أن ما فوق الدينار من باب أولى.
وقوله تعالى: ، وفي الآية الأخرى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ} [الإسراء: 31] {مِنْ إِمْلَاقٍ} [الأنعام: 151]، فإن مفهومهما تحريم قتله بدون الإملاق وخشيته من باب أَوْلى.
¬__________
(¬1) الصحاح (6/ 2453).
(¬2) انظر: أساس البلاغة (ص 466).
(¬3) الأبزار: التوابل. (تاج العروس، 10/ 166)، (الصحاح، 2/ 589).
(¬4) في جميع النُّسخ: ومنهم.
وأعطوه حُكم الحقيقة مع أنه مجَاز.
قلتُ: وعكسُ هذا الإشكالِ من حيث [العلة] (¬1) الإشكالُ في جمع القِلة إذا اقترن بما يقتضي عمومه: كيف يقال بالعموم فيه مع أن نهايته في اللغة عشرة مع إطباق العلماء على الاستدلال بعمومه؟ نحو: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ} [الأحزاب: 35]، {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: 5]، {إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ} [الانفطار: 13]، إلى غير ذلك.
فَجُمِع بين الطريقين بأن الشارع تَصَرَّف في ذلك بالنقل، كما في الصلاة والحج والصوم، فعمم هذه الجموع بما اقترن بها وإنْ كان أصلها بغير العموم.
وجمع إمام الحرمين بأحسن من ذلك، وهو حمل كلام أهل العربية على حالة التجرد عما يقتضي العموم مِن "أل" ونحوها، وكلام الأصوليين والفقهاء على حالة الاقتران باللام ونحو ذلك.
وأقول: إنَّ هذا الإشكال في الأصل إنما يتوجه إذا قُلنا بأن الجمع إذا اقترن بما يقتضي عمومه، كانت أفراده وحدانًا، لا جموعًا.
أما إذا قُلنا: (أفراده جموع)، فَجِهَة عمومه غير نهاية أفراده، فإنَّ العموم حينئذٍ في كل عشرة عشرة أو تسعة تسعة أو باقي مراتبه.
بل والقائل بالأول جَرَّد الدلالة عن الجمعية أصلًا، وصار عنده دالًّا على الحقيقة مِن حيث هي كما سبق تقريره مطولًا، فتأمله.
¬__________
(¬1) كذا في (ص، ق)، لكن في (ش): العلية. وفي (ت، س): الغاية. وفي (ض) كأنها: (الغاية) أو (الكفاية).
الطعم ليس بِعِلة، بل هو صالح أن يكون دليلًا على ذلك ابتداءً من غير نظر إلى سبر وتقسيم.
وإنما عُمل بهذا لأنَّ الأغلب في الأحكام أن تكون مُعلَّلة بالمصالح تَفضلًا، فبطل أن يكون هذا الحكم لا عِلة له، والأوصاف المذكورة الأصلُ عَدَمُ غيرها.
وقولي: (وَكُلُّ هَذَا حُجَّةٌ لِلنَّاظِرِ والمناظِر) معناه: أن المجتهد يرجع إلى ظنه، فإذا حصل له الظن بذلك، عمل به، وكان مؤاخَذًا بما اقتضاه ظنه.
وأما المناظِر فيكفي قوله: (بحثتُ فلم أجد غير هذه الأوصاف، والأصل عدم ما سواها). فيقْبَل؛ لأنه ثقةٌ أهلٌ للنظر. فالحكم بنفي ما سوى ذلك مستنِد إلى ظن عَدَمِه، لا إلى عدم العلم بوصف آخَر.
فإنْ بَيَّن المعترِض وصفًا غير ذلك، لَزِمَ المستدِل إبطاله، ولا يَلْزم المعترض بيان صلاحيته للتعليل.
وإذا أخذ المستدِل في إبطال ما ذكره المعترِض، فهل يكون ذلك انتقالًا منه ينقطع به؟ أو لا ينقطع حتى يعجز عن إبطاله؟
الأصح الثاني؛ لأنه لم يدَّع القَطْع في الحصر، فغاية ما أبداه المعترِض مَنعْ لمقدمة مِن مقدمات المستدِل يُحتاج إلى إقامة الدليل عليها.
وقيل: ينقطع؛ لأنه كأنه ادَّعى الحصر وقد ظهر بطلانه.
وجواب ذلك: أنه لا يظهر بطلانه إلا إنْ عجز عن دَفْعِه.
قال ابن السبكي: وعندي أنه ينقطع إنْ كان ما اعترض به المعترِض مساويًا في العلة لما ذكره المستدِل في حصر الأوصاف وأَبْطلَه؛ لأنه ليس ذكر المذكور وإبطاله أَوْلى مِن ذلك المسكوت عنه المساوي له، وإنْ كان دُونه فلا انقطاع له؛ لأنَّ له أن يقول: هذا لم يكن عندي