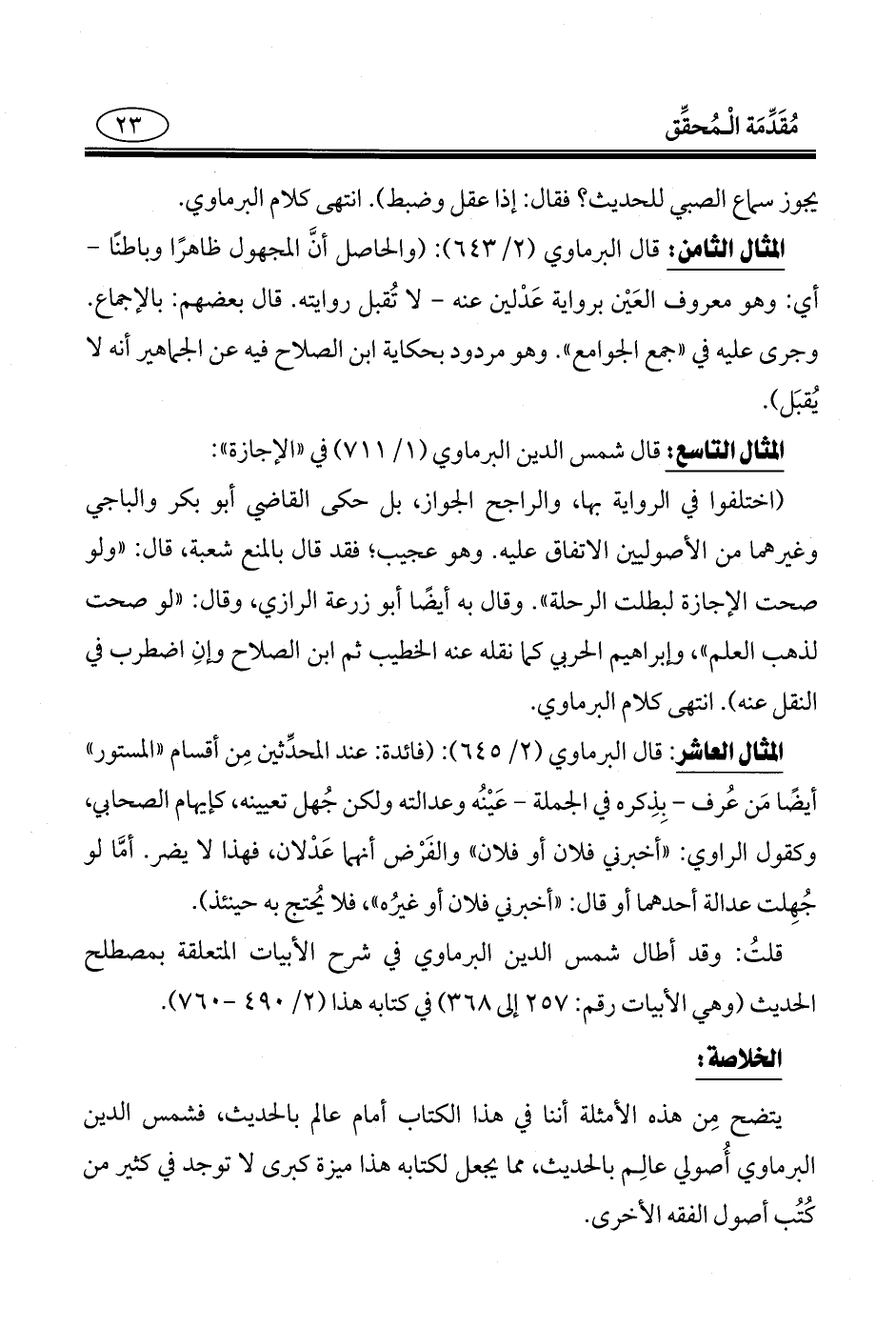
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية
يجوز سماع الصبي للحديث؟ فقال: إذا عقل وضبط). انتهى كلام البرماوي.المثال الثامن: قال البرماوي (2/ 643): (والحاصل أنَّ المجهول ظاهرًا وباطنًا - أي: وهو معروف العَيْن برواية عَدْلين عنه - لا تُقبل روايته. قال بعضهم: بالإجماع. وجرى عليه في "جمع الجوامع". وهو مردود بحكاية ابن الصلاح فيه عن الجماهير أنه لا يُقبَل).
المثال التاسع: قال شمس الدين البرماوي (1/ 711) في "الإجازة":
(اختلفوا في الرواية بها، والراجح الجواز، بل حكى القاضي أبو بكر والباجي وغيرهما من الأصوليين الاتفاق عليه. وهو عجيب؛ فقد قال بالمنع شعبة، قال: "ولو صحت الإجازة لبطلت الرحلة". وقال به أيضًا أبو زرعة الرازي، وقال: "لو صحت لذهب العلم"، وإبراهيم الحربي كما نقله عنه الخطيب ثم ابن الصلاح وإنِ اضطرب في النقل عنه). انتهى كلام البرماوي.
المثال العاشر: قال البرماوي (2/ 645): (فائدة: عند المحدِّثين مِن أقسام "المستور" أيضًا مَن عُرف - بِذِكره في الجملة - عَيْنُه وعدالته ولكن جُهل تعيينه، كإيهام الصحابي، وكقول الراوي: "أخبرني فلان أو فلان" والفَرْض أنهما عَدْلان، فهذا لا يضر. أمَّا لو جُهِلت عدالة أحدهما أو قال: "أخبرني فلان أو غيرُه"، فلا يُحتج به حينئذ).
قلتُ: وقد أطال شمس الدين البرماوي في شرح الأبيات المتعلقة بمصطلح الحديث (وهي الأبيات رقم: 257 إلى 368) في كتابه هذا (2/ 490 - 760).
الخلاصة:
يتضح مِن هذه الأمثلة أننا في هذا الكتاب أمام عالم بالحديث، فشمس الدين البرماوي أُصولي عالِم بالحديث، مما يجعل لكتابه هذا ميزة كبرى لا توجد في كثير من كُتُب أصول الفقه الأخرى.
والخلاف في تواتُر السبعة حكاه السرخسي من أصحابنا في كتاب الصوم من "الغاية"، فقال: (القراءات السبع متواترة عند الأئمة الأربعة وجميع أهل السُّنة، خلافًا للمعتزلة، فإنها آحاد عندهم). انتهى.
وممن ادَّعَى أنها آحاد أيضًا الأبياري شارح "البرهان"، قال: وأسانيدهم تشهد بذلك.
ونازع بهذا قول الإمام في "البرهان": إنها متواترة.
وقال صاحب "البديع" من الحنفية: إنها مشهورة، لا متواترة.
وفي "مختصر الروضة" للطوفي من الحنابلة: (إنها متواترة، خِلافًا لبعضهم) (¬1).
فقَوْل ابن الحاجب: (لنا: لو لم تكن متواترة لكان بعض القرآن غير متواتر، كَـ"ملك" و"مالك" ونحوهما) (¬2) إلى آخِره -[نصبٌ للدليل] (¬3) مع مخالف، خلافًا لقول بعض الشراح: إنه دليل لا على مخالف؛ لأنَّ كوْن تواتُر السبعة لا خِلاف فيه - ممنوعٌ؛ لِما بيَّناه.
وما أشار إليه شارح "البرهان" وتبعَه جمع عليه مِن أنَّ "أسانيدهم مَن تتبعها يجدها آحادًا، فيكون التواتر إنما هو مِنَّا إليهم فقط" ممنوعٌ؛ فإنها تواترت لهم وشاركهم مَن بلغ معهم حد التواتر، ولكن اشتهرت عنهم، [فلا يكون] (¬4) كل منهم منفردًا، وأسانيد القراءات تدل على ذلك.
ثم - على تقدير تسليم ما قالوه - القطعُ حاصل من حيث تَلَقِّي الأُمة لها بالقبول وتوارُد السلف والخلَف على القطعْ بها كما قال ابن الصلاح في أحاديث الصحيحين، وسيأتي بيانه
¬__________
(¬1) شرخ مختصر الروضة (2/ 21).
(¬2) مختصر المنتهى مع شرحه (1/ 462).
(¬3) كذا في (ز، ش). وفي سائر النُّسخ: نصبَ الدليل.
(¬4) كذا في (ش). لكن في (ظ، ت): لا يكون. وفي سائرها: لا بِكون.
ومن ذلك أيضًا قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92]، مفهومه وجوب الكفارة في العمد من باب أوْلى، إلَّا أنْ يُقال: ذنب المتعمِّد أعظم مِن أن يُتلافَى بالكفارة.
وكذا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن أسلف في شيء فليُسْلِف في شيءٍ معلوم ووزنٍ معلوم إلى أَجلٍ معلوم" (¬1)، فإن أصحابنا قالوا: إذا جاز في المؤجَّل، ففي الحال مِن باب أَوْلى؛ لأنه أقَل [غرورًا] (¬2) وأَبْعَد خطرًا.
وأما تضعيف تمثيل الكفارة بأنَّ العمد أشد فلا يُجبر بكفارة بخلاف الخطأ، وتضعيف تمثيل السلم بأنه ليس مِن الغَرر حتَّى يكون الحالُّ فيه كالمؤجَّل، فجوابهما:
أن الكفارة شُرعت للزجر، لا للجبر، وزجر المتعمِّد أَحَق مِن المخطئ.
وأن البيع لِما في الذمة له فوائد جُوِّز السلم لأجلها، وتلك موجودة في الحالّ كما في المؤجَّل مع كونه أَقَل خطرًا. وذلك كُله مبسوط في محله مِن الفقه.
والثاني: وهو المساوي، يُسمى "لحن الخطاب"، أي: معناه، كما قال تعالى: {وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ} [محمد: 30].
مثاله قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} [النساء: 10] ولا شك أن سائر الإتلافات كذلك في الوعيد.
وظاهر كلام ابن الحاجب أن هذا القِسم غير معتبر، وأن الأولوية شرط في الاحتجاج، حيث اقتصر في الموافقة على "فحوى الخطاب" وذكر أمثلته، ثم قال: (وهو تنبيه بالأدنى). أي: على الأعلى.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (رقم: 2125)، صحيح مسلم (رقم: 1604).
(¬2) كذا في (ص، ض، ت، ش)، لكن في (ز): غررا.
الثالث:
من فوائد الخلاف سوى ما سبق من مسألة الأصول وهي "غاية ما ينتهي إليه التخصيص" خلافًا لما يقتضيه نَقْل الأستاذ أبي إسحاق من اتفاق أئمتنا على أنَّ التخصيص يجوز إلى واحد، فلا يبقى للخلاف في هذه المسألة فائدة.
لكن سبق رد ذلك بنقل [المذاهب] (¬1) في تلك المسألة، ويترتب عليها أن الجمع نَصٌّ في أَقَلِّه، فإخراج بعضه يكون نسخًا، لا تخصيصًا. وتضم هذه المسألة إلى أن إخراج بعض العام بعد دخول وقت العمل يكون نسخًا كما سيأتي.
وسِوَى ما سبق من الفروع الفقهية:
لو قال: (له علَيَّ دراهم)، يلزمه ثلاثة، وقيل: درهمان.
وأنه يُكتفَى في الصلاة على الميت باثنين. نقله الرافعي عن "التهذيب"، وقال: (إنه بناء على أن أقَل الجمع اثنان) (¬2).
ولو أوصى لأقاربه وليس له إلا قريب واحد، فهل يصرف إليه الكل؟ أو الثلث؟ وجهان، وفي وجه ثالث حكاه الأستاذ أبو منصور: النصف.
قال في "المطلب": ولم أفهم له معنى، فإن كان بناءً على أن أقَل الجمع اثنان، فيلزمه فيما إذا أوصى للفقراء أنه يجوز الاقتصار على الاثنين، ولم نَرَ مَن قال به.
ولو قال: (إنْ تزوجتُ النساء -أو اشتريتُ العبيد- فهي طالق)، لم يحنث إلا بثلاثة. وقياس مَن يرى أن أقَل الجمع اثنان أنْ يحنث بهما.
¬__________
(¬1) كذا في (ص، ق، ش)، لكن في (س، ت، ض): أئمة المذهب.
(¬2) العزيز شرح الوجيز (2/ 442).
مخيلًا البتة، بخلاف ما ذكرتُه وأبطلته.
قلتُ: ما مِن وَصْف يأتي به المعترِض إلا والمستدِل ينازع في مساواته؛ ولهذا يَدْفَعه، فأين محل هذا التفصيل؟ !
واعلم أن الإشارة بقولي: (هَذَا) إلى القسم الثاني وهو الظني. وفي كونه حجة للناظر والمناظر ثلاثة مذاهب:
أحدها وهو الراجح: أنه حُجة لهما، لأنَّ المدار على غلبة الظن، وقد وجدت؛ فيكون حجة مطلقًا. واختاره القاضي أبو بكر، وقال: إنه [مِن] (¬1) أقوى ما تثبت به العِلل.
الثاني: ليس بحجة مطلقًا. حكاه في "البرهان" عن بعض الأصوليين.
والثالث: أنه حجة للناظر دُون المناظِر؛ لأنه يعمل بظن نفسه، وأما كون ظنه حُجة على غيره فلا.
واختار إمام الحرمين قولًا رابعًا: أنه حُجة بشرط قيام الإجماع على أن حكم الأصل معلَّل في الجملة؛ لأنه لو كان ما ذكر مِن الأوصاف لا عِلية لواحد منها والأصل عدم غيرها، لَعَادَ ذلك إلى تخطئة الإجماع في أنه مُعلَّل.
قيل له: فالقائسون بعض الأُمة.
فقال: منكر القياس لا يُعَد مِن علماء الأُمة الذين يؤثر خلافهم.
تنبيه:
يكفي في حصر الأوصاف اتفاق الخصمين بالنسبة إلى نفي ما عداها، وأما إذا اتفقا مثلًا على أن الحكم معلَّل وأن العلة فيه أحد المعنيين، واختار المستدِلُّ واحدة والمعترِضُ أخرى،
¬__________
(¬1) من (ش، ض).