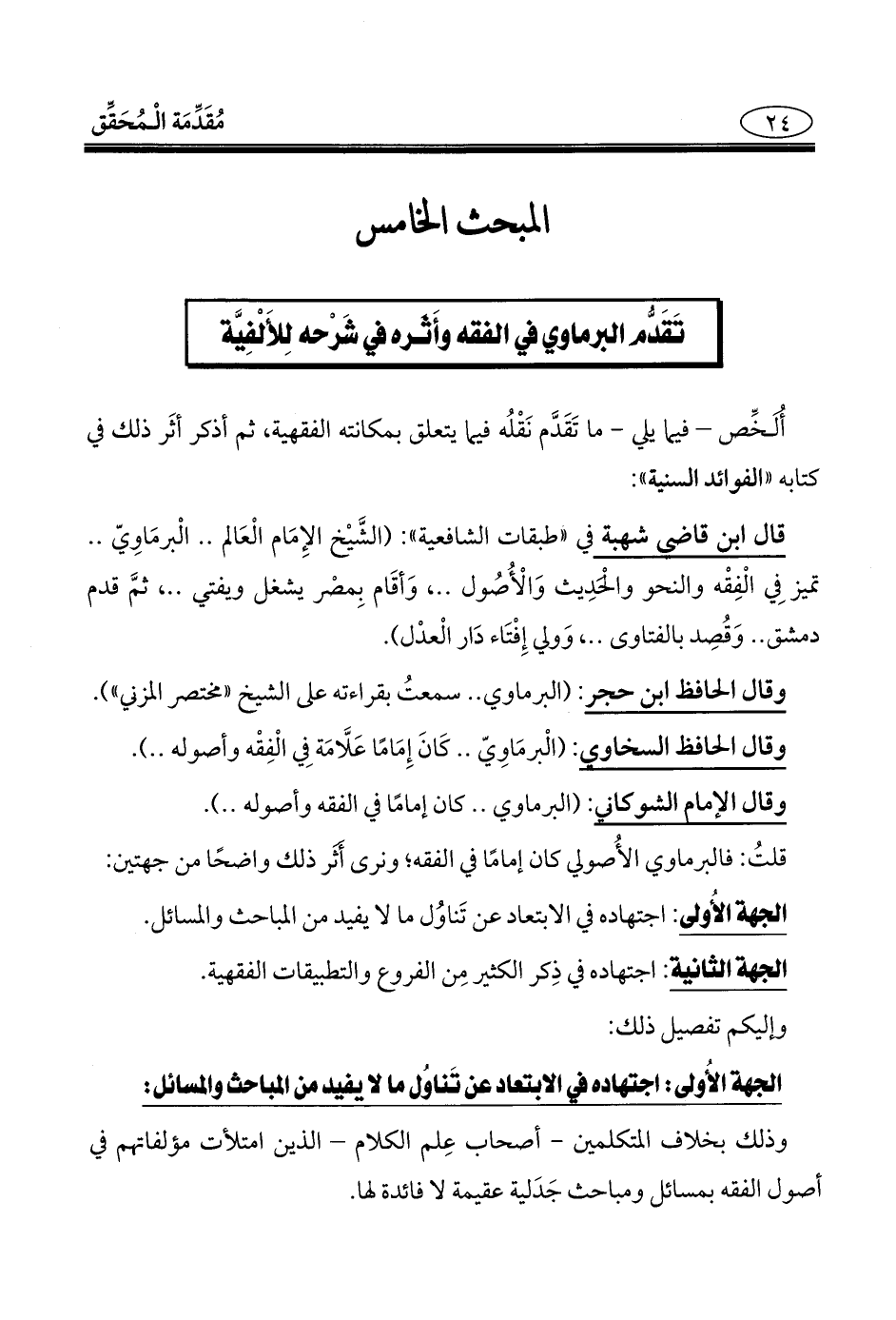
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية
المبحث الخامس: تَقَدُّم البرماوي في الفقه وأَثَره في شَرْحه لِلأَلْفِيَّةأُلَخِّص - فيما يلي - ما تَقَدَّم نَقْلُه فيما يتعلق بمكانته الفقهية، ثم أذكر أثَر ذلك في كتابه "الفوائد السنية":
قال ابن قاضي شهبة في "طبقات الشافعية": (الشَّيْخ الإِمَام الْعَالم .. الْبرمَاوِيّ .. تميز فِي الْفِقْه والنحو والْحَدِيث وَالْأُصُول .. ، وَأقَام بِمصْر يشغل ويفتي .. ، ثمَّ قدم دمشق .. وَقُصِد بالفتاوى .. ، وَولي إِفْتَاء دَار الْعدْل).
وقال الحافظ ابن حجر: (البرماوي .. سمعتُ بقراءته على الشيخ "مختصر المزني").
وقال الحافظ السخاوي: (الْبرمَاوِيّ .. كَانَ إِمَامًا عَلَّامَة فِي الْفِقْه وأصوله .. ).
وقال الإمام الشوكاني: (البرماوي .. كان إمامًا في الفقه وأصوله .. ).
قلتُ: فالبرماوي الأُصولي كان إمامًا في الفقه؛ ونرى أَثَر ذلك واضحًا من جهتين:
الجهة الأُولى: اجتهاده في الابتعاد عن تَناوُل ما لا يفيد من المباحث والمسائل.
الجهة الثانية: اجتهاده في ذِكر الكثير مِن الفروع والتطبيقات الفقهية.
وإليكم تفصيل ذلك:
الجهة الأُولى: اجتهاده في الابتعاد عن تَناوُل ما لا يفيد من المباحث والمسائل:
وذلك بخلاف المتكلمين - أصحاب عِلم الكلام - الذين امتلأت مؤلفاتهم في أصول الفقه بمسائل ومباحث جَدَلية عقيمة لا فائدة لها.
وما قيل فيه من النظر.
وما أحسنَ قول الإمام كمال الدين ابن الزملكاني: انحصار الأسانيد في طائفة لا يمنع مجيء القراءات عن غيرهم؛ فقد كان يتلقاه من أهل كل بلد بقراءة إمامهم الجمُّ الغفير عن مثلهم، وكذلك دائماً. فالتواتر حاصل لهم، ولكن الأئمة الذين قصدوا ضبط الحروف وحفظوا شيوخهم [فيها] (¬1) جاء السند من جهتهم، وهذا كالأخبار الواردة في حجة الوداع، هي آحاد ولم تزل حجة الوداع منقولة عمن يحصُل بهم التواتُر عن مثلهم في كل عصر. فينبغي أن يتفطن لذلك وأنْ لا يُغتر بقول القراء فيه.
وأشرتُ إلى ذلك في النَّظم بقولي: (لأَنَّهُ مِنْهُ بِقَطْعٍ سَائِرِ). أي: لأن ما قرأه السبعة من [القراءات] (¬2) كما هو مقطوع به في كل عصر ومصر فهو سائر في الأعصار والأمصار.
وقولي: (لَا الِاخْتِلَافُ) إلى آخِره - بيانٌ لِأنَّ ما أَطْلقه الجمهور مِن تواتُر السبعة ليس على إطلاقهم، بل يُستثنى منه - كما قال ابن الحاجب - ما كان من قبيل الأداء، كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة ونحوه. ومراده بالتمثيل بِـ"المد والإمالة" مقادير المد وكيفية الإمالة، لا أصل المد والإمالة؛ فإنه متواتر قطعًا.
فالمقادير كَمَدِّ حمزة وورش بقَدْر ست ألِفات، وقيل: خَمس. وقيل: أربع. ورجحوه، وعاصم بقدر ثلاث، والكسائي بقدر ألِفين ونصف، وقالون بقدر ألِفين، والسُّوسي بقدر ألِف ونصف، ونحو ذلك. وكذلك الإمالة تنقسم إلى:
- محضة، وهي أن ينحى بالألِف إلى الياء، وبالفتحة إلى الكسرة.
- وبَيْن بَيْن، وهي كذلك إلا أنها تكون إلى الألف أو الفتحة أقرب، وهي المختارة عند
¬__________
(¬1) في (ش): منها.
(¬2) كذا في (ص)، لكن في (ت، ز، ق): القرآن.
قال: (ويُعرف ذلك بمعرفة المعنى وأنه أَشد مناسبة [في] (¬1) المسكوت) (¬2).
نعم، قوله في صَدْر المسألة: (أنْ يكون المسكوت موافقًا في الحكم) دليل على عدم الفرق بين الأَوْلى والمساوي. وكذا قوله في مفهوم المخالفة: (وشرطه أنْ لا يظهر أَوْلَوية ولا مساواة) (¬3).
على أنَّ اشتراط الأولوية هو ظاهر كلام الشَّافعي في "الرسالة" كما نقله إمام الحرمين في "البرهان"، وبه قال الشيخ أَبو إسحاق وغيره من أئمتنا، ونقله الهندي عن الأكثرين.
والقول بأنه لا يشترط هو طريقة الغزالي والإمام الرازي وأتباعه، وهو ظاهر استدلالات الأئمة بالمساوي كالأَوْلى وإنْ خَصَّصوا بالتسمية الأَوْلَوي.
أمَّا تسمية الأَوْلَوي بِـ "فحوى الخطاب" والمساوي بِ "لحن الخطاب" فَعَلَيْه قوم من أصحابنا، وبعضهم يُسمي الأَوْلوي بالاثنين معًا.
وحكى الماوردي (¬4) في الفرق بينهما وجهين:
أحدهما: ما سبق.
والثاني: أن "الفحوى" ما نَبَّه عليه اللفظ، و"اللحن" ما لاح في أثناء اللفظ.
وقال القفال في "فتاويه": "الفَحْوَى" ما دَلَّ المُظْهَر على المُسْقَط، و"اللحن" ما يكون محالًا على غير المراد في الأصل والوضع، و"المفهوم" ما يكون المراد به المُظهَر والمُسْقَط.
وقيل غير ذلك، والخلاف في الاصطلال، ولا مشاححة فيه.
¬__________
(¬1) في (ز، ظ): من.
(¬2) مختصر المنتهى (2/ 439) مع (بيان المختصر).
(¬3) مختصر المنتهى (2/ 440).
(¬4) الحاوي الكبير (16/ 153).
فإنْ قيل: هلَّا جُعل ذلك تعليقًا على مستحيل حتى لا يحنث؛ لأن (اللام) للعموم؛ [فيقتضي] (¬1) نساء أو عبيد العالم؟
قيل: لأن إعمال الكلام أَولى من إهماله؛ فيُحمل على الجنس، كما لو حلف لا يُكلم الناس، فإنه يحنث بواحد كما قاله ابن الصباغ وغيره. فلو قال: (ناسًا) بالتنكير، حنث بواحد؛ لأجل دلالة العموم. لكن هذا إذا قُلنا: أفراده وحدان، لا جموع. أمَّا إذا قُلنا: جموع، فينبغي أن لا يحنث إلا بثلاثة.
وشبَّه ابن الصباغ الأول -وهو ما اقترن بمقتضِي العموم- بما لو قال: (لا آكُل الخبز).
وفيه نظر؛ لِصِدْق ذلك على القليل والكثير، كَـ"الماء" و"العسل"، فلا يُشبَّه به ما يدل على الجمعية.
وفروع الفقه على هذه المسألة لا تنحصر، وفي هذه الإشارة كفاية.
قولي: (مَا لَمْ يَكُنْ لِكَثْرَةٍ فَزَائِدُ عَشَرَةٍ) أي: أقَل الجمع ثلاثة ما لم يكن من جموع الكثرة، فإن أقَله الزائد على العشرة، وهو أحد عشر.
وقولي: (مَا لَمْ يَنُبْ) تخصيص لقاعدة جمع الكثرة: أنه إذا ناب باستغنائه أو غيره، فإنه يصير كجمع القِلة حتى يكون أَقَله فيه الخلاف، والأرجح ثلاثة.
وقد أوضحنا ذلك. والله أعلم.
¬__________
(¬1) كذا في (ق، س)، لكن في (ص): تقتضي.
فقال المستدِلُ: لِعِلَّتي مرجِّح، وهو كذا، فهل يكفي ذلك؟
قال القاضي أبو الطيب في مناظرته مع أبي [الحسين] (¬1) القُدُوري: لا يكفي؛ فإن اتفاقهما ليس اتفاق الأُمة؛ فلا يكون حجة. وقال القدوري: يكفي لقطع المنازعة.
وأما إبطال بعض الأوصاف فله طُرق:
أحدها: أن يدل دليل شرعي على إلغائه كما سبق.
ثانيها: بيان كون الوصف طرديًّا مِن جنس ما عُلِم مِن الشرع إلغاؤه:
- إما مطلقًا، كالطول والقصر بالنسبة لوجوب القصاص أو الكفارة أو العتق أو الإرث أو التقديم في الصلاة أو نحو ذلك.
- أو لا مُطلقًا، بل بالنسبة لذلك الحكم فقط، كالذكورة في العتق مع أنها معتبرة في غيره كالشهادة والقضاء وولاية النكاح والإرث، فلا يُعَلَّل بها شيء من أحكام العتق.
نعم، في الثواب والجزاء في الآخرة قد يكون ذلك، فقد روى الترمذي: "مَن أعتق عبدًا مُسلِمًا أعتقه الله مِن النار، وَمن أعتق أَمَتين مُسْلمتين أعتقه الله من النار" (¬2).
ثالثها: أن لا تظهر مناسبة في وصف؛ فيكفي ذلك في إلغائه، ويكفي قول المستدل: بحثتُ، فلم أجد له مناسبة للحكم.
فإنْ قال المعترِض مِثله في الوصف [المنفي] (¬3) أنه بحث فلم يجد له مناسبة، تَعارضَا،
¬__________
(¬1) كذا في (ت)، لكن في (ص): الحسن.
(¬2) بنحوه في: مسند أحمد (18088)، سنن الترمذي (1547)، سنن ابن ماجه (2522) وغيرها، ولفظ ابن ماجه: (مَن أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا، كان فكَاكَهُ من النَارِ ... ومَن أَعْتَقَ امْرَأتيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ، كَانَتَا فكَاكَهُ من النَّارِ). قال الألباني: صحيح. (صحيح الترمذي: 1547).
(¬3) كذا في جميع النُّسخ. ولَعَله: المتبقي. وفي (البحر المحيط، 4/ 205): (الوصف المستبقَى).