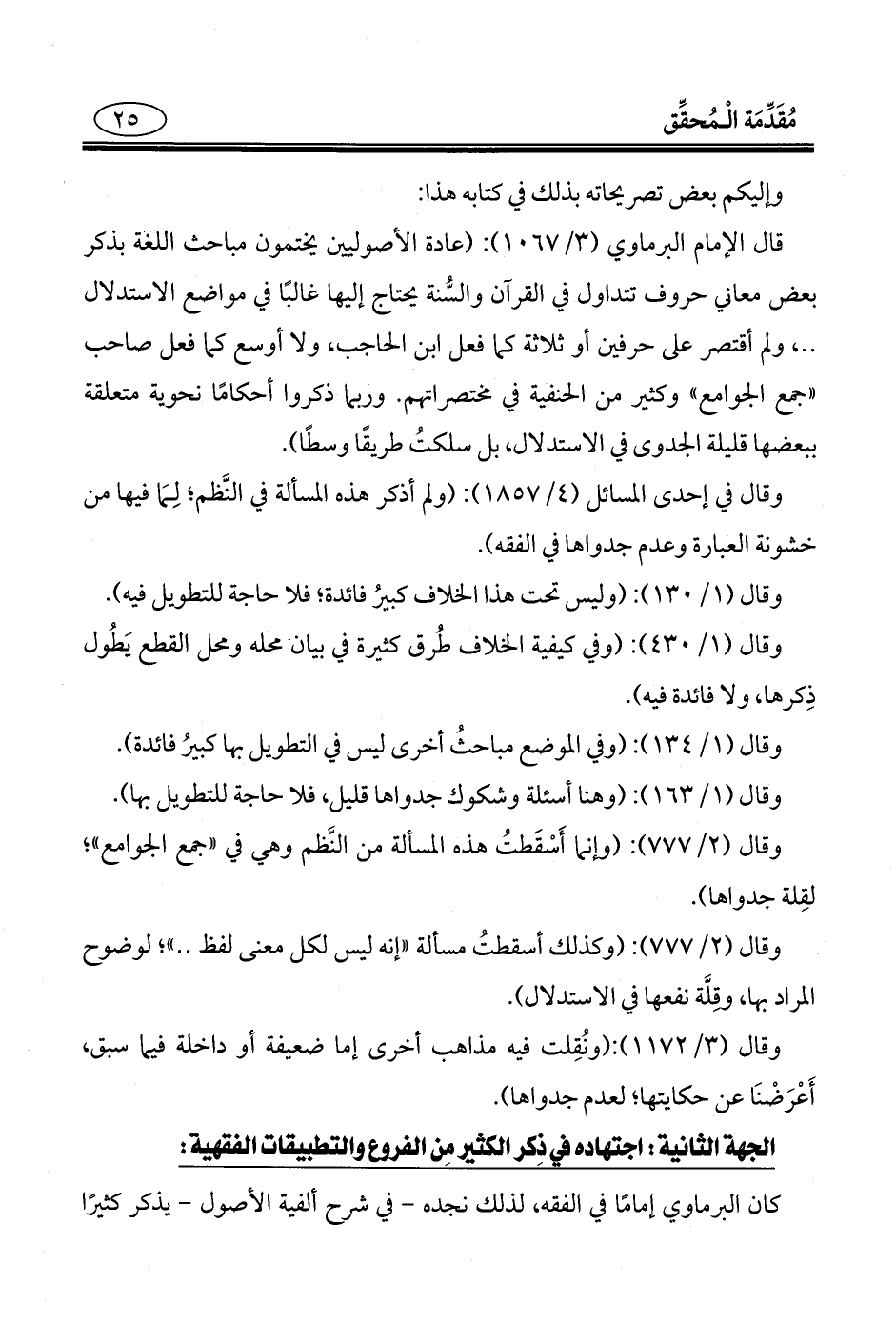
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية
وإليكم بعض تصريحاته بذلك في كتابه هذا:قال الإمام البرماوي (3/ 1067): (عادة الأصوليين يختمون مباحث اللغة بذكر بعض معاني حروف تتداول في القرآن والسُّنة يحتاج إليها غالبًا في مواضع الاستدلال .. ، ولم أقتصر على حرفين أو ثلاثة كما فعل ابن الحاجب، ولا أوسع كما فعل صاحب "جمع الجوامع" وكثير من الحنفية في مختصراتهم. وربما ذكروا أحكامًا نحوية متعلقة ببعضها قليلة الجدوى في الاستدلال، بل سلكتُ طريقًا وسطًا).
وقال في إحدى المسائل (4/ 1857): (ولم أذكر هذه المسألة في النَّظم؛ لِمَا فيها من خشونة العبارة وعدم جدواها في الفقه).
وقال (1/ 130): (وليس تحت هذا الخلاف كبيرُ فائدة؛ فلا حاجة للتطويل فيه).
وقال (1/ 430): (وفي كيفية الخلاف طُرق كثيرة في بيان محله ومحل القطع يَطُول ذِكرها، ولا فائدة فيه).
وقال (1/ 134): (وفي الموضع مباحثُ أخرى ليس في التطويل بها كبيرُ فائدة).
وقال (1/ 163): (وهنا أسئلة وشكوك جدواها قليل، فلا حاجة للتطويل بها).
وقال (2/ 777): (وإنما أَسْقَطتُ هذه المسألة من النَّظم وهي في "جمع الجوامع"؛ لقِلة جدواها).
وقال (2/ 777): (وكذلك أسقطتُ مسألة "إنه ليس لكل معنى لفظ .. "؛ لوضوح المراد بها، وقِلَّة نفعها في الاستدلال).
وقال (3/ 1172): (ونُقِلت فيه مذاهب أخرى إما ضعيفة أو داخلة فيما سبق، أَعْرَضْنَا عن حكايتها؛ لعدم جدواها).
الجهة الثانية: اجتهاده في ذِكر الكثير مِن الفروع والتطبيقات الفقهية:
كان البرماوي إمامًا في الفقه، لذلك نجده - في شرح ألفية الأصول - يذكر كثيرًا
الأئمة.
أما أصلُ الإمالة فمتواترة قطعًا.
وكذلك التخفيف في الهمز والتشديد فيه، منهم مَن يسهله، ومنهم مَن يبدله، ونحو ذلك.
فهذه الكيفية هي التي ليست متواترة؛ ولهذا كره الإمام أحمد - رضي الله عنه - قراءة حمزة؛ لِما فيها من طول المد والكسر والإدغام ونحو ذلك، وكذا قراءة الكسائي؛ لأنها كقراءة حمزة في الإمالة والإدغام كما نقل ذلك السرخسي في "الغاية". فلو كان ذلك متواترًا لَمَا كرهه الإمام أحمد؛ لأن الأُمة إذا كانت مجمعة على شيء، فكيف يكره؟ !
وقولي: (وَوَصْفُ حَرْفٍ يُسْهَلُ) هو مما زاده أبو شامة - في المستثنى - على ما ذكره ابن الحاجب في استثنائه، وهي الألفاظ المختلَف فيها بين القراء، أيْ: ألفاظ اختلف القراء في وجه تأديتها، كالحرف المشدد يبالغ بعضهم فيه حتى كأنه يزيد حرفًا، وبعضهم لا يرى ذلك، وبعضهم يرى التوسط بين الأمرين.
وهو معنى قولي: (وَوَصْفُ حَرْفٍ يُسْهَلُ). وهو بضم أوله مِن "أسهل" الرباعي بمعنى "سهَّل" المشدد. أي: يختلف في وجه تسهيله. وهذا الذي قاله [ظاهر، و] (¬1) يمكن دخوله تحت قول ابن الحاجب في الاحتراز عنه: (فيما ليس من قبيل الأداء). على أن بعضهم قد نازع أبا شامة بما لا تحقيق فيه، والله أعلم.
وقولي: (أَمَّا الشُّذُوذُ في قِرَاءَاتٍ ترى) تمامه قولي بعده في جواب "أما":
¬__________
(¬1) ليس في (ز).
وقولي: (وَالشَّافِعِيُّ قَدْ رَأَى "الْمُوَافَقَهْ") إلى آخِره - بيان لمدْرَك الاستدلال في مثل صورة الفحوى المذكورة على المسكوت بحكم المذكور هل هو بطريق المفهوم السابق بيانه؛ أو بطريق آخَر؟ وإذا قلنا بطريق آخَر، فما هي؟
وحاصل ما فيه ثلاثة أقوال، مع الأول تصير أربعة:
الأول منها: بالمفهوم، وهو المشهور، وجرى عليه ابن الحاجب والبيضاوي تَبعًا لأصلهما؛ فلذلك ذكرناه في أصل التقسيم، ونقله سليم في "التقريب" عن المتكلمين بأَسْرهم الأشعرية والمعتزلة، وسمَّاه الحنفية "دلالة النَّص".
الأول: أنَّه من باب القياس، قِيسَ المسكوت على المذكور قياسًا جَلِيًّا كما سماه الشَّافعي بذلك، فإنه يشترط في القياس الجِلي كَوْن الحكم في المقِيس أَوْلَى مِن المقيس عليه. وقد حكى الشَّافعي القولين في "الأُم" هل دلالة النص في ذلك لفظية؟ أو قياسية؟
وبالثاني صَدَّر كلامه في "الرسالة" وأوضحَه بالأمثلة، ثم قال: ومنع بعض أهل العلم أن يُسمى قياسًا؛ لأنه معلوم مِن النَّص.
وهو ما نقله الرافعي أيضًا في "باب القضاء" عن الأكثرين، وكذا الهندي في "النهاية". وعبارة الصيرفي: ذهب طائفة جِلَّة إليه، سيدهم الشَّافعي.
وقال الشيخ في "اللمع" (¬1): إنه الصحيح. وجَرَى عليه القفال الشاشي.
الثالث: أن اللفظ الدال على الأَخَص نُقل عُرْفًا إلى الأَعَم، فنُقِل: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} إلى معنى "ولا تؤذهما".
الرِّابِع: أنَّه أُطْلِق على الأَعَم إطلاقًا مجازيًّا، مِن باب إطلاق الأخص على الأعم، ولم
¬__________
(¬1) اللمع في أصول الفقه (ص 44).
ص:
616 - وَإنْ يُخَصُّ اللَّفْظُ ذُو الْعُمُومِ ... يُرَدْ عُمُومُهُ لَدَى التَّفْهِيمِ
617 - تَنَاوُلًا لَا حُكْمًا، الَّا أَنَّهُ ... حَقِيقَةٌ فِيمَا بَقِيْ، وَحُكْمُهُ
618 - بَاقٍ إذَا يَكُونُ بِالْمُعَيَّنِ ... خُصَّ وَلَوْ مُنْفَصِلًا مِنْهُ عُنِي
619 - أَوْ لَمْ يَكُنْ عُمُومُهُ قَدْ أَنْبَأَ ... عَنْهُ، وَأَمَّا إنْ يَكُنْ قَدْ [بُدِئَ] (¬1)
620 - بِقَصْدِ أَنْ يَكُونَ لِلْخُصُوصِ ... فَذَا مُجَرَّدٌ عَنِ التَّخْصِيصِ
621 - وَهْوَ مَجَازٌ نَوْعُهُ كُلِّيُّ ... أُطْلِقَ لِلَّذِي هُوَ الْجُزْئِيُّ
الشرح: اشتملت هذه الأبيات على أربع مسائل من مباحث تخصيص العموم.
الأُولى: أن تخصيص العام هل هو إخراج من حُكمِه والعمومُ في اللفظ باقٍ؟ أو مِن اللفظِ؟
الثانية: وهي مُفرَّعة على الأُولى، الفرق بين العام المخصوص والعام المراد به خاص.
الثالثة: أن العام بعد التخصيص دلالته على ما بقي حقيقة؟ أَم مجاز؟ وهل يَطَّرِد ذلك في العام المراد به خاص؟ أو لا؟
الرابعة: الحكم على العام إذا خُص هل هو باقٍ في الأفراد بعد التخصيص فيكون حُجة فيها؟ أو لا؟
فأما المسألة الأولى:
وهي كون الإخراج في التخصيص مِن الحكم لا من اللفظ؛ فلأن مقصود الشرع بيان
¬__________
(¬1) في (ت، س، ض): ندبا.
وليس للمستدِل بيان مناسبته؛ لأنه انتقال في الاستدلال على العِلية مِن السبر إلى المناسبة. إنما طريقه أن يأتي بمرجِّح لِسَبْرِه على سَبْر المعترِض، كأنْ يُبيِّن أنَّ سبره موافِق لتعدية الحكم، وسَبْر المعترض قاصر. وهو مبني على المختار في ترجيح المتعدية على القاصرة. والله أعلم.
كل:
813 - وَالْخَامِسُ: الْمَعْرُوفُ بِـ "الْمُنَاسَبَهْ" ... بِأَنْ يَكُونَ الْوَصْفُ ذَا مُنَاسبَهْ
814 - مُلَائِمًا فِعْلَ ذَوِي الْعُقُولِ ... عَلَى الَّذِي يُذْكَرُ في التَّفْصِيلِ
815 - وَبِـ "إخَالَةٍ" يُسَمَّى، وَكَذَا ... ذَلِكَ الِاسْتِخْرَاجُ "تَخْرِيجًا" إذَا
816 - تُضِيفُهُ إلَى "الْمَنَاطِ"، وَهْوَ أَنْ ... يُعَيَّنَ الْوَصْفُ لِتَعْلِيلٍ إذَنْ
817 - مَعْ كَوْنِ الَاصْلِ نَفْيَ مَا سِوَاهُ ... بِشَرْطِ الِاقْتِرَانِ إذْ يَغْشَاهُ
818 - كَذَا خُلُوّهُ عَنِ الْقَوَادِحِ ... إنْ لَمْ يُجبْ عَنْهَا بِرَدٍّ صَالِحِ
الشرح:
الخامس مِن الطرق الدالة على العلية: "المناسبة"، ويقال له: "الإخالة" وهو أن يكون الأصل مشتملًا على وصف مناسب للحكم، فيحكم العقل -بوجود تلك المناسبة- أنَّ ذلك الوصف هو عِلة الحكم.
والمراد بالمناسبة في قولي: (ذَا مُنَاسَبَهْ) المناسبة اللغوية، بخلاف المعَرِّف وهو المناسبة فإنها بالمعنى الاصطلاحي؛ حتى لا يكون تعريفًا للشيء بنفسه.
فحينئذٍ الوصف المناسب الأَرْجَح في تعريفه ما أشرتُ إليه بقولي: (مُلَائِمًا) بالنصب إما "خبرًا" بعد خبرل "كان"، أو "بدلًا" من خبر "كان" وهو: "ذَا مُنَاسَبَهْ".
فيقال على هذا التعريف: "المناسب" هو المُلائِم لأفعال العُقَلاء، وهذه الملائَمة تُدْرَك