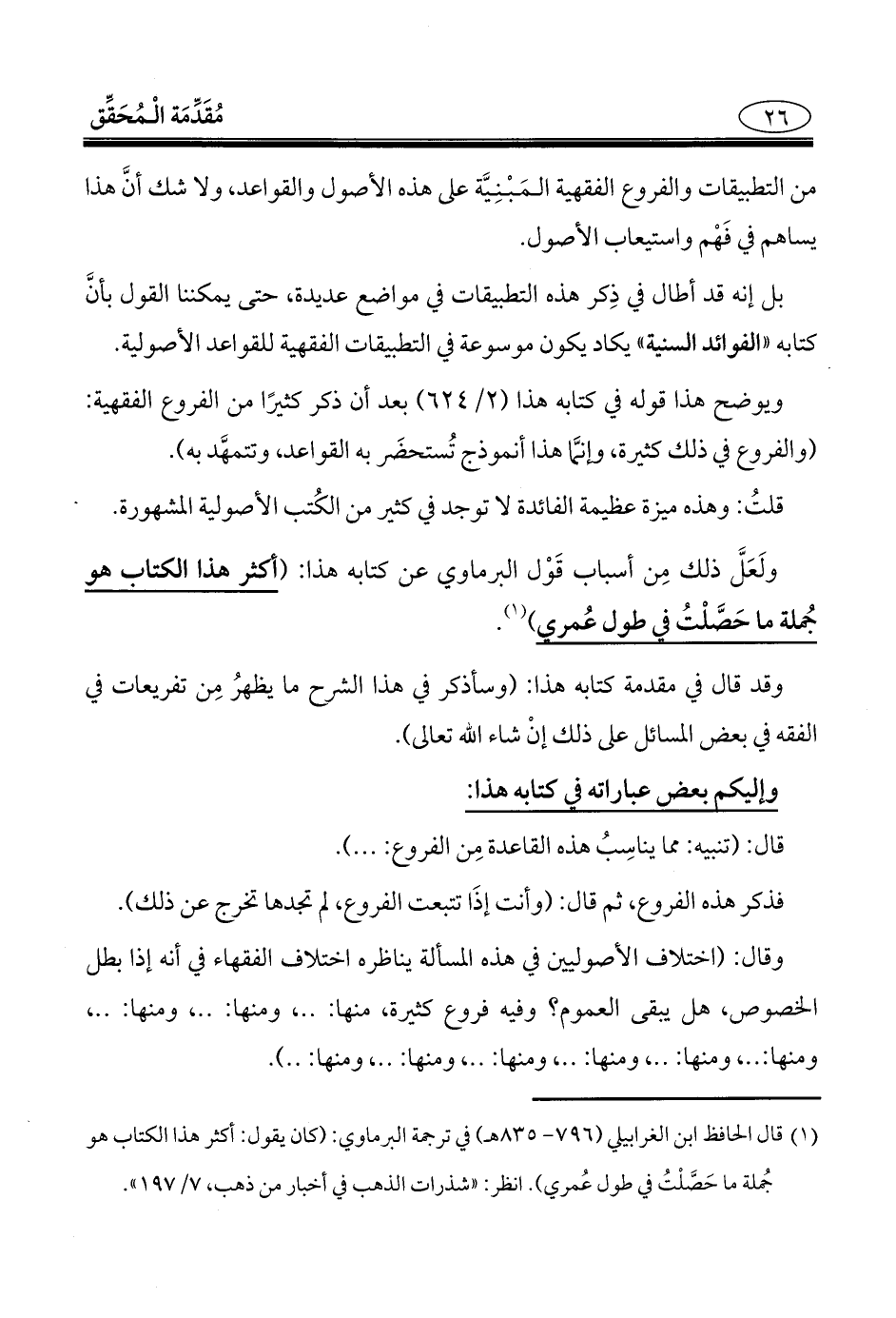
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية
من التطبيقات والفروع الفقهية المَبْنِيَّة على هذه الأصول والقواعد، ولا شك أنَّ هذا يساهم في فَهْم واستيعاب الأصول.بل إنه قد أطال في ذِكر هذه التطبيقات في مواضع عديدة، حتى يمكننا القول بأنَّ كتابه "الفوائد السنية" يكاد يكون موسوعة في التطبيقات الفقهية للقواعد الأصولية.
ويوضح هذا قوله في كتابه هذا (2/ 624) بعد أن ذكر كثيرًا من الفروع الفقهية: (والفروع في ذلك كثيرة، وإنمَّا هذا أنموذج تُستحضَر به القواعد، وتتمهَّد به).
قلتُ: وهذه ميزة عظيمة الفائدة لا توجد في كثير من الكُتب الأصولية المشهورة.
ولَعَلَّ ذلك مِن أسباب قَوْل البرماوي عن كتابه هذا: (أكثر هذا الكتاب هو جُملة ما حَصَّلْتُ في طول عُمري) (¬1).
وقد قال في مقدمة كتابه هذا: (وسأذكر في هذا الشرح ما يظهرُ مِن تفريعات في الفقه في بعض المسائل على ذلك إنْ شاء الله تعالى).
وإليكم بعض عباراته في كتابه هذا:
قال: (تنبيه: مما يناسِبُ هذه القاعدة مِن الفروع: ... ).
فذكر هذه الفروع، ثم قال: (وأنت إذَا تتبعت الفروع، لم تجدها تخرج عن ذلك).
وقال: (اختلاف الأصوليين في هذه المسألة يناظره اختلاف الفقهاء في أنه إذا بطل الخصوص، هل يبقى العموم؟ وفيه فروع كثيرة، منها: .. ، ومنها: .. ، ومنها: .. ، ومنها: .. ، ومنها: .. ، ومنها: .. ، ومنها: .. ، ومنها: .. ، ومنها: .. ).
¬__________
(¬1) قال الحافظ ابن الغرابيلي (796 - 835 هـ) في ترجمة البرماوي: (كان يقول: أكثر هذا الكتاب هو جُملة ما حَصَّلْتُ في طول عُمري). انظر: "شذرات الذهب في أخبار من ذهب، 7/ 197".
ص:
272 - فَلَيْسَ قُرْآنًا؛ [لِذَا] (¬1) لَا يُقْرَأُ ... بِهِ، وَذَاكَ بَعْدَ سَبْعٍ تُقْرَأُ
273 - وَاخْتَارَ جَمْعٌ مَا رَآهُ الْبَغَوِي ... مِنْ أَنَّهُ وَرَاءَ عَشْرٍ مُنْحَوِى
274 - نَعَمْ، يَكُونُ حُجَّةً إنْ ثَبَتَا ... نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ مُثْبِتَا
الشرح:
أيْ: إذا عُلم أن القرآن لا يكون إلا متواترًا، نشأ منه أن القراءات الشاذة ليست قرآنًا؛ لأنها آحاد، وحينئذ فلا يجوز القراءة بها، قال ابن عبد البر: إجماعًا. وقال النووي في "شرح المهذب": لا في الصلاة ولا في غيرها. وكذا قاله في فتاويه، قال: فإنْ قرأ بها في الصلاة وغيَّرت المعنى، بطلت صلاته إن كان عامدًا عالمًا.
وكذا قال أبو الحسن السخاوي: لا تجوز القراءة بها؛ لخروجها عن إجماع المسلمين وعن الوجه الذي يثبت به القرآن وهو التواتُر وإن كان موافقًا للعربية وخط المصحف.
ونقل الشاشي في "المستظهري" عن القاضي الحسين أن الصلاة بالقراءة الشاذة لا تصح.
نعم، نازع الشيخ أبو حيان وجَمعٌ في جواز القراءة بها، وليس مخالَفةً لِمَا نُقل مِن الإجماع؛ لأنهم بنوه على تفسير هم "الشاذ"، وسيأتي، فإنما أجازوا فيما ليس بِشَاذ على رأيهم.
وعضد أبو حيان ذلك بأن المسلمين لم يزالوا يُصلون خلف أصحاب هذه القراءات، كالحسن البصري ويعقوب وطلحة بن مُصَرّف وابن مُحَيْصن والأعمش وأضرابهم، ولم ينكر ذلك أحد.
¬__________
(¬1) في (ز، ت، ش، ن 2، ن 5): لذا. لكن في سائر النُّسَخ: كذا.
يَبْلُغ في الاشتهار أن يصير حقيقة عُرفية، وإنَّما دل على إرادة الجاز فيه السِّيَاق والقرائن. وقال به كثير من المحققين، كالغزالي في موضع وإنْ كان في موضع آخَر أطلق أن النَّص دل عليه بالفحوى، كأنه جرى هنا على المشهور وحقق هناك. وكذا ابن القشيري، وهو ظاهر اختيار ابن الحاجب [حيث] (¬1) ضَعَّف طريقة القول بأنه قياس بأمور قد سبقه بها الآمدي وغيره ووَهَّاها المحققون، ليس ذلك موضع ذِكرها.
نعم، زعم قوم - كابن السمعاني - أن الشَّافعي لم يُرد حقيقة القياس، بل شبهه.
والحقُّ أن له جهتين: جهة هو بها قياسٌ حقيقةً، وجِهة هو بها مُستنِد إلى اللفظ، ولا امتناع أن يكون للشيء اعتباران، فلذلك أَجمع على القول به مُثْبِتُو القياس ومُنكروه، كُلٌّ نَظَر إلى جهة.
وقد قال ابن سريج لأبي بكر بن داود: ما تقول فيمَن يعمل مثقال ذَرَّتين؟ فقال: الذرتان ذَرة وذَرة. فقال ابن سريج: فلو عمل مثقال ذَرة ويصف؟
قال إمام الحرمين: (فتبلَّد وظهر حزنه) (¬2). أي: لأن بإنكاره القياس لا يجري القياس في نِصف [ذَرة] (¬3)، لعدم شمول اللفظ لها.
ومن هنا يُعْلَم وَجْه آخَر في اجتماع النَّقْلَين عن الغزالي.
قولي: (لَا بِلَفْظٍ وَافَقَهْ) إلى آخِره - تعريض بالمذاهب الثلاثة المذكورة في المسألة على خِلاف المرجَّح الذي هو نَص الشَّافعي وإنْ كنتُ قد جزمتُ بالأول منها، لضرورة التقسيم
¬__________
(¬1) في (ز، ظ): حتَّى انه.
(¬2) البرهان في أصول الفقه (2/ 575).
(¬3) في (ز، ظ، ض): الا.
الحُكم للأفراد عمومًا أو خصوصًا، لا لكون اللفظ يدل أو لا. فإذا أَمر بقتل الكفار مثلًا ثم خَصص الذمي، فإنما خرج من الحكم وهو القتل، والمخرَج كافر لم يخرج عن تناول الكفار له. وقد سبق الإشارة لذلك مِن قول مَن قال: إن القابل للتخصيص حُكم ثبت لمتعدد. فالإخراج من الحكم على المتعدد، لا من إطلاق لفظ المتعدد.
وعن ذِكر ذلك استغنيت في النَّظم بما ذكرته هنا.
نعم، سيأتي في التخصيص بالاستثناء أن إسناد الحكم بعد الإخراج [أَوْلى] (¬1).
وقد ذكره ابن الحاجب هناك في كيفية دلالة نحو: (عشرة إلاَّ ثلاثة) هل الإسناد للسبعة بعد الإخراج للثلاثة؟ أو أن مجموع اللفظ يصير دالًّا؟ أو غير ذلك مما سيأتي إيضاحه في محله؟
وأما المسألة الثانية (وهي من مهمات هذا الباب):
الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أُرِيدَ به الخصوص، وهو مهم عزيز الوجود.
والشافعي رحمه الله أشار إلى تغايرهما في ترديده في آية البيع ونحوه بين أقوال، منها: أنه عام مخصوص. ومنها: أنه عام أُريدَ به الخصوص، وكثرت مقالات أصحابه في تقرير ذلك.
قال الشيخ أبو حامد: (والفرق بينهما أن الذي أريد به الخصوص ما كان المراد به أقَل، وما ليس بمراد هو الأكثر).
قال ابن أبي هريرة: (وليس كذلك العام المخصوص؛ لأن المراد به هو الأكثر، وما ليس بمراد هو الأقل).
قال: (ويفترقان في الحكم مِن جهة أنَّ الأول لا يصح الاحتجاج بظاهره، وهذا يمكن
¬__________
(¬1) كذا في (ص)، لكن (ق، س، ض): أولا.
بواسطة العادة التي أجراها الله تعالى.
وقولي: (عَلَى الَّذِي يُذْكَرُ في التَّفْصِيلِ) أي: على ما سيأتي تفصيله في "الملائمة" أنها إما لجلب مصلحة أو دفع مفسدة، وإما بأنها ضروري أو حاجي أو تحسيني ونحو ذلك مما يأتي موضحًا مفصلًا. وهذا التعريف جارٍ على طريقة مَن [لا] (¬1) يُعَلِّل أفعال الله بالمصالح، أيْ بمراعاة المصالح للعباد تَفَضُّلًا وإحسانًا، لا لِزُومًا كما تقوله المعتزلة.
وعلى هذا يُحمل قول ابن الحاجب في تعريف "المناسب": (إنه وصف ظاهر منضبط يحصل عَقْلًا مِن ترتيب الحكم عليه ما يَصْلُح أن يكون مقصودًا مِن حصول منفعة أو دَفْع مفسد) (¬2).
فلم يجعله مُحَصِّلًا لذلك، بل إنه بحيث يحصل به ذلك وإنْ لم يذكر في قوله: (يحصل): "بحيث يحصل" كما هي عبارة الآمدي. لكنها مرادهما فيما يظهر؛ لقولهما: (ما يصلح أن يكون مقصودًا)، ولم يقولا: (ما قُصِد به حصول منفعة).
ولو لم يحمل كلامهما على ذلك، لَزِم أنْ يَعْتَبِرَا في ماهية "المناسبة" ما هو خارج عنها وهو اقتران الحكم بالوصف، فإنه خارج، بدليل قولنا: (المناسبة مع الاقتران دليل العلة). فالمقارنة قَيْد في اعتبار المناسب عِلة، لا في تحقيق ماهيته.
وكذلك ترتيب الحكم على وَفْقه في الشرع زائد على ماهية "المناسب".
واحترز بِـ "صلاحية أن يكون مقصودًا" عن: الوصف المستبقى في السبر، والمدار في الدوران، وغير ذلك.
وليس هذا مغايرًا للتعريف الأول، بل هو بهذا التقدير يكون بسطًا له وإيضاحًا. وإنْ
¬__________
(¬1) ليس في (ت).
(¬2) مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل (2/ 1085)، الناشر: دار ابن حزم.