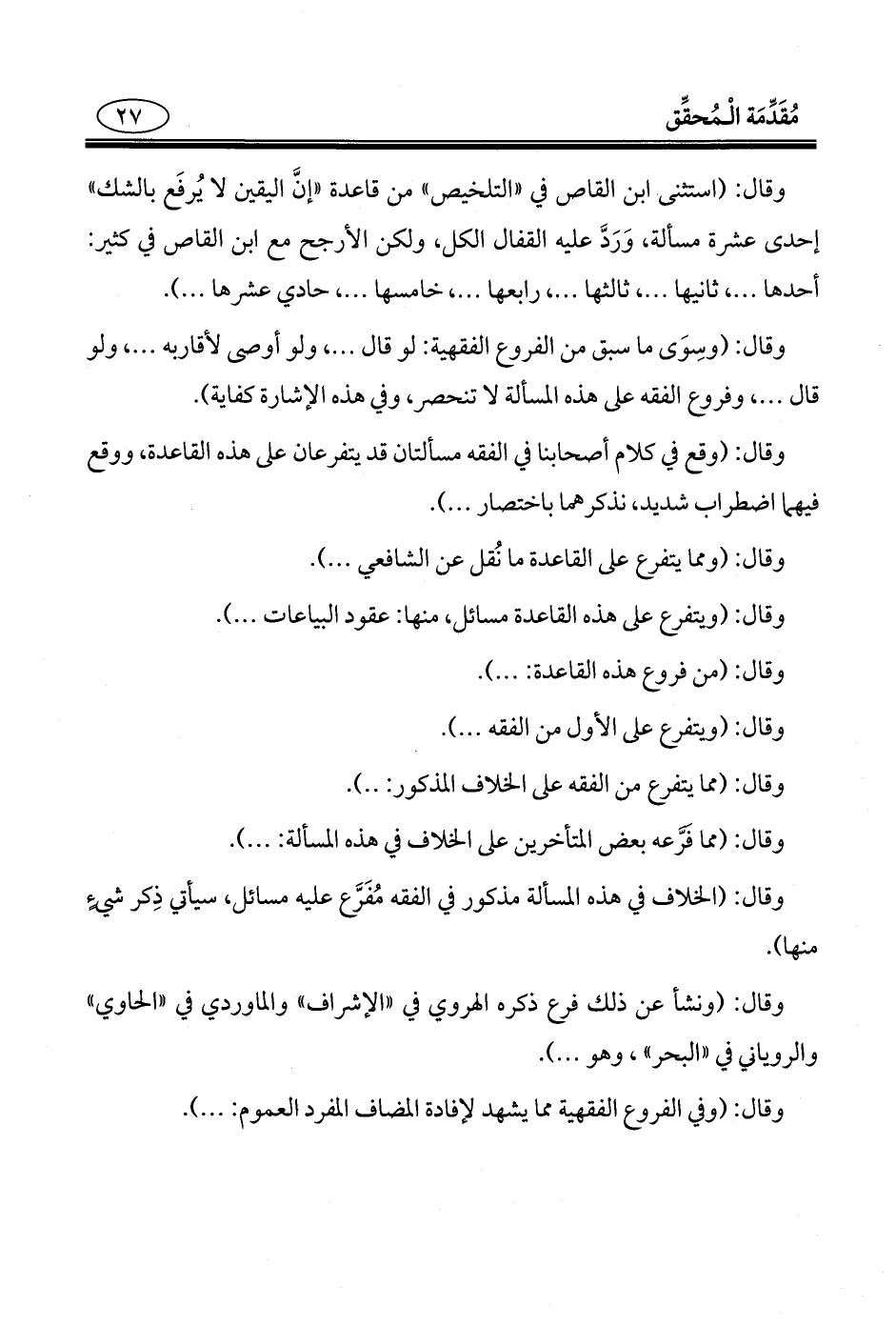
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية
وقال: (استثنى ابن القاص في "التلخيص" من قاعدة "إنَّ اليقين لا يُرفَع بالشك" إحدى عشرة مسألة، وَرَدَّ عليه القفال الكل، ولكن الأرجح مع ابن القاص في كثير: أحدها ... ، ثانيها ... ، ثالثها ... ، رابعها ... ، خامسها ... ، حادي عشرها ... ).وقال: (وسِوَى ما سبق من الفروع الفقهية: لو قال ... ، ولو أوصى لأقاربه ... ، ولو قال ... ، وفروع الفقه على هذه المسألة لا تنحصر، وفي هذه الإشارة كفاية).
وقال: (وقع في كلام أصحابنا في الفقه مسألتان قد يتفرعان على هذه القاعدة، ووقع فيهما اضطراب شديد، نذكرهما باختصار ... ).
وقال: (ومما يتفرع على القاعدة ما نُقل عن الشافعي ... ).
وقال: (ويتفرع على هذه القاعدة مسائل، منها: عقود البياعات ... ).
وقال: (من فروع هذه القاعدة: ... ).
وقال: (ويتفرع على الأول من الفقه ... ).
وقال: (مما يتفرع من الفقه على الخلاف المذكور: .. ).
وقال: (مما فَرَّعه بعض المتأخرين على الخلاف في هذه المسألة: ... ).
وقال: (الخلاف في هذه المسألة مذكور في الفقه مُفَرَّع عليه مسائل، سيأتي ذِكر شيءٍ منها).
وقال: (ونشأ عن ذلك فرع ذكره الهروي في "الإشراف" والماوردي في "الحاوي" والروياني في "البحر"، وهو ... ).
وقال: (وفي الفروع الفقهية مما يشهد لإفادة المضاف المفرد العموم: ... ).
لكن كلام الرافعي يقتضي جواز القراءة بالشاذ من غير أنْ ينبه على تفسير "الشاذ" بغير المشهور فيه، فإنه قال: تسوغ القراءة بالسبع وكذا بالقراءة الشاذة إن لم يكن فيها تغيير معنًى ولا زيادة حَرْف ولا نقصانه.
وزعم النووي في "شرح المهذب" أن كلام الرافعي في الصحة، لا في الجواز. يعني: فلا يبقى في كلامه إشكال. وكأنه يريد بذلك أن كلام الرافعي في صحة نقلها وثبوتها بالسند الصحيح، لا في جواز القراءة بها، ولكنه تأويل بعيد، وقد جزم هو في "الروضة" بأنه تصح الصلاة بالقراءة الشاذة إنْ لم يكن فيها تغيير معنى ولا زيادة حرف ولا نقصانه.
وقولي: (وَذَاكَ بَعْدَ سَبع تُقْرَأُ) إشارة إلى تفسير "الشاذ"، وهو لُغةً: المنفرد. واصطلاحًا: ما لم يتواتر من القراءات. أما الشذوذ في الأحاديث فسيأتي بيانه.
وقد اختُلف في ضبط القراءة الشاذة، فالمشهور أنها ما وراء السبعة المعروفة، وهو ظاهر كلام الرافعي السابق؛ ولذلك جريتُ عليه في النَّظم.
ونُقل عن البغوي أنه ما وراء العشرة، أي: هذه السبعة مع يعقوب وخلف وأبي جعفر يزيد بن القَعْقَاع. واختار هذا الشيخ تقي الدين السبكي وغيرُه، وقالوا: إنَّ قراءة الثلاثة المذكورين تواترت كالسبعة. وقد حكى البغويُّ في تفسيره الإجماعَ على جواز القراءة بها. قال أبو حيان وهو من أئمة هذا الشأن: لا نعلم أحدًا من المسلمين حظر القراءة بالثلاثة الزائدة على السبع، بل قُرئ بها في سائر الأمصار.
وقال الشيخ تاج الدين السبكي: (القول بأنها غير متواترة في غاية السقوط، ولا يصح القولُ به عمَّن يُعتبر قوله في الدِّين). انتهى
قال القاضي أبو بكر بن العربي في "القواصم": (ضَبْط الأمر على سبع قراءات ليس له أصل في الشرع، وقد جمع قومٌ ثماني قراءات، وقومٌ عشرًا).
كما بينتُ ذلك؛ ولهذا [لم أتركه] (¬1)، بل عقبته بالتحقيق الذي هو النَّص، فاعْلَمه.
تنبيهان
الأول: قال صاحب "كشف الأسرار" من الحنفية ما نَصه: (ظن بعض الشَّافعية أن هذا قياس جَلِي، وأصْله التأفيف وفَرْعه الضرب وعِلَّته دَفْع الأذى، وليس كما ظن؛ لأنَّ الأصل في القياس لا يجوز أن يكون جُزءًا مِن الفرع بالإجماع) (¬2).
قلتُ: هذا عجيب؛ فإنه إنما قِيس المسكوت على المنطوق، لا الأَعَم على بعضه، والعجب أنَّه إنما تَعرَّض للضرب فقط، لا لِمُطْلَق الإيذاء حتَّى يكون أَعَم من التأفيف.
الثاني: أشار إمام الحرمين في "البرهان" في "كتاب القياس" إلى أن الخلاف لفظي، وليس كذلك، بل من فوائده ما سيأتي في باب النسخ أَنَّا إذا قُلنا: (دلالته لفظية)، جاز النَّسخ به، وإلا فلا.
ومنها: أنَّه يُقَدَّم عليه الخبر إنْ كان قياسًا، وإلا فلا. قاله الغزالي في "المنخول".
نعم، قال الأستاذ أَبو إسحاق: هو قياس ولكن لا يُقَدَّم عليه الخبر.
قلتُ: ومَنْشَأُ ذلك كله ما سبق مِن أن له اعتبارًا آخَر في استناد النَّص.
قيل: ولا شك في تقديمه على القياس؛ لأنه أقوى منه، لكن لو كان القياس عِلته منصوصة فالظاهر تقديم القياس عليه؛ لأنه بمنزلة النَّص.
¬__________
(¬1) في (ز، ظ): أركتمه.
(¬2) كشف الأسرار (1/ 115).
التعلق بظاهره؛ اعتبارًا بالأكثر).
وفرق الماوردي بوجهين، أحدهما هذا، والثاني أن إرادة ما أُريدَ به خاص متقدمة على لفظ العام، وما أُريدَ به العموم ثُم خُصَّ تتأخر أو تقارن.
وقال ابن دقيق العيد في "شرح العنوان": (يجب أن يُتَنبه للفرق بينهما، فالعام المخصوص أعم مِن العام الذي أُريدَ به الخصوص، ألا ترَى أن المتكلِّم إذا أراد باللفظ أولًا ما دَلَّ عليه ظاهره مِن العموم ثم أَخرَج بعد ذلك بعض ما دل عليه اللفظ، كان عامًّا مخصوصًا، ولم يكن عامًّا أريد به الخصوص. ويقال: إنه منسوخ بالنسبة إلى البعض الذي أخرج. وهذا متوجه إذا قصد العموم، وفرق بينه وبين أنْ لا يقصد الخصوص، بخلاف ما إذا نطق باللفظ العام مريدًا به بعض ما تناوله في هذا). انتهى
وحاصل ما قرره أنَّ العام إذا قُصِر على بعضه، له ثلاثة أحوال:
الأول: أنْ يُراد به في الابتداء خاص، فهذا هو المراد به خاص.
والثاني: أن يراد به عام ثم يخرج منه بعضه، فهو نسخ.
والثالث: أن لا يقصد به خاص ولا عام في الابتداء، ثم يخرج منه أمر يتبين بذلك أنه لم يُرَد به في الابتداء عمومُه، فهذا هو العام المخصوص.
فلهذا كان التخصيص عندنا بيانًا، لا نَسخًا، إلا إنْ أُخْرِج بعد دخول وقت العمل بالعام، فيكون نَسْخًا؛ لأنه قد تبَيَّن أن العموم أُرِيدَ في الابتداء.
وممن حرر الفرق بينهما أيضًا من المتأخرين الشيخ تقي الدين السبكي، فقال: (جرى ذِكر هذه المسألة في درس في العادلية يوم الاثنين، الثالث والعشرين من صفر سنة خمس
كان في "جمع الجوامع" جعله قولًا مغايِرًا له، ولكن هذا عندي أجود.
الثاني مِن التعاريف للمناسب:
ما عَرَّف به البيضاوي أنه: ما يجلب للإنسان نفعًا أو يدفع عنه ضررًا.
ونحوه عبارة بعضهم: الوصف المُفْضِي إلى ما يجلب للإنسان نفعًا أو يدفع عنه ضررًا. وهو مغايِر للذي قَبْله بأنَّ هذا لم يجعل المقصود في جلب النفع ودفع الضرر نفس الوصف، بل الذي يفضي إليه الوصف، والأول جعله نفس الوصف، وكلاهما على طريقة مَن يُعَلِّل أفعال الله عز وجل بمراعاة المصالح، أي: بالنسبة للعبد؛ لِتَعَالِي الرب عن الانتفاع والضرر. وهذا بخلاف التعريف المختار كما قررناه، وهو الجاري على قول الأشعري؛ ولهذا الإمام الرازي لَمَّا ذكر هذين التفسيرين أشار إلى مَا قُلناه مِن اختلافهما باختلاف قَوْلَي الناس في تعليل أفعال الله تعالى.
الثالث: قول أبي زيد الدبوسي مِن الحنفية: إنَّ المناسب ما لو عُرض على العقول لَتَلَقَّتْهُ بالقبول.
قال صاحب "البديع": (وهو أقرب إلى اللغة) (¬1).
وبُنِيَ عليه الاحتجاج به على العلة في مقام المناظرة دون مقام النظر؛ لإمكان أن يقول الخصم: هذا لا يتلقاه عقلي بالقبول وليس الاحتجاج عَلَيَّ بِتَلَقِّي عقل غيري له بِأَوْلَى مِن الاحتجاج على ذلك الغَيْر بِعَدَم تَلَقِّي عقلي له بالقبول.
ومنهم مَن أجاب عن ذلك بأنه ليس الاعتبار بتلقي عقله ولا عقل مناظره فقط، بل المراد العقول السليمة والطباع المستقيمة إذا عُرِضَ عليها وتلقته، انتهض دليلًا على مُناظِرِه.
¬__________
(¬1) بيان معاني البديع (2/ 794)، رسالة دكتوراة مقدمة من الطالب: صبغة الله غلام، جامعة أم القرى/ 1410 هـ.