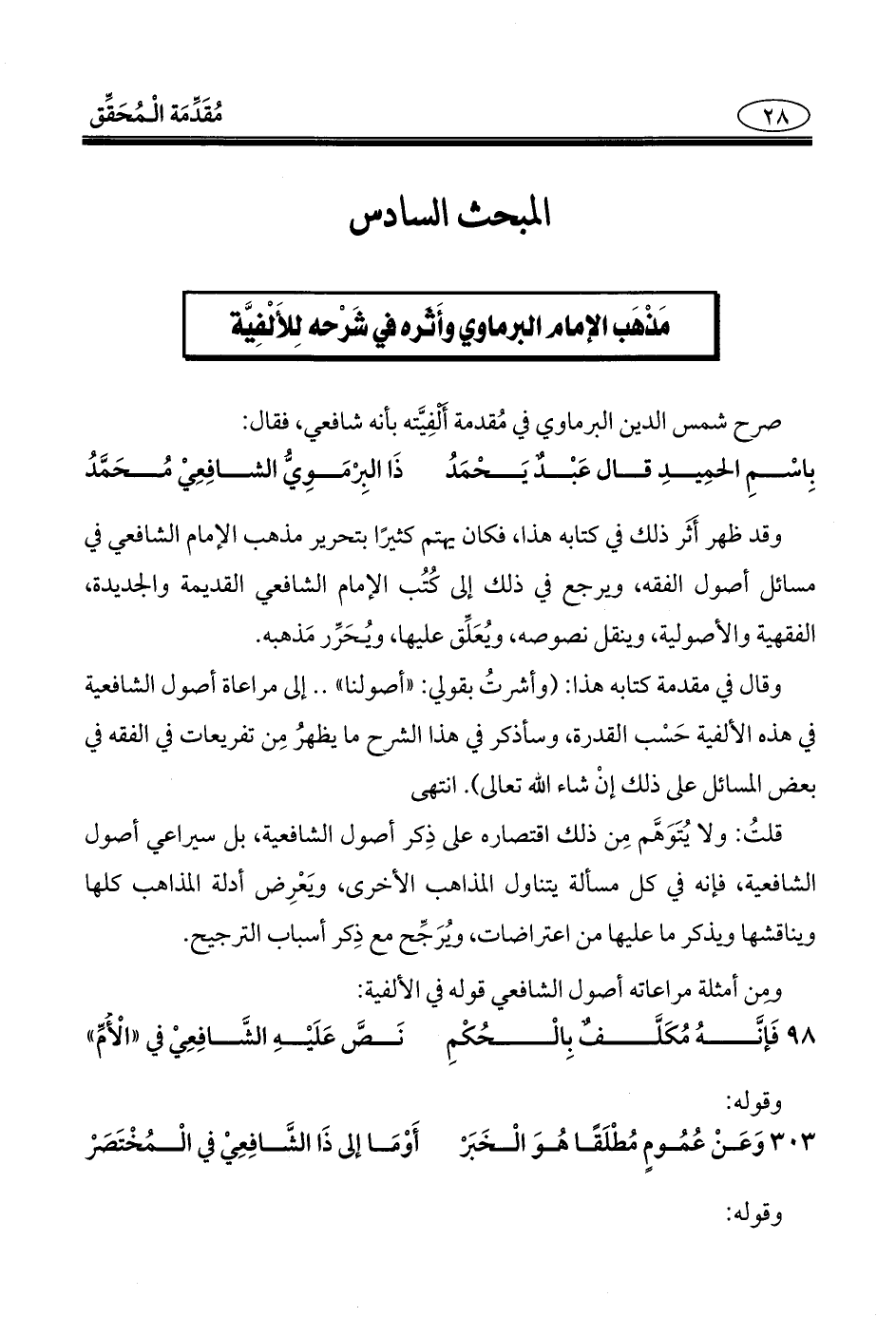
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية
المبحث السادس: مَذْهَب الإمام البرماوي وأَثَره في شَرْحه لِلأَلْفِيَّةصرح شمس الدين البرماوي في مُقدمة أَلْفِيَّته بأنه شافعي، فقال:
بِاسْمِ الحمِيدِ قال عَبْدٌ يَحْمَدُ ... ذَا البِرْمَوِيُّ الشافِعِيْ مُحَمَّدُ
وقد ظهر أَثَر ذلك في كتابه هذا، فكان يهتم كثيرًا بتحرير مذهب الإمام الشافعي في مسائل أصول الفقه، ويرجع في ذلك إلى كُتُب الإمام الشافعي القديمة والجديدة، الفقهية والأصولية، وينقل نصوصه، ويُعَلِّق عليها، ويُحَرِّر مَذهبه.
وقال في مقدمة كتابه هذا: (وأشرتُ بقولي: "أصولنا" .. إلى مراعاة أصول الشافعية في هذه الألفية حَسْب القدرة، وسأذكر في هذا الشرح ما يظهرُ مِن تفريعات في الفقه في بعض المسائل على ذلك إنْ شاء الله تعالى). انتهى
قلتُ: ولا يُتَوَهَّم مِن ذلك اقتصاره على ذِكر أصول الشافعية، بل سيراعي أصول الشافعية، فإنه في كل مسألة يتناول المذاهب الأخرى، ويَعْرِض أدلة المذاهب كلها ويناقشها ويذكر ما عليها من اعتراضات، ويُرَجِّح مع ذِكر أسباب الترجيح.
ومِن أمثلة مراعاته أصول الشافعي قوله في الألفية:
98 - فَإنَّهُ مُكَلَّفٌ بِالْحُكْمِ ... نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيْ في "الْأُمِّ"
وقوله:
303 - وَعَنْ عُمُومٍ مُطْلَقًا هُوَ الْخَبَرْ ... أَوْ مَا إلى ذَا الشَّافِعِيْ في الْمُخْتَصَرْ
وقوله:
قال: (وأصلُ ذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "أُنزل القرآن على سبعة أحرف" (¬1). فظن قومٌ أنها سبع قراءات، وهو باطل) (¬2). انتهى
قلتُ: قد يُمنع ما قاله بأن كوْنها سبعة إنما هو بحسب الواقع اتفاقًا، لا للحديث. والحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس وأُبي بن كعب وعمر - رضي الله عنهم -.
قال أبو حاتم بن حبان: (اختُلف في المراد بذلك على خمسة وثلاثين قولًا، وقد وقفتُ منها على كثير). انتهى
ورجح القرطبي قول الطحاوي: إن المراد به أنه وُسع عليهم في مبدأ الأمر أن يُعبِّروا عن المعنى الواحد بما يدل عليه لُغة إلى سبعة ألفاظ؛ لأنهم كانوا أُميين لا يَكتب إلا القليل منهم، فشقَّ على أهل كل ذي لُغة أن يتحول إلى غيرها، فلمَّا كثر مَن يَكتب وعادت لُغاتهم إلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتفع ذلك، فلا ويُقرأ إلا باللفظ الذي نزل.
ثم نقل ذلك عن ابن عبد البر وعن القاضي أبي بكر، ومن ذلك أن أُبي بن كعب كان يقرأ {لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا} [الحديد: 13]: "للذين آمنوا امهلونا"، "للذين آمنوا أخرونا".
وممن اختار هذا القول أيضًا ابن العربي. وإنْ كان في قوله: "أُنزل على سبعة أَحْرُف" ما قد ينافي إرادة السماحة في لُغات، فإنه ما نزل إلا بواحدة، والتوسيع ليس من المنزل، [بل] (¬3) في حُكمه، إلا أن يُؤوَّل ["أنزل القرآن" أي] (¬4): أنزل أنْ يُقرأ على سبعة أحرف.
واعْلم أن ممن نُقل عنه أن المراد به القراءات السبع الخليل بن أحمد، وهو أضعف
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (رقم: 4754)، صحيح مسلم (رقم: 818).
(¬2) العواصم من القواصم (ص 360)، الناشر: دار التراث - مصر.
(¬3) من (ز).
(¬4) من (ش).
ومنها: ما قاله صاحب "الكشف" (¬1) أيضًا: إنه هل يعمل عمل النَّص؟ أوْ لا حتَّى لا يجري فيما يمتنع فيه القياس من الحدود والكفارات؟
أي: بناءً على مذهبهم، وقد سبقت المسألة في "باب الأدلة" في الكلام على القياس.
ومنها: ما سيأتي أيضًا في تخصيص العام بالفحوى، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لَيُّ الواجِد يُحِل عرضَه وعقوبته" (¬2). أي: وعقوبته هي الحبس، هل يختص ذلك بغير الولد؛ لقوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ}؟ فلا يُحْبَس الوالِدُ للولدِ كما نسبه إمام الحرمين لمعظم الأصحاب ونسبه الرافعي في "باب [التفليس] (¬3) " لتصحيح البغوي، وزاد النووي رحمه الله: إنه الأصح في "المهذب" وغيره، ومقابِلُه وَجْه صححه الغزالي، وجَرَى عليه صاحب "الحاوي الصغير".
ومَنْشَأُ الخلاف صلاحية تخصيص الفحوى - أو القياس - للعموم. وسيأتي فيه مزيد بيان في باب التخصيص، والله أعلم.
ص:
466 - وَإنْ يَكُنْ خَالَفَ، فَـ "الْمُخَالَفَهْ" ... فَخُذْ بِهَا بِمَا تَرَاني وَاصِفَهْ
467 - وَبِـ "دَلِيلٍ لِلْخِطَابِ" إنْ [تُضِفْ] (¬4) ... سَمِّ بِهِ ذَا النَّوْعَ فِيمَا قَدْ وُصِفْ
الشرح:
هذا هو الضرب الثاني من المفهوم وهو "مفهوم المخالفة"، وهو أن يكون المسكوت
¬__________
(¬1) كشف الأسرار (1/ 116).
(¬2) سبق تخريجه.
(¬3) كذا في (ز). وفي (ظ): الفيلس. وفي سائر النُّسخ: الفلس.
(¬4) في (ش، ن 2): يضف.
وأربعين وسبعمائة، فخبط فيها الحاضرون، وهُم معذورون [بسبب] (¬1) ما بَلَغَهم مِن العِلم، فكتبتُ فيها وفي دلالة العام في الأمرين على الخاص -هل هو حقيقة؟ أو مجاز؟ - زبدة كلام مَن تكلم فيه من العلماء، وزدتُ عليهم تحقيقات لم يلموا بها).
فنذكر ما قاله؛ لما اشتمل عليه من الفوائد.
فقال: (العام الذي أريدَ به الخصوص هو العام إذا أُطلق وأريدَ به بعض ما يتناوله، فهو لفظ مستعمل في بعض مدلوله، وبَعْضُ الشيء غَيْره، فالذي يظهر أنه مجاز قطعًا، إلا إنْ قيل: إن العام دلالته على كل فرد من أفراده دلالة مطابقة. فقد يقال حينئذٍ على هذا بأنه حقيقة في كل فرد. فإنْ جاء خلاف فيه فإنما يجيء من هذه الجهة.
وشرط الإرادة في هذا النوع -على ما ظهر لنا- أن تكون مقارِنة لأول اللفظ، ولا يُكتفَى بطريانها في أثنائه؛ لأن المقصود فيها نقلُ اللفظ عن معناه إلى غيره واستعماله في غير موضوعه، وليست إرادة إخراج لبعض المدلول، بل إرادة استعمال اللفظ في شيء آخَر غَيْر موضوعه، كما يُراد باللفظ مجازه الخارج عنه، لا فرق بينهما إلا أنَّ ذاك خارج وهذا داخل؛ لأن البعض داخل في الكل.
ومَن يجعل الدلالة على كل فرد دلالة مطابقة، لا يناسبه أن يقول: إنه استعمال اللفظ في غير موضوعه، بل يصير كاستعمال المشترك في أَحد معنييه، وهو استعمال حقيقي، وإرادة أَحد مَعْنَيَي المشترك عند مانع استعمال المشترك في مَعْنَيَيْه لا شك أنها لا تخرجه عن موضوعه ولا تجعله مجازًا، بل هي مُصَحِّحة لاستعماله.
وأما عند مَن يُجَوِّز استعماله في معنييه فَهُم مختلفون إذا استُعمل في معنييه هل هو مجاز؟ أَم لا؟ فمَن جعله مجازًا فذلك لأن الاستعمال الحقيقي عنده هو استعماله في أحد المعنيين،
¬__________
(¬1) كذا في (ص، ق)، لكن في (س): بحسب.
تنبيهات
أحدها: قولهم: (وَصْف) جارٍ على الغالب، وإلا فقد سبق أن العلة تكون حُكمًا شرعيًّا وأمرًا عرفيًّا أو لُغويًّا.
الثاني: إنَّ مقتضَى ما سبق نقله في تعريف الآمدي وابن الحاجب يقتضي أن الحكمة لا يُعَلَّل بها. ولكن مختارهما أن الحكمة إنِ انضبطت جاز التعليل بها.
الثالث: إنَّ حصول الحكم في الوصف المناسب قد يكون:
- يقينًا، كالبيع، فإنه إذا كان صحيحًا، حصل منه الملك الذي هو المقصود.
- أو ظنًّا، كالقصَاص للانزجار، بدليل وجود الإقدام مع عِلمهم بأنَّ القصَاص مشروع.
- وقد يتساوى حصول المقصود وعدم حصوله، فلا يوجد لا قَطْع ولا ظن، بل يكونان متساويين.
قال صاحب "البديع": (ولا مثال له على التحقيق) (¬1).
ويقرب منه ما مَثَّل به ابن الحاجب مِن حد شارب المسكر؛ لحفظ العقل، فإنَّ المُقدمين كثير والمجتنبين كثير، فتساوى المقصود وعدمه فيه.
وقد يكون عدم حصول المقصود أَرْجَح من حصوله، كنكاح الآيسة لمصلحة التوالد؛ لأنه -مع إمكانه- بعيدٌ عادةً.
¬__________
(¬1) بيان معاني البديع (2/ 798).