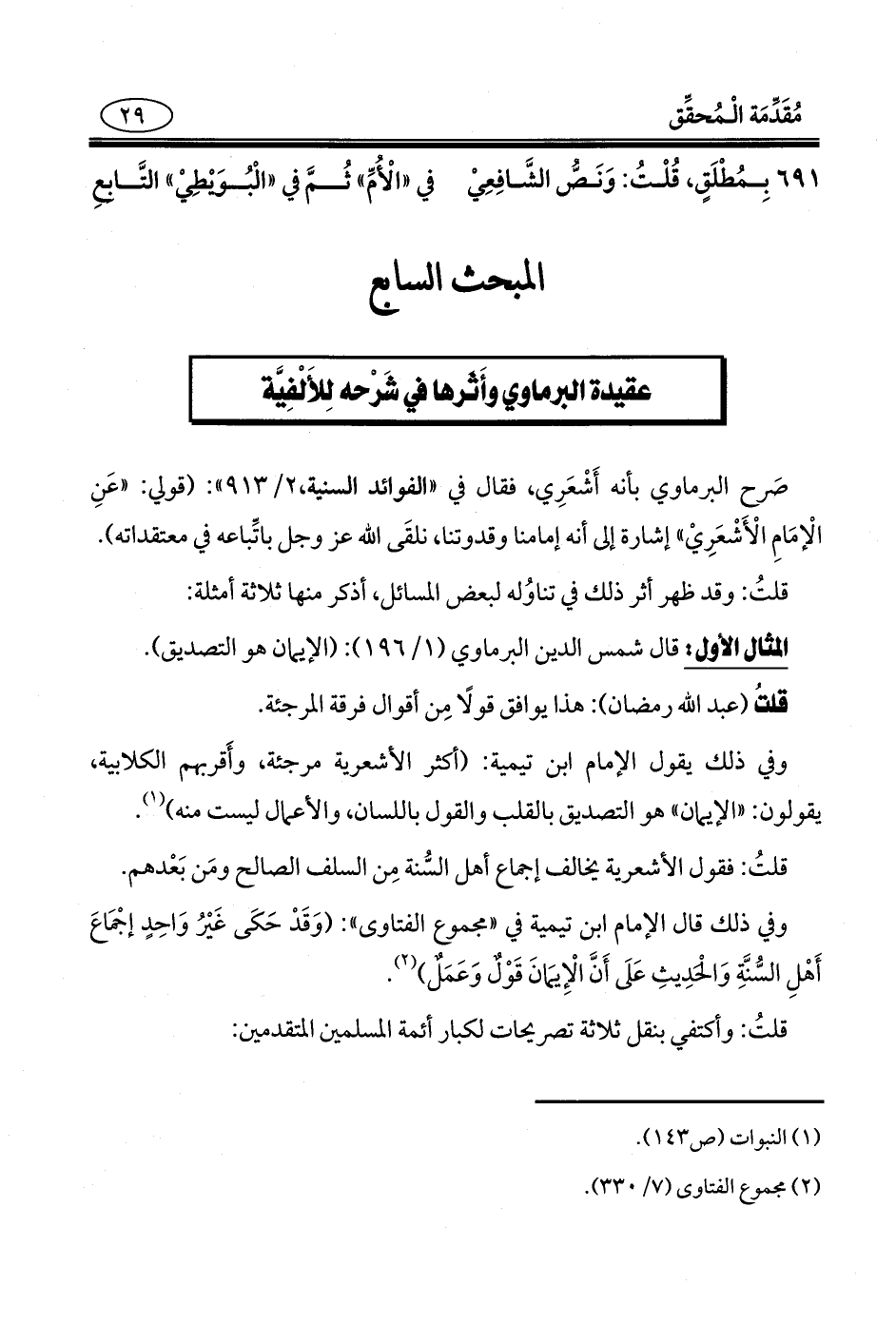
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية
691 - بِمُطْلَقٍ، قُلْتُ: وَنَصُّ الشَّافِعِيْ ... في "الْأُمِّ" ثُمَّ في "الْبُوَيْطِيْ" التَّابِعِالمبحث السابع: عقيدة البرماوي وأَثَرها في شَرْحه لِلأَلْفِيَّة
صَرح البرماوي بأنه أَشْعَرِي، فقال في "الفوائد السنية، 2/ 913": (قولي: "عَنِ الْإمَامِ الْأَشْعَرِيْ" إشارة إلى أنه إمامنا وقدوتنا، نلقَى الله عز وجل باتِّباعه في معتقداته).
قلتُ: وقد ظهر أثر ذلك في تناوُله لبعض المسائل، أذكر منها ثلاثة أمثلة:
المثال الأول: قال شمس الدين البرماوي (1/ 196): (الإيمان هو التصديق).
قلتُ (عبد الله رمضان): هذا يوافق قولًا مِن أقوال فرقة المرجئة.
وفي ذلك يقول الإمام ابن تيمية: (أكثر الأشعرية مرجئة، وأَقربهم الكلابية، يقولون: "الإيمان" هو التصديق بالقلب والقول باللسان، والأعمال ليست منه) (¬1).
قلتُ: فقول الأشعرية يخالف إجماع أهل السُّنة مِن السلف الصالح ومَن بَعْدهم.
وفي ذلك قال الإمام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى": (وَقَدْ حَكَى غَيْرُ وَاحِدٍ إجْمَاعَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الْإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ) (¬2).
قلتُ: وأكتفي بنقل ثلاثة تصريحات لكبار أئمة المسلمين المتقدمين:
¬__________
(¬1) النبوات (ص 143).
(¬2) مجموع الفتاوى (7/ 330).
الأقوال، وليس هذا موضع بَسْطها.
وقولي: (نَعَمْ، يَكُونُ حُجَّةً) إلى آخِره - إشارة إلى أن القراءات الشاذة إذا صح سندها، فالصحيح أنه يُحتج بها؛ لأنه إذا بطل خصوص كوْنها قرآنًا لِعَدم التواتر، يبقى عموم كوْنها خبرًا. وقد أطلق الشافعي - فيما حكاه البويطي عنه في باب الرضاع وفي تحريم الجمْع - الاحتجاجَ بها، وعليه جمهور أصحابه، كالقضاة: الحسين وأبي الطيب والروياني، وكذا الرافعي. وقد احتجوا على قطع اليمين من السارق بقراءة ابن مسعود: "والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم".
ونقله ابن الحاجب عن أبب حنيفة، حيث احتج على وجوب التتابع بما نُقل عن مصحف ابن مسعود: "فصيام ثلاثة أيام متتابعات" بعد أنِ اختار - تبعًا للآمدي ونسبه للشافعي - أنه ليس بحجة.
وكذا قال الأبياري في "شرح البرهان": إنه المشهور من مذهب مالك والشافعي.
وقال النووي في "شرح مسلم": إنه مذهب الشافعي. قال: لأن ناقلَها لم ينقلها إلا على أنها قرآن، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر. وإذا لم يثبت قرآنا، لم يثبت خبرًا.
وكذا زعم إمام الحرمين في "البرهان" أن الشافعي إنما لم يقُل بالتتابع كأبي حنيفة لأنَّ عنده أن الشاذ لا يُعمل به، وتبع الإمام في ذلك أبو نصر القشيري والغزالي في "المنخول" وإلْكِيا وابن السمعاني. ولكن المذهب إنما هو ما سبق عن نَص البويطي وغيره، فهو الأرجح.
ومسألة التتابع حكى الماوردي فيها قولًا بالوجوب احتجاجًا بقراءة "متتابعات"، ولكن الأرجح لا يجب، لا لكون القراءة الشاذة غير حُجة؛ بل لأنها إنما نُقلت تأويلًا، لا قراءةً، أو لمعارضة ذلك بقول عائشة - رضي الله عنها -: (نزلت "فصيام ثلاثة أيام متتابعات"، فسقطت
مخالفًا في الحكم للمذكور، ويجب الأخذ به والاحتجاج في أنواع يأتي ذِكرها ووصفها وما يُشترط في العمل بها، ويُسمى هذا النوع "دليل الخطاب"، وهو معنى قولي: (إنْ تُضِفْ)، أي: عند إضافة لفظ دليل إلى الخطاب، فلمَّا لم يَتأتَّ لي نَظْمه بصورته، عَبَّرت عنه بذلك.
وإنَّما سُمي بذلك لأن دلالته من جنس دلالات الخطاب، أو لأن الخطاب دالٌّ عليه، أو لمخالفته منظوم اللفظ كما في "منخول" الغزالي عن ابن فورك، على أن بعضهم حاول فرقًا بينهما، والحقُّ خِلافه. ومنهم مَن يُسميه "لحن الخطاب"، وقد سبق أن "لحن الخطاب" عند الجمهور إنما هو اسم لأحد نَوْعَي الموافقة.
واعْلَم أنَّ التخالف بين المذكور والمسكوت هل هو لكون حُكمه ضد حُكمه؟ أو نقيضه؟
زعم القرافي في قواعده [الثاني] (¬1)، قال: (ولهذا استدل بعض أصحابنا بقوله تعالى: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} [التوبة: 84] على وجوب الصلاة على المؤمنين) (¬2).
أي: فَضِد النهي عن الصلاة إيجابها.
وضُعِّف بأنَّ المخالفة تَصْدُق بالأعَم وهو النقيض، فالاقتصار على الضد يستدعي دليلًا، وحينئذٍ فمفهومُ النهي عن الصلاة على المنافقين عدمُ النهي عن الصلاة على غيرهم، وهو أَعَم مِن الإيجاب والندب والإباحة، فلا دلالة فيه على خصوص الوجوب؛ إذْ لا يَلزم مِن وجودِ الأَعَم وجودُ الأَخَص، والله أعلم.
¬__________
(¬1) كذا في (ز، ق، ظ) وهو الصواب كما في الفروق (2/ 71). لكن في (ص، ش، ت، ض): الأول. وهذا الاستدلال نقله القرافي ثم ضَعَّفه بما ذكره البرماوي.
(¬2) الفروق (2/ 70).
ومَن جعله حقيقة كالعام كما هي طريقة السيف الآمدي في النقل عن الشافعي - رضي الله عنه -، فيصير البحث فيه كالبحث في العام المراد به الخصوص.
وفيه نظر؛ لأنَّا نَعلم أن المشترك وَضَعَه الواضع لكل مِن المعنيين وَحْده، بخلاف العام. ولكن أدى مساق البحث على طريقة الآمدي إلى ما قُلناه.
ويؤنسك إلى اشتراط مقارنة الإرادة في هذا النوع لأول اللفظ ما ذكره الفقهاء في تكبيرة الإحرام وقي كنايات الطلاق، وإذا حَقَّقْت هذا المعنى، اضبطه.
وأما العام المخصوص فهو العام الذي أُريدَ به معناه مخُرجًا منه بعض أفراده. فالإرادة فيه إرادة الإخراج، لا إرادة الاستعمال، فهي تشبه الاستثناء، فلا يشترط مقارنتها لأول اللفظ، ولا يجوز تأخرها عن آخِره، بل يُشترط -إنْ لم توجد في أوله- أن تكون في أثنائه.
ويؤنسك في هذا ما قاله الفقهاء في مشيئة الطلاق وأنه يشترط اقتران النية ببعض اللفظ قبل فراغه، فالتخصيص إخراج كما أن الاستثناء إخراج.
ولهذا نقول: المخصصات المتصلة أربعة: الاستثناء، والغاية، والشرط، والصفة. والمخَصِّص في الحقيقة هو الإرادة المُخْرِجة، وهذه الأربعة والمخَصِّص المنفصل خَمْسَتُها دالة على تلك الإرادة، وتلك الإرادة ليست إرادة استعمال اللفظ في غير موضوعه؛ فلذلك لم يُقْطَع بكونها مجازًا، بل حصل التردد.
ومنشأ التردد أنَّ إرادة إخراج بعض المدلول هل [تُصَيِّر] (¬1) اللفظ مُرادًا به الباقي؟ أو لا؟ والحقُّ لا، وهو يُشْبه الخلاف في الاستثناء، وبهذا يقوى أن العام المخصوص حقيقة، لكن الأكثرون على أنه مجاز. ووَجْهه أنْ يجعل اللفظ موضوعًا ليستعمل في معناه بتمامه غير مخرج منه شيء، فإذا أُخْرج منه شيء، كان مجازًا؛ لاستعماله على غَيْر الوجه الذي وَضَعَه
¬__________
(¬1) كذا في (ص)، لكن في (س): يصير.
والتعليل في هذين الآخَرين فيه خلاف.
فمنهم مَن منع في الأول منهما؛ للتردد بين حصول المقصود وعدمه من غير ترجيح.
وفي ثانيهما أيضًا؛ لرجحان نفي المقصود على حصوله.
ولكن الأصح -وفاقًا لابن الحاجب وغيره- الجواز؛ فإن السفر مظنة المشقة، وقد اعتُبِرَ وإنِ انتفى الظن في سفر الملك المُتَرفِّه على هيئةٍ لا مشقة فيها بمجرد احتمال المقصود.
وقال في "البديع": إن هذين الآخَرين متفق على اعتبارهما إذا كان المقصود ظاهرًا من الوصف في غالب صُوَر الجنس، وإلا فلا.
أما إذا كان المقصود فائتًا قطعًا فلا يُعتبر، خلافًا للحنفية، فيلحق عندهم النسب في ولد مَن تزوج وهو بالمشرق امرأة بالمغرب بطريق التوكيل -مع القطع بأنَّ الولد ليس منه؛ وذلك لاقتضاء الزواج ذلك في الأغلب. فعمم ذلك؛ حفظًا للنسب.
ومثله في الاستبراء جارية اشتراها بائعُها في المجلس. وجعله في "جمع الجوامع" مما يبعد فيه العلوق منه.
وينبغي أن يُقيَّد بأنْ يقارِنه احتمالٌ ما. أما إذا لم يحتمل فهو مِن المقطوع بنفيه كما ذكرناه، وإنما الاستبراء هنا للتعبد.
قولي: (وَبِـ "إخَالَةٍ" يُسَمَّى) أي: يقال في "المناسبة" أيضًا: "إخالة"، فَهُمَا اسمان مترادفان. وسُمي "إخالة"؛ لأن ذلك باعتبار النظر إليه يُخال أنه علة، أي: يُظَن.
وكذا يسمى ذلك الاستخراج (أيْ: استخراج كون ذلك علة؛ لِمَا فيه مِن المناسبة): "تخريج المناط"، مِن "نَاطَ" أيْ: تعلق. أيْ: خرج ما نِيطَ به الحكم.
فالنياط: التعلُّق. و"المناط": هو المُتَعَلَّق، كأنه استخرج مُتَعَلَّق هذا الحكم مِن أوصاف الأصل المَقِيس عليه، فَحَكَم بأنه عِلة.