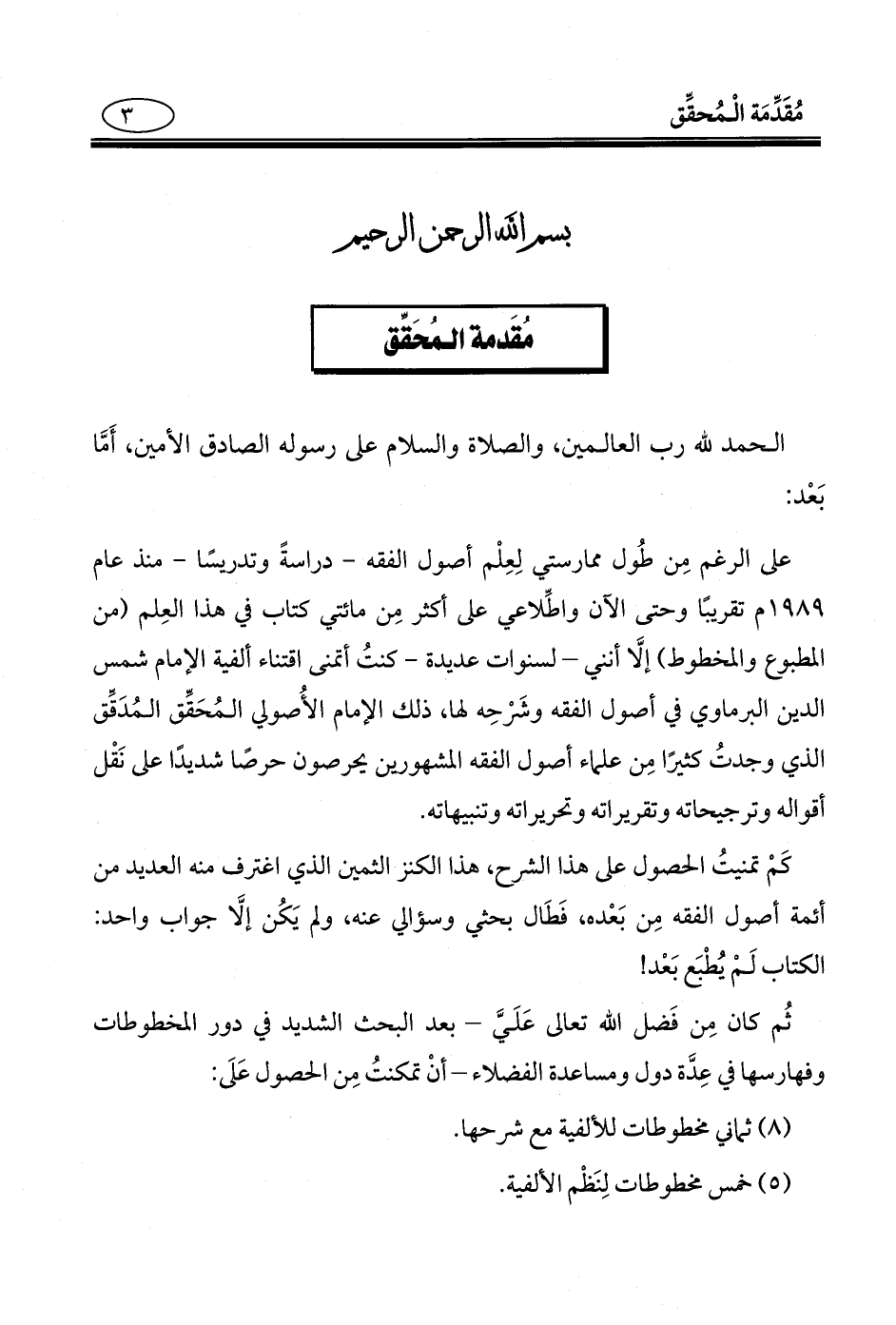
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِمُقَدمة المُحَقِّق
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين، أَمَّا بَعْد:
على الرغم مِن طُول ممارستي لِعِلْم أصول الفقه - دراسةً وتدريسًا - منذ عام 1989 م تقريبًا وحتى الآن واطِّلاعي على أكثر مِن مائتي كتاب في هذا العِلم (من المطبوع والمخطوط) إلَّا أنني - لسنوات عديدة - كنتُ أتمنى اقتناء ألفية الإمام شمس الدين البرماوي في أصول الفقه وشَرْحِه لها، ذلك الإمام الأُصولي المُحَقِّق المُدَقِّق الذي وجدتُ كثيرًا مِن علماء أصول الفقه المشهورين يحرصون حرصًا شديدًا على نَقْل أقواله وترجيحاته وتقريراته وتحريراته وتنبيهاته.
كَمْ تمنيتُ الحصول على هذا الشرح، هذا الكنز الثمين الذي اغترف منه العديد من أئمة أصول الفقه مِن بَعْده، فَطَال بحثي وسؤالي عنه، ولم يَكُن إلَّا جواب واحد: الكتاب لَمْ يُطْبَع بَعْد!
ثُم كان مِن فَضل الله تعالى عَلَيَّ - بعد البحث الشديد في دور المخطوطات وفهارسها في عِدَّة دول ومساعدة الفضلاء - أنْ تمكنتُ مِن الحصول عَلَى:
(8) ثماني مخطوطات للألفية مع شرحها.
(5) خمس مخطوطات لِنَظْم الألفية.
الباب الثاني
في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة"
رفعته، ومنه: مَنصة العروس (بفتح الميم). قاله المطرزي.
فقولي: (مَعْنًى) مرفوع بفعل محذوف على حد قوله تعالى: {إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ (1)} [الانفطار: 1].
والظاهر: ما أفاد معنى مع احتمال معنى غيره لكنه ضعيف، فهو بسبب ضعفه خفي؛ فلذلك سُمي اللفظ لدلالته على مقابِله وهو القوي "ظاهرًا"، كالأسد فإنه ظاهر في الحيوان المفترس، ويحتمل أن يُراد به الرجل الشجاع مجازًا، لكنه احتمال ضعيف.
والكلام في دلالة اللفظ الواحد؛ ليخرج "المُجْمَل مع المُبَيِّن"؛ لأنه وإنْ أفاد معنى لا يحتمل غيره فإنه لا يُسمى مِثله "نَصًّا".
واعْلَم أن "النَّص" كما يُطلق في مقابَلة "الظاهر" يُطلق أيضًا في مقابلة الاستنباط والقياس، فيقال مثلًا: دَلَّ عليه النَّص والقياس. فهو أَعَم مِن أن يكون معه احتمال آخَر أو ليس معه، وهذا كما سيأتي في أن العلة إما منصوصة وإما مستنبطة، وفي أن شرط الفرع أنْ لا يكون منصوصًا، ونحو ذلك. ومن هذا قولهم: (نَصُّ الشَّافعي كذا) في مقابلة قول مُخَرَّج أو نحوه، يعنون به أَعَم مِن النَّص والظاهر، والله أعلم.
ص:
448 - كِلَاهُمَا "الْمُحْكَمُ"، وَالْمُقَابِلُ ... فَ "مُتَشَابِهٌ" إذَا [تُقَابِلُ] (¬1)
449 - يَسْتَأْثِرُ اللهُ بِعِلْمِهِ، وَقَد ... يُطْلِعُ بَعْضَ أَصْفِيَاهُ [الْمُعْتَمَدْ] (¬2)
¬__________
(¬1) في (ض، ت، ن): يقابل.
(¬2) في (ن 1، ن 3، ن 4): المعد.
قلتين، لم يحمل الخبث" (¬1) على غير ما وقع فيه ميتة لا نَفس لها سائلة، وشبه ذلك.
تنبيهات
الأول: المراد مِن قَصْرِ العام قصرُ حُكمه، وإنْ كان لفظ العام باقيًا على عمومه لكن لفظًا لا حُكمًا؛ فبذلك يخرج إطلاق العام وإرادة الخاص؛ فإنَّ ذلك قَصْر دلالة لفظ العام، لا قصر حُكمه. وسيتضح ذلك بما سيأتي مِن كون التخصيص إخراجًا مِن الحكم، لا مِن لفظ "العام"، ومِن الفرق بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص، وأن دلالةَ الأولِ على باقي الأفراد حقيقةٌ (على المرجَّح)، والثاني مجاز قطعًا.
ولهذا قال البيضاوي عقب تعريف "التخصيص" وتبعه في "جمع الجوامع": إنَّ القابل للتخصيص حكم ثبت لمتعدد (¬2).
ولكن استُشكِل عليه بأنه يشمل العدد والجمع المنكَّر، والتخصيص إنما هو للعام، ولا عموم فيهما.
وقد أجاب في "منع الموانع" عن الأول: بأنَّ مدلول اسم العدد واحد، والتعدد إنما هو في المعدود.
ومراده بذلك أنَّ مدلول العدد كلٌّ مجموعيٌّ، فهو مفرد ذو أجزاء، بخلاف العام؛ فإن مدلوله جزئيات متعددة؛ لأنه كُلي كما سبق، والحكم فيه كُلية.
وعن الثاني: (بأنَّ الجمع المنكَّر إنِ اقترن بما يقتضي عمومه كـ "أل" أو "النفي" أو نحوه
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.
(¬2) منهاج الوصول (ص 174) بتحقيقي، جمع الجوامع (2/ 33) مع حاشية العطار.
ص:
800 - أَمَّا الَّذِي يَثْبُتُ لِلْعِلِّيَّه ... فَأَوْجُة نَذْكُرُهَا جَلِيَّه
801 - أَوَّلُهَا: "الْإجَماعُ"، وَالثَّاني لَهَا ... نَصّ صَرِيحٌ، كـ "الِعِلَّةٍ نَهَى"
802 - "لِسَبَبٍ"، "لِأَجْلٍ"، اوْ "مِنْ أَجْلِ" ... وَنَحْوِ "كَيْ"، "إذَنْ"، وَمَا كمِثْلِ
الشرح:
لما فرغت من بيان شروط العلة، شرعتُ في الطرق التي تدل على عليتها، ويُعبر عنها أيضًا بمسالك العلة.
وذلك إما إجماع أو نص أو استنباط. والنص إما صريح أو ظاهر أو إيماء.
فأما الأول وهو الإجماع فإنما قُدِّم لأنه أقوى، قطعيًّا كان أو ظنيًّا، ولأن النص تفاصيله كثيرة.
وبعضهم -كالبيضاوي- يُقدم النص؛ لكونه أصل الإجماع.
والمراد بثبوتها بالإجماع أنْ تجمع الأُمة على أن هذا الحكم عِلته كذا. كإجماعهم في "لا يقضي القاضي وهو غضبان" (¬1) على أنَّ علته شَغْل القَلب. وممن حكى فيه الإجماع القاضي أبو الطيب.
وأما الثاني وهو النص (أي: مِن الكتاب أو السُّنة):
فـ "الصريح" هو: ما وُضع لإفادة التعليل بحيث لا يحتمل غير العِلية؛ ولذلك عَبَّر عنه البيضاوي بِـ "النص القاطع".
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.