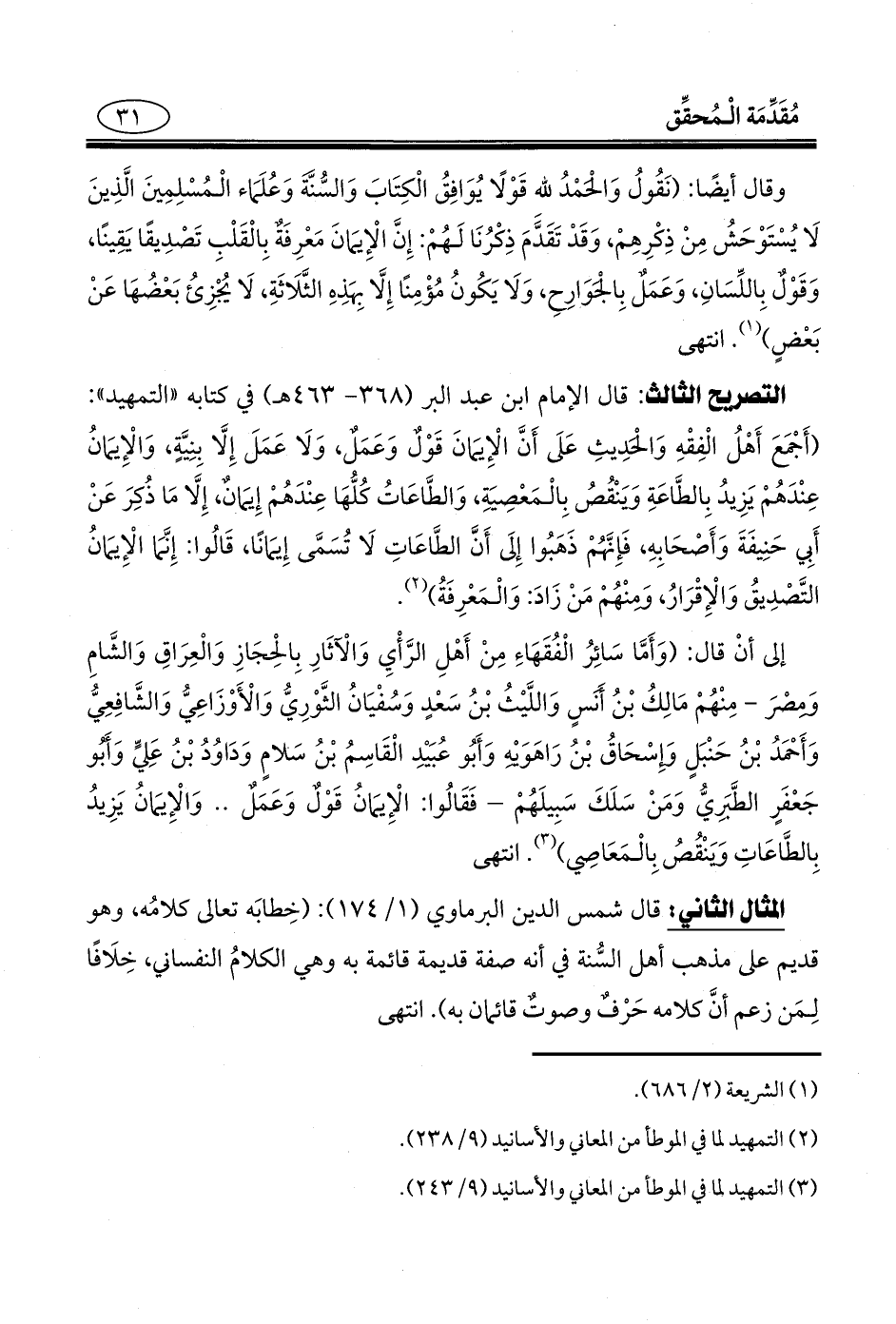
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية
وقال أيضًا: (نَقُوُل وَالْحَمْدُ للهِ قَوْلًا يُوَافِقُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَعُلَمَاء الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ لَا يُسْتَوْحَشُ مِنْ ذِكْرِهِمْ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُمْ: إِنَّ الْإِيمَانَ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ تَصْدِيقًا يَقِينًا، وَقَوْلٌ بِاللِّسَانِ، وَعَمَلٌ بِالجْوَارِحِ، وَلَا يَكُونُ مُؤْمِنًا إِلَّا بِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ، لَا يُجْزِئُ بَعْضُهَا عَنْ بَعْضٍ) (¬1). انتهىالتصريح الثالث: قال الإمام ابن عبد البر (368 - 463 هـ) في كتابه "التمهيد": (أَجْمَعَ أَهْلُ الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الْإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ، وَلَا عَمَلَ إِلَّا بِنِيَّةٍ، وَالْإِيمَانُ عِنْدَهُمْ يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ، وَالطَّاعَاتُ كُلُّهَا عِنْدَهُمْ إِيمَانٌ، إِلَّا مَا ذُكِرَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ، فَإِنَّهُمْ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ الطَّاعَاتِ لَا تُسَمَّى إِيمَانًا، قَالُوا: إِنَّمَا الْإِيمَانُ التَّصْدِيقُ وَالْإِقْرَارُ، وَمِنْهُمْ مَنْ زَادَ: وَالْمَعْرِفَةُ) (¬2).
إلى أنْ قال: (وَأَمَّا سَائِرُ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الرَّأْيِ وَالْآثَارِ بِالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ وَالشَّامِ وَمِصْرَ - مِنْهُمْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ وَأَبُو عُبَيْدِ الْقَاسِمُ بْنُ سَلامٍ وَدَاوُدُ بْنُ عِليٍّ وَأَبُو جَعْفَرٍ الطَّبَرِيُّ وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُمْ - فَقَالُوا: الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ .. وَالْإِيَمانُ يَزِيدُ بِالطَّاعَاتِ وَيَنْقُصُ بِالْمَعَاصِي) (¬3). انتهى
المثال الثاني: قال شمس الدين البرماوي (1/ 174): (خِطابَه تعالى كلامُه، وهو قديم على مذهب أهل السُّنة في أنه صفة قديمة قائمة به وهي الكلامُ النفساني، خِلَافًا لِمَن زعم أنَّ كلامه حَرْفٌ وصوتٌ قائمان به). انتهى
¬__________
(¬1) الشريعة (2/ 686).
(¬2) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (9/ 238).
(¬3) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (9/ 243).
ص:
275 - وَتَثْبُتُ السُّنَّةُ وَالْإجْمَاعُ بِه ... كَذَاكَ بِالْآحَادِ لَيْسَ يَشْتَبِهْ
276 - لكِنْ تَوَاتُرٌ بِسُنَّةٍ يَقِلْ ... بَلْ نَفْيُ غَيْرِ الْمَعْنَوِيْ فِيهَا قُبِلْ
الشرح:
لَمَّا فرغتُ من بيان السند في الدليل الأول وهو الكتاب، شرعتُ في بيانه في الدليلين الآخَرين وهُما السُّنة والإجماع، فذكرتُ أن كُلًّا منهما يكون بالتواتر وبالآحاد، لكن المتواتر في السُّنة قليل حتى إنَّ بعضهم نفاه إذا كان لفظيًّا، وهو أن يتواتر لفظه بعيْنه، لا ما إذا كان معنويًّا، كأن يتواتر معنى في ضمن ألفاظ مختلفة، ولو كان ذلك المعنى [المشترك] (¬1) فيه بطريق اللزوم، ويسمى "التواتر المعنوي"، وسيأتي بيانه.
وقد سبق أن ابن الصلاح قال: (إن المتواتر بِاسْمه الخاص إنما لم يذكره المحدثون لندرته عندهم حتى لا يكاد يوجد) (¬2).
وسبق التعقب عليه في شيء من ذلك.
ثم قال: (ومَن سُئِل عن إبراز مثال لذلك فيما يُروَى من الحديث، أعياه تَطَلُّبه، وحديث: "إنما الأعمال بالنيات" (¬3) ليس من ذلك بسبيل وإنْ نقَله عددُ التواتر وزيادة؛ لأن ذلك طرأ عليه في وسط إسناده، ولم يوجد في أوائله) (¬4).
¬__________
(¬1) في (ز): الشركة.
(¬2) مقدمة ابن الصلاح (ص 267).
(¬3) سبق تخريجه.
(¬4) المرجع السابق.
نعم، كلام ابن الحاجب يقتضي أن هذا مِن شروط المذكور، لكن على معنى أن المذكور صُرح به لرفع الخوف، كقولك لمن يخاف من ترك الصلاة الموَسَّعة في أول الوقت: (تركُها أول الوقت جائز)، ليس مفهومه عدم الجواز في باقي الوقت، وهكذا إلى أن يتضيق كما سبق في المُوَسَّع.
ومنه: أن لا يكون سُكت عنه لكون المخاطَب غير جاهل به، ويمكن جعْل هذا من شروط المذكور، على معنى أن يكون ذِكره لأجل جهالة المخاطَب إياه، بخلاف المسكوت فإنه يَعلمه. كما لو قيل: (صلاة السُّنة فروضها كذا وكذا)، فلا يُقال: مفهومه أن الفرض ليس كذلك؛ لأنَّ ذلك معلوم.
وربما قُدِّر أن المتكلِّم جاهل بحكم المسكوت، وذلك في غير الشارع كما سبق نظيره في الخوف، فيكون التكلِّم - غير الشارع - إنما تَرك حُكم المسكوت جَهْلًا، فظهر للتخصيص بالذِّكر سبب آخَر.
وربما يُدَّعى أن ذلك من شروط المذكور، على معنى أنَّه خُص بالذكر؛ [لِجَهْل] (¬1) حُكم غيرِه.
ومن القسم الثاني: أنْ لا يكون ذُكر لكونه الغالب عادةً، فأما إنْ جَرَى على الغالب فإنه لا يُعتبر مفهومه، كقوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ} [النساء: 23]، فتقييد تحريم الربيبة بكونها في حجره لكونه الغالب، فلا يدل على حِل الربيبة التي ليست في حجره.
قال الماوردي: {فِي حُجُورِكُمْ} أي: في بيوتكم. واختلف الفقهاء في اعتباره، فقال داود: إنه شرط في تحريم الربيبة. ومذهب الشَّافعي وأبي حنيفة وجمهور الفقهاء أنَّها
¬__________
(¬1) في (ص): لجهله.
والوجهان خارجان مما سبق.
أما الأول وهو كون التخصيص السلب عن بعض الأفراد فهو قولهم: (التخصيص إخراج).
وأما الثاني وهو الاحتياج في المراد به خاص للدليل المعنوي فمعناه: الدليل الذي يدل على إرادة الخاص؛ لأنها أمر معنوي، فهو راجع لقولهم: (إن إرادة الخاص فيه سابقة).
ويُعلم أيضًا أن ما قاله تاج الدين السبكي في "شرح البيضاوي" بعد نقل كلام والده أن مقتضَى كلام الشافعي أنه لا فرق بينهما -ممنوع.
فذكر أن الشافعي في "الرسالة" قال في "باب ما نزل عامًّا دلت السُّنة على أنه يُراد به الخاص": (قال الله جل ثناؤه: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} [النساء: 11] إلى قوله: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: 11]، وقال: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} [النساء: 12] إلى قوله: {فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} [النساء: 12]. فأبان أن للوالدين والأزواج ما سُمّي في الحالات وكان عام المَخْرج، فدلت سُنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه إنما أريد به بعض الوالدين والمولودين والأزواج دُون بعض، وذلك أن يكون دِين الوالدين والمولودين والأزواج واحدًا، ولا يكون الوارث قاتلًا ولا مملوكًا). انتهى
قال: (ووقف والدي على ذلك، فذكر أن البحث الذي قرره -أي في الفرق بين النوعين- إنْ صح، احتمل أن يكون ما أورده الشافعي أراد به أن يكون عامًّا مخصوصًا وأنْ يكون مرادًا به الخصوص).
فظاهر كلامه أن والده يُسلِّم ما قاله في فَهم نَص الشافعي، وهو عجيب.
فقد عرفت من كلام ابن دقيق العيد وغيره أن العام المخصوص أُريدَ به خاص بالإخراج، لا في الابتداء، وأن مِن هذه الجهة يكون العام المخصوص أَعَم من العام الذي
بحيث تَسْلم العِلة.
مثال الوصف المناسب الذي استخرجه القائس مِن الأصل وجعله علة للحكم: "الإسكار" في قياس النبيذ على الخمر في التحريم، و"القتل العَمْد المحض العدوان" في القصاص، ونحو ذلك مما استنبطه الأئمة بالنظر والاجتهاد.
وهذا هو الذي عَظُم فيه الخلاف بين العلماء، فأهل الظاهر ينكرونه، ومقالتهم في غاية الضعف، حتى أن أصحابها انحطوا بها عن درجة الاعتبار؛ لجمودهم وقصُور أفهامهم عن معاني الشريعة ودقائقها اللطيفة. والله أعلم.
ص:
819 - فَإنْ يَكُنْ خَفِيًّا اوْ لَمْ يَنْضَبِطْ ... عَلِّلْ بِلَازِمٍ لِذَاكَ مُنْضَبِطْ
820 - كَسَفَرٍ مَظِنَّةِ الْمَشَقَّةِ ... وَالْوَطْءِ لِلشَّغْلِ الَّذِي في الْعِدَّةِ
الشرح:
اكتفيتُ بالتنبيه هنا على حُكم ما لو كان الوصف خفيًّا أو غير منضبطٍ عن جعل عدم ذلك شرطا في الوصف المناسب. فلم أَقُل هناك: (أنْ يكون وصفًا ظاهرًا منضبطًا) كما قال ابن الحاجب في تصريحه به. ثم إنه بعد ذلك ذكر ما تحرز به عنه، فقال: (فإنْ كان المذكور خفيًّا أو غير منضبط اعتُبِرَ مُلازمُه وهو المظنة). أي: وهي الوصف الظاهر المنضبط. فيجعل هو العلة يوجد المعلول بوجوده ويُعْدَم بعدمه سواء كانت الملازمة عقلية أم لا.
وإنما لم نعتبره لأنه غير معلوم؛ لكونه خفيًّا أو لكونه غير منضبط. فإذا لم يُعْرَف في نفسه فكيف يُعرِّف غيره؟ ! وهو معنى تعليل ابن الحاجب ذلك بقوله: (لأنَّ الغَيْبَ لا يُعَرِّف