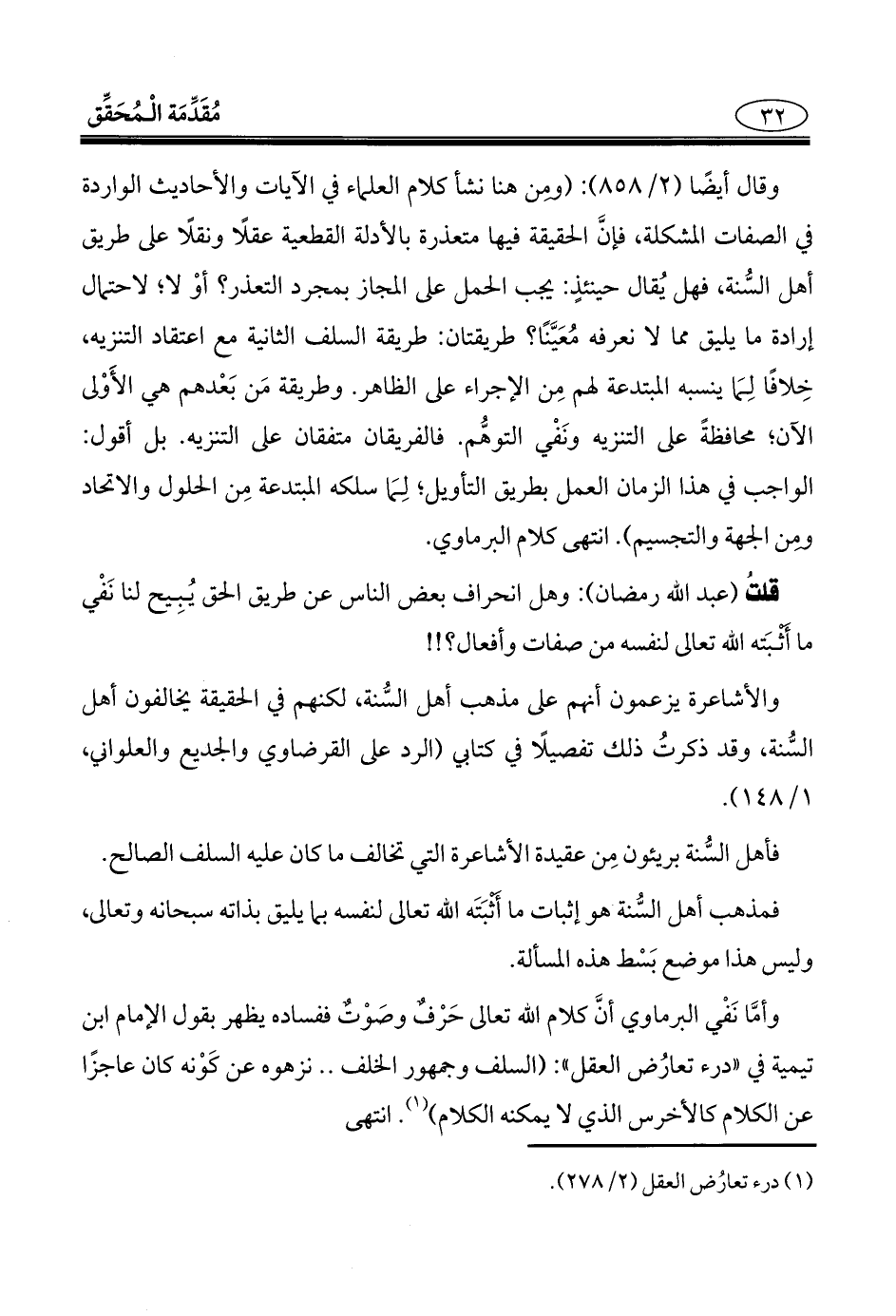
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية
وقال أيضًا (2/ 858): (ومن هنا نشأ كلام العلماء في الآيات والأحاديث الواردة في الصفات المشكلة، فإنَّ الحقيقة فيها متعذرة بالأدلة القطعية عقلًا ونقلًا على طريق أهل السُّنة، فهل يُقال حينئذٍ: يجب الحمل على المجاز بمجرد التعذر؟ أوْ لا؛ لاحتمال إرادة ما يليق مما لا نعرفه مُعَيَّنًا؟ طريقتان: طريقة السلف الثانية مع اعتقاد التنزيه، خِلافًا لِما ينسبه المبتدعة لهم مِن الإجراء على الظاهر. وطريقة مَن بَعْدهم هي الأَوْلى الآن؛ محافظةً على التنزيه ونَفْي التوهُّم. فالفريقان متفقان على التنزيه. بل أقول: الواجب في هذا الزمان العمل بطريق التأويل؛ لِمَا سلكه المبتدعة مِن الحلول والاتحاد ومِن الجهة والتجسيم). انتهى كلام البرماوي.قلتُ (عبد الله رمضان): وهل انحراف بعض الناس عن طريق الحق يُبِيح لنا نَفْي ما أَثْبَته الله تعالى لنفسه من صفات وأفعال؟ ! !
والأشاعرة يزعمون أنهم على مذهب أهل السُّنة، لكنهم في الحقيقة يخالفون أهل السُّنة، وقد ذكرتُ ذلك تفصيلًا في كتابي (الرد على القرضاوي والجديع والعلواني، 1/ 148).
فأهل السُّنة بريئون مِن عقيدة الأشاعرة التي تخالف ما كان عليه السلف الصالح.
فمذهب أهل السُّنة هو إثبات ما أَثْبَتَه الله تعالى لنفسه بما يليق بذاته سبحانه وتعالى، وليس هذا موضع بَسْط هذه المسألة.
وأمَّا نَفْي البرماوي أنَّ كلام الله تعالى حَرْفٌ وصَوْتٌ ففساده يظهر بقول الإمام ابن تيمية في "درء تعارُض العقل": (السلف وجمهور الخلف .. نزهوه عن كَوْنه كان عاجزًا عن الكلام كالأخرس الذي لا يمكنه الكلام) (¬1). انتهى
¬__________
(¬1) درء تعارُض العقل (2/ 278).
يشير بذلك إلى أنه لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر - رضي الله عنه -، ولا عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولا عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولا عن محمد إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم اشتهر، فرواه عنه خلْقٌ كثير، قيل: سبعمائة. وقيل غير ذلك، وتَواتَر حتى الآن.
نعم، تُعُقِّب عليه بأنه قد رواه نحو العشرين صحابيًّا، وأنه قد تُوبع الثلاثة الذين بعد عمر.
وجوابه: أن ما ذُكر من ذلك إنما هو بمعنى "الأعمال بالنية"، لا بلفظِه، والكلام إنما هو في المتواتر لفظًا لا معنًى، وأن [المتابعات] (¬1) الواقعة لا تنتهي إلى حد التواتر.
ثم قال ابن الصلاح: (نعم، حديث: "مَن كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار" (¬2) نراه مثالًا لذلك؛ فإنه نقله من الصحابة - رضي الله عنه - العددُ الجمُّ) (¬3). إلى آخِر ما ذكره.
وقد تُعُقب عليه بوصف غيره من الأئمة عِدة أحاديث بأنها متواترة:
كحديث ذكر حوض النبي - صلى الله عليه وسلم -، أورد البيهقي في كتاب "البعث والنشور" روايته عن أزيد من ثلاثين صحابيًّا، وأفرده المقدسي بالجمع. قال القاضي عياض: وحديثه متواتر بالنقل.
وحديث الشفاعة، قال القاضي عياض: بلغ التواتر.
وحديث المسح على الخفين، قال ابن عبد البر: رواه نحو أربعين صحابيًّا، واستفاض وتواتر.
¬__________
(¬1) كذا في (ز، ش، ص). لكن في (ق، ظ، ت): المتتابعات.
(¬2) صحيح البخاري (رقم: 107)، صحيح مسلم (رقم: 4).
(¬3) مقدمة ابن الصلاح (ص 269).
لكنه أجاب في "أماليه" بأنَّ المفهوم إنما قُلنا به لخلو القيد عن الفائدة لولاه، أما إذا كان الغالب وقوعه: فإذا نُطق باللفظ أوَّلًا، فُهم القيد لأجل غَلَبته، فذِكره بعد يكون تأكيدًا للحُكم المتصف بذلك القيد. فهذه فائدة أمكن اعتبار القيد فيها، فلا حاجة إلى المفهوم، بخلاف غير الغالب.
واعْلَم أن ابن دقيق العيد في "شرح العنوان" بعد أنْ نصر مقالة الجمهور قال: (يشكل على الشَّافعي في قوله: "في سائمة الغنم الزكاة" (¬1)، فإنه قال فيه بالمفهوم وأسقط الزكاة في المعلوفة مع أن الغالب والعادة السوم، فمقتضَى هذه القاعدة أن لا يكون لهذا التخصيص مفهوم).
انتهى وهذا السؤال ذكره القفال الشاشي وأجاب عنه بما حاصله أن اشتراط السوم لم يَقُل به الشَّافعي مِن جهة المفهوم، بل مِن جهة أن قاعدة الشرع أن لا زكاة فيما أُعِد للبذلة، وإنَّما تجب في الأموال النامية، فعُلم مِن ذلك اعتبار السوم.
نعم، قصد القفال بذلك إبطال المفهوم بالكُلية، ولكنه مردود، وسيأتي مِن نَص الشَّافعي ما يدل على أنَّه إنما أوجب في السائمة دُون المعلوفة تَعلُّقًا بما في الحديث مِن القيد.
ومنه: أن لا يكون المذكور خارجًا لجواب سؤال عنه، مِثل أن يُسأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هل في الغنم السائمة زكاة؟ "، فلا يَلزم مِن جواب السؤال عن إحدى الصفتين أن يكون الحكم على الضد في الأخرى؛ لظهور فائدة في الذِّكر غير الحكم بالضد.
ومنه أيضًا: أن لا يكون خرج لبيان حكم حادثة اقتضت بيان الحكم في المذكور، كما لو قيل بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لزيد غنم سائمة"، فقال: "في السائمة الزكاة"، إذِ القصد الحكم على تلك الحادثة، لا النفي عمَّا عداه.
¬__________
(¬1) سبق الكلام عليه.
أريدَ به خاص.
فمعنى قول الشافعي: (دَلَّت السُّنة على أنه يُراد به الخاص) أنه سلب الحكم عن بعض الأفراد وبقي الحكم في الباقي؛ بدليل إيرادِه في ترجمة الباب، فالإرادة التي عناهَا إرادة الحكم، لا إرادة دلالة اللفظ وإطلاقه على الخاص.
ومن هنا يُعلم أنَّ قول الأصوليين: (إنَّ الخاص يُقضَى به على العام، تَقدَّم أو تَأَخر أو جُهِل أو قارَن) لا يُنافي ما سبق في الفرق بين العام المخصوص والمراد به الخصوص؛ لأن الإرادة في الثاني سابقة على العام، وفي الأول متأخِّرة أو مقارِنة؛ لأن إرادة الإطلاق غير إرادة السلب عن البعض، فلا يَضُر كَوْن إرادة السلب دليلها سابقًا.
ثم ذكر القاضي تاج الدين أن العام الذي يُراد عمومُه ضربان: ما أفراده كلها مُرادة، وما أُريدَ غالب أفراده ولكن نزل الغالب منزلة الكل. وأن الشافعي في "الرسالة" مثَّل للأول بقوله تعالى: {وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء: 176] وبقوله تعالى: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} [الرعد: 16]، بناءً على أنه ليس مما خُص بالعقل، بل دَلَّ العقل أنه لم يدخل أصلًا، فالعموم فيه مراد.
ومَثَّل [للثاني] (¬1) بقوله تعالى: {رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا} [النساء: 75]، فإنَّ مِن المعلوم أن فيها غَيْر الظالم، ولكن لِقِلَّتهم جُعلوا كالعدم (¬2). انتهى
وهذا يقتضي أنَّ لنا قِسمًا ثالثًا -في قَصْر اللفظ على بعض الأفراد- غير العام المخصوص والعام المراد به الخصوص؛ لأن الثاني إنما يكون إذا أطلق على الأقل كما سبق في كلام الشيخ أبي حامد والماوردي، والأول إنما يكون حيث لم يُرَد إطلاق اللفظ وإرادة بعض
¬__________
(¬1) كذا في (ص)، لكن في (ق، س): الثاني.
(¬2) انظر: الإبهاج (2/ 134).
الغيب). وذلك كالسفر لعدم انضباط المشقة التي هي المعنى المناسب لترتُّب [الترخص] (¬1) عليه، فيناط الترخص بِمُلازِمها وهو السفر.
ومثال إقامة المظنة مقام المناسب عند خفائه: شغل الرحم المناسب للعدة؛ حفظًا للنسب، لَمَّا لم ينضبط، أُنِيطَ بالوطء الذي هو وصف ظاهر منضبط، حتى لو تحققت البراءة لرحمها، تَعْتَد.
قال الغزالي في "الوسيط" في "أول العدد": (ومقصود هذه العدة براءة الرحم، ولكن يُكتفى بسبب الشغل ولا يُشترط عينه؛ لأنَّ ذلك خفي لا يُطَّلَع عليه؛ فلذلك تجب العِدة بوطء الصبي بمجرد تغييب الحشفة. وحيث علق طلاقها بيقين براءة الرحم. ومن دَأْب الشرع في مظان التباس المعاني المقصودة رَبْط الأحكام بالأسباب الظاهرة، كما علق البلوغ بالاحتلام والسن؛ لخفاء العقل. وعلق الإسلام بكلمتي الشهادة مع الإكراه؛ لخفاء العقيدة). انتهى
وهو معنى قولي: (وَالْوَطْءِ لِلشَّغْلِ الَّذِي في الْعِدَّةِ). والله أعلم.
ص:
821 - ثُمَّ: الْمُنَاسِبُ الَّذِي تَقَدَّمَا ... هُوَ ضَرُورِيٌّ، فَحَاجِيٌّ، فَمَا
822 - بَعْدَهُمَا يُعْرَفُ بِـ "التَّحْسِيني" ... فَأَوَّلٌ مِنْهَا [لِحِفْظِ] (¬2) الدِّينِ
823 - فَالنَّفْسِ، فَالْعَقْلِ، فَبَعْدَهُ النَّسَبْ ... فَالْمَالُ، فَالْعِرْضُ، فَحَقِّقِ الرُّتَبْ
الشرح:
لما ذكرت في تعريف "المناسب" أنه الملائم لفعل ذوى العقول وفي معنى ذلك
¬__________
(¬1) كذا في (ص، ق)، لكن في (س): (الرخص). وكذلك كلمة (الترخص) التالية.
(¬2) في (س، ت): كحفظ.