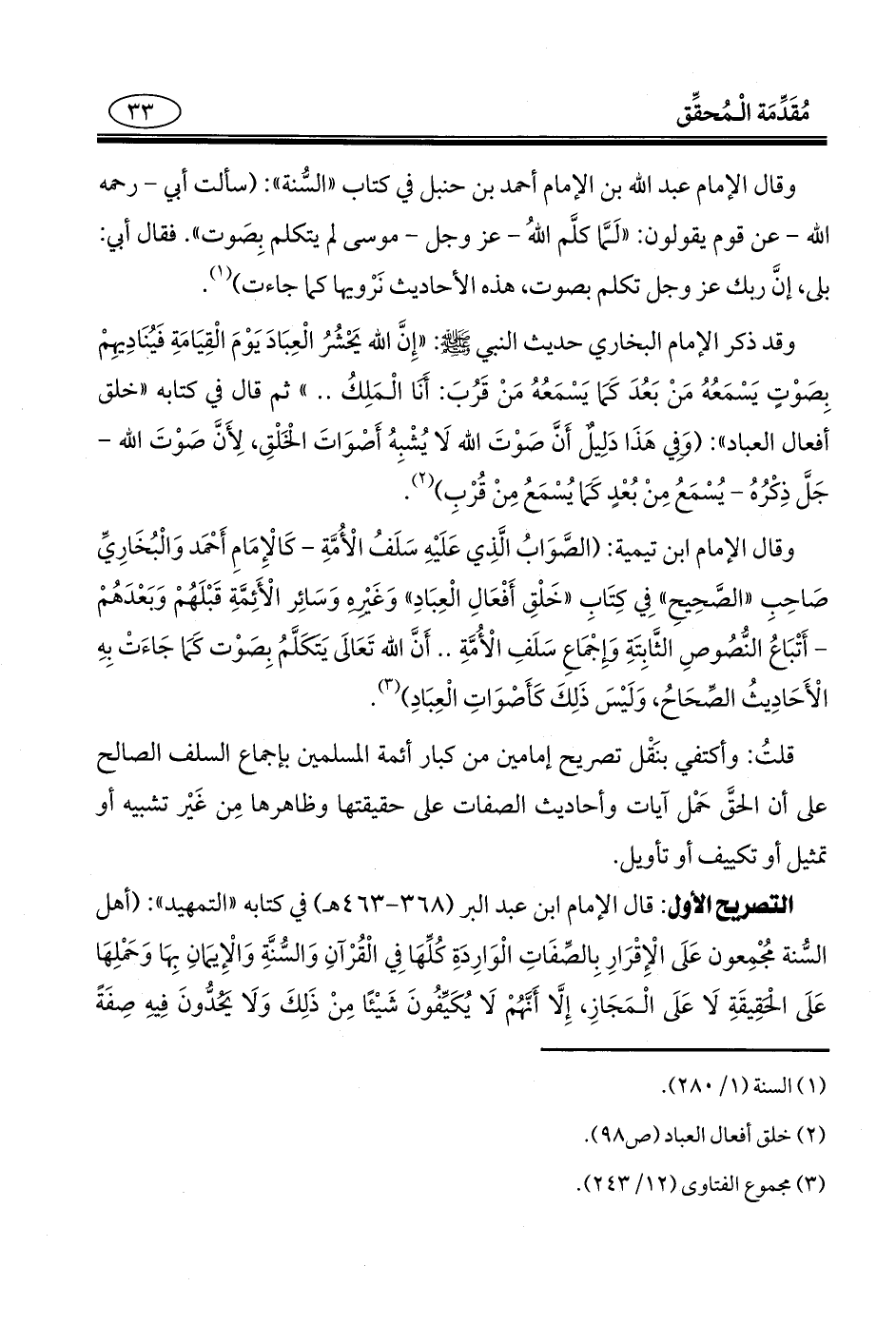
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية
وقال الإمام عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل في كتاب "السُّنة": (سألت أبي - رحمه الله - عن قوم يقولون: "لَمَّا كلَّم اللهُ - عز وجل - موسى لم يتكلم بِصَوت". فقال أبي: بلى، إنَّ ربك عز وجل تكلم بصوت، هذه الأحاديث نَرْويها كما جاءت) (¬1).وقد ذكر الإمام البخاري حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الله يَحْشُرُ الْعِبَادَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ: أَنَا الْمَلِكُ .. " ثم قال في كتابه "خلق أفعال العباد": (وَفي هَذَا دَلِيلٌ أَنَّ صَوْتَ الله لَا يُشْبِهُ أَصْوَاتَ الْخَلْقِ، لِأَنَّ صَوْتَ الله - جَلَّ ذِكْرُهُ - يُسْمَعُ مِنْ بُعْدٍ كَمَا يُسْمَعُ مِنْ قُرْبِ) (¬2).
وقال الإمام ابن تيمية: (الصَّوَابُ الَّذِي عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ - كَالْإِمَامِ أَحْمَد وَالْبُخَارِيِّ صَاحِبِ "الصَّحِيحِ" فِي كِتَابِ "خَلْقِ أَفْعَالِ الْعِبَادِ" وَغَيْرِهِ وَسَائِر الْأَئِمَّةِ قَبْلَهُمْ وَبَعْدَهُمْ - أَتْبَاعُ النُّصُوصِ الثَّابِتَةِ وَإِجْمَاعِ سَلَفِ الْأُمَّةِ .. أَنَّ الله تَعَالَى يَتكَلَّمُ بِصَوْت كَمَا جَاءَتْ بِهِ الْأَحَادِيثُ الصِّحَاحُ، وَلَيْسَ ذَلِكَ كَأَصْوَاتِ الْعِبَادِ) (¬3).
قلتُ: وأكتفي بنَقْل تصريح إمامين من كبار أئمة المسلمين بإجماع السلف الصالح على أن الحقَّ حَمْل آيات وأحاديث الصفات على حقيقتها وظاهرها مِن غَيْر تشبيه أو تمثيل أو تكييف أو تأويل.
التصريح الأول: قال الإمام ابن عبد البر (368 - 463 هـ) في كتابه "التمهيد": (أهل السُّنة مُجْمِعون عَلَى الْإِقْرَارِ بِالصِّفَاتِ الْوَارِدَةِ كُلِّهَا فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِيمَانِ بِهَا وَحَمْلِهَا عَلَى الْحَقِيقَةِ لَا عَلَى الْمَجَازِ، إِلَّا أَنَّهُمْ لَا يُكَيِّفُونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَلَا يَحُدُّونَ فِيهِ صِفَةً
¬__________
(¬1) السنة (1/ 280).
(¬2) خلق أفعال العباد (ص 98).
(¬3) مجموع الفتاوى (12/ 243).
وقال ابن حزم في "المحلى": (نقل تواتر يوجب العلم) (¬1).
قال: (ومن ذلك أحاديث النهي عن الصلاة في [معاطن] (¬2) الإبل، وحديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد وحديث قول المصلِّي: "ربنا ولك الحمد") إلى آخِره.
وجواب ذلك: يحتمل أنَّ مراد قائل ذلك بِـ"المتواتر" إنما هو المشهور، كما يعبر به كثيرا عنه، أو أنها متواترة معنًى، أو غير ذلك، وإلا فالواقع [فقْدان] (¬3) شرط التواتر في بعض طبقاتها. وإلى هذا أشرت بقولي: (بَلْ نَفْيُ غَيْرِ الْمَعْنَوِيْ فِيهَا قُبِلْ).
وأما الإجماع فنقله بالتواتر كثير. نعم، وقع خلاف في أصل الإجماع إذا قُلنا بإمكان تصوُّره: هل يمكن معرفته والاطِّلاع عليه؟ فأثبته الأكثرون كما قاله الآمدي، ونفاه الأقلُّون، ومنهم أحمد بن حنبل، في إحدى الروايتين عنه أنَّ مُدَّعي الإجماع كاذب.
ولكنه محمول على:
- الاستبعاد، أيْ: يَبعد مع كثرة العلماء وتفرقهم في البلاد النائية أنْ يَعرف الناقل عنهم اتفاقَ معتقداتهم مع إمكان أن يكون قوله أو فعله المنقول عنه مخالفًا لمعتقده؛ لغرضٍ ما. وبتقدير تسليمه فقدْ يرجع عنه قبل الوصول للباقين، فالورَع أنْ لا يُنقل؛ [لذلك] (¬4)، ولأنه قد يكون ثَم مخالف لم يُطَّلَع عليه.
- أو أنه قال ذلك في حَق مَن ليس له معرفة بخلاف السلف؛ لأن أحمد قد أطلق القول بصحة الإجماع في مواضع كثيرة.
¬__________
(¬1) المحلى (2/ 83).
(¬2) في (ز): مواطن.
(¬3) في (ش): فقد.
(¬4) في (ق، ت): كذلك.
ومن هذا قوله تعالى: {لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً} [آل عمران: 130] فإنه وَرَد على ما كانوا يتعاطونه في الآجال أنَّه إذا حَلَّ الدَّين، يقول للمديون: (إما أن تعطي وإما أن تزيد في الدَّين)؛ فيتضاعف بذلك مضاعفة كثيرة.
وهنا سؤال: وهو أنَّه لمَ جعلوا هنا السؤال والحادثة قرينة صارفة عن القول بضد الحكم في المسكوت ولم يجعلوَا ذلك في ورود العام على سؤال أو حادثة صارفًا له عن عمومه على الأرجح؟ بل لم يُجْروا هنا ما أَجْروه هناك من الخلاف في أن العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب وإنْ كان ابن تيمية في "المسودة" حكى عن القاضي أبي يعلى وأصحابهم فيه احتمالين.
وقد يُجاب بأنَّ المفهوم لَمَّا ضَعُف عن المنطوق في الدلالة، اندفع بذلك ونَحْوِه، وقوة اللفظ في العام تخالف ذلك، حتَّى إنَّ الحنفية ادَّعوا أن دلالة العام على كل فردٍ من أفراده قطعية كما سيأتي في موضعه؛ فلَم يندفع بذلك (على الطريقة الراجحة).
قولي: (وَنَحْوِهِ مِنْ مُقْتَضِي) إلى آخِره - إشارة إلى أن احتمال وجود فائدة للتخصيص بالذكر يُحال الأمر عليها حتَّى لا يُعمل بالمفهوم - ليس منحصرًا فيما ذُكِر، بل كل ما وُجِد له فائدة يمكن الإحالة عليها يمتنع العمل به؛ ولهذا ذكر البيضاوي عبارة شاملة للصُّوَر كلها، وهي: أنْ لا تظهر لتخصيص المنطوق بالذِّكْر فائدة غَيْر نَفْي الحكم عن المسكوت (¬1).
فمِن الفوائد أيضًا: أنْ لا يكون عَهْدٌ، فإنْ كان فهو بمنزلة الاسم اللقب الذي يُحتاج إليه في التعريف، فلا يدل على نَفْي الحكم عمَّا عداه.
ومنها: أن لا يُقْصَد بذكره زيادة الامتنان على المسكوت، كقوله تعالى: {لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا} [النحل: 14]، فلا يدل على منع القديد.
¬__________
(¬1) منهاج الوصول (ص 162) بتحقيقي.
الأفراد، وهذا أريد به بعض الأفراد وإنْ كانت هي الأكثر.
وأما المسألة الثالثة:
وهي أن دلالة العام بعد تخصيصه على باقي الأفراد هل هو حقيقة؟ أو مجاز؟
فيه مذاهب:
أحدها وهو المختار وعليه جريتُ في النَّظم: أنه حقيقة مطلقًا بأيِّ تخصيص خُصِّص. فقد قال الشيخ أبو حامد: (إنه مذهب الشافعي وأصحابه، وهو قول مالك وجماعة من أصحاب أبي حنيفة). انتهى
وذلك لأن الواضع لما وضعه للجميع وخرج بعض الأفراد من الحكم بدليل، لم تتأثر دلالة اللفظ على الباقي حقيقةً كما كانت كذلك.
وجزم بأنه حقيقة أيضًا القاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق وابن الصباغ وسليم، ونقله ابن برهان في "الوجيز" عن أكثر علمائنا، وقال إمام الحرمين في "التلخيص" وابن القشيري: إنه مذهب جماهير الفقهاء. ونقله الغزالي في "المنخول" عن الشافعي، ونقله ابن الحاجب عن الحنابلة، ورجحه الشيخ تقي الدين السبكي وغيره من المتأخرين.
الثاني: أنه مجاز مطلقًا، ونقله الإمام الرازي عن جمهور أصحابنا والمعتزلة كأبي علي وابنه، ونقله الشيخ أبو حامد وسليم عن المعتزلة بأسرها، واختاره البيضاوي وابن الحاجب والهندي. وفي "الأوسط" لابن برهان: إنه المذهب الصحيح. ونسبه إلْكِيَا للمحققين، ونقله في "المنخول" عن القاضي أبي بكر، وممن جزم به من الحنفية: الدبوسي والسرخسي والبزدوي، وحكوه عن اختيار العراقيين من الحنفية.
وحُكي عن الأشعري، لكن فيه نظر مِن وجهين كما قاله الشيخ أبو حامد:
أحدهما: أن الصِّيَغ عنده مشتركة بين العموم والخصوص، فإذا دَلَّ دليل على أنه
ما نقلته في الشرح من التعاريف، بينتُ هنا ما أشير إليه في جميع ذلك من وجه الملائمة والمناسبة أنها لا تخلو عن ثلاثة أمور مرتبة في الملائمة: الضروري، ثم الحاجي، ثم التحسيني؛ لأنها إما في محل الضرورة أو في محل الحاجة أو لا في محلهما ولكن في محل الاستحسان في مطرد العادات.
فأما "الضروري": فهو الذي يكون في محل ضرورة العباد لا بُدَّ منه، وذلك خمسة أنواع، وهي المقاصد التي اتفق الملل في حفظها، وهي: الدِّين، فالنفْس، فالعقل، فالمال، فالنَّسَب.
فحِفظ الدِّين بقتال الكفار، قال تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} [التوبة: 29]، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله" (¬1)، وقال: "مَن بَدَّل دِينه فاقتلوه" (¬2).
وحِفظ النفس بمشروعية القصاص، قال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} [البقرة 179].
وحِفظ العقل بتحريم المسكرات ونحوها، قال تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَا} [المائدة: 91] الآية.
وحِفظ المال بقطع السارق وتضمينه وتضمين الغاصب، قال تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] وقال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188].
والنَّسب بوجوب حَد الزاني، قال تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا} [النور: 2] الآية.
وقد أشير إلى خمسة بقوله تعالى: {لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.
(¬2) سبق تخريجه.