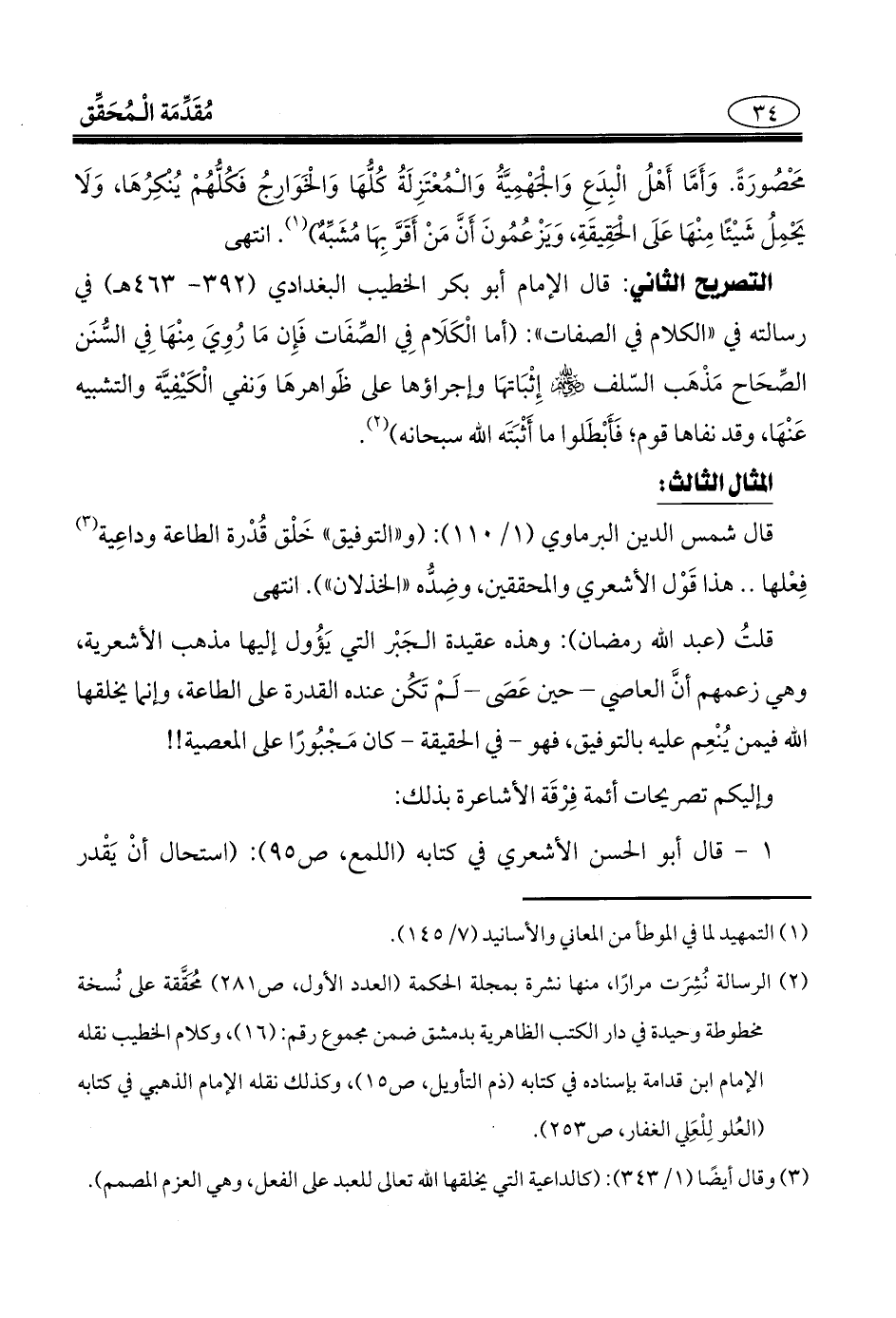
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية
مَحْصُورَةً. وَأَمَّا أَهْلُ الْبِدَعِ وَالْجَهْمِيَّةُ وَالْمُعْتَزِلَةُ كُلُّهَا وَالْخَوَارِجُ فَكُلُّهُمْ يُنْكِرُهَا، وَلَا يَحْمِلُ شَيْئًا مِنْهَا عَلَى الْحَقِيقَةِ، وَيَزْعُمُونَ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِهَا مُشَبِّهٌ) (¬1). انتهىالتصريح الثاني: قال الإمام أبو بكر الخطيب البغدادي (392 - 463 هـ) في رسالته في "الكلام في الصفات": (أما الْكَلَام فِي الصِّفَات فَإِن مَا رُوِيَ مِنْهَا فِي السُّنَن الصِّحَاح مَذْهَب السّلف - رضي الله عنهم - إِثْبَاتهَا وإجراؤها على ظَواهرهَا وَنفي الْكَيْفِيَّة والتشبيه عَنْهَا، وقد نفاها قوم؛ فَأَبْطَلوا ما أَثْبَتَه الله سبحانه) (¬2).
المثال الثالث:
قال شمس الدين البرماوي (1/ 110): (و"التوفيق" خَلْق قُدْرة الطاعة وداعِية (¬3) فِعْلها .. هذا قَوْل الأشعري والمحققين، وضِدُّه "الخذلان"). انتهى
قلتُ (عبد الله رمضان): وهذه عقيدة الجَبْر التي يَؤُول إليها مذهب الأشعرية، وهي زعمهم أنَّ العاصي - حين عَصَى - لَمْ تَكُن عنده القدرة على الطاعة، وإنما يخلقها الله فيمن يُنْعِم عليه بالتوفيق، فهو - في الحقيقة - كان مَجْبُورًا على المعصية! !
وإليكم تصريحات أئمة فِرْقَة الأشاعرة بذلك:
1 - قال أبو الحسن الأشعري في كتابه (اللمع، ص 95): (استحال أنْ يَقْدر
¬__________
(¬1) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (7/ 145).
(¬2) الرسالة نُشِرَت مرارًا، منها نشرة بمجلة الحكمة (العدد الأول، ص 281) مُحَقَّقة على نُسخة مخطوطة وحيدة في دار الكتب الظاهرية بدمشق ضمن مجموع رقم: (16)، وكلام الخطيب نقله الإمام ابن قدامة بإسناده في كتابه (ذم التأويل، ص 15)، وكذلك نقله الإمام الذهبي في كتابه (العُلو لِلْعَلِي الغفار، ص 253).
(¬3) وقال أيضًا (1/ 343): (كالداعية التي يخلقها الله تعالى للعبد على الفعل، وهي العزم المصمم).
- وحمل ابن تيمية قوله ذلك على إجماع غير الصحابة؛ لانتشارهم، أما الصحابة فمعروفون محصورون.
ونقل ابن الحاجب أنَّ المانع احتج بأن نقْله مستحيل عادةً؛ لأن الآحاد لا يفيد العِلم بوقوعه، وهو قطعي لا بُدَّ له من سندٍ قطعي، والتواتر بعيد.
وأجاب عن ذلك بالوقوع؛ فإنَّا قاطعون [بتواتر النقل] (¬1) عن إجماع الأُمة على تقديم النَّص القاطع على الظن.
ولم يتعرض لِرد أن الآحاد لا يفيد، ولكنه مردودٌ بأنَّ قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفِعله أقوى منه، ومع ذلك يثبت بالآحاد ويجب العمل به.
قال الماوردي: وليس آكد من سُنن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وهي تثبت بقول الواحد.
وجرى على هذا أيضًا إمام الحرمين والآمدي وإنْ نقل عن الجمهور اشتراط نقله بالتواتر.
ومنهم مَن فرَّع المنع على كون الإجماع حُجة قطعية، ونقل ذلك عن الجمهور. وقال القاضي في "التقريب": إنه الصحيح.
ولكن لا يلزم؛ فإنه وإنْ كان قطعيًّا في نفسه لكن طريق وصوله قد تكون ظنية؛ بدليل السُّنة كما قررناه.
وذهب جَمعٌ من الفقهاء إلى ثبوته بالآحاد بالنسبة إلى العمل خاصة، لكن لا يرفع به قاطع، ولا يعارضه.
¬__________
(¬1) في (ز): بنقل التواتر.
ومنها: أن لا يخرج مخرج التفخيم والتأكيد، كحديث: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخِر أن تحد على ميت" (¬1) الحديث، فَقَيْد "الإيمان" لِلتفخيم في الأمر وأن هذا لا يليق بمن كان مؤمنًا.
ومما يذكر مِن شروط العمل بالمفهوم أن لا يعود على الأصل - الذي هو المنطوق فيه - بالإبطال، كحديث: "لا تَبع ما ليس عندك" (¬2). لا يُقال: مفهومه صحة بيع الغائب إذا كان عنده " إذْ لو صَحَّ فيه لَصَحَّ في المذكور وهو الغائب الذي ليس عنده، لأن المعنى في الأمرين واحد، ولم يُفَرق أحدٌ بينهما.
وقد ذُكِرتْ لشروط أخرى غير مما سبق وصُوَر من الفائدة يحتمل رجوعها إلى ما سبق، وفَهْمُها منه، ولا حاجة إلى التطويل بها بَعْد تَقَرُّر الضابط بما سبق.
قولي: (لَا يَقْتَضِي) أي: لا يقتضي العمل بالمفهوم، أي: إن هذه الأمور تقتضي تخصيص المذكور بالذِّكْر، لا نَفْي الحكم عن غيره.
ولكن وراء هذا بحث آخَر، وهو أن المقترِن مِن المفاهيم بما يمنع القول به لوجود فائدة تقتضي التخصيص في المذكور بالذكر كما سبق شرحه:
هل يدل اقترانه بذلك على إلغائه وجعله كالعدم؛ فيصير المعروض [لقيد] (¬3) المفاهيم - إذا كان فيه لفظ عموم - شاملًا للمذكور والمسكوت حتَّى لا يجوز قياس المسكوت بالمذكور بِعِلَّة جامعة، لأنه منصوص، فلا حاجة لإثباته بالقياس؟
أوْ لا يدل، بل غايته الحكم على المذكور وأما غير المذكور فمسكوت عن حُكمه؛ فيجوز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (رقم: 1221)، صحيح مسلم (رقم: 1491).
(¬2) سبق تخريجه.
(¬3) في (ز) كأنها: بقيد. وفي سائر النسخ: لقيد.
للخصوص، كان استعماله فيه حقيقةً.
والثاني: أنه يحتج به فيما بقي بمجرده، فلو كان مجازًا، لم يحتج به إلا بقرينة.
احتُج لهذا المذهب بأنه حقيقة في الاستغراق، فلو كان حقيقة في الباقي بعد التخصيص، للزم الاشتراك، والمجاز خير منه.
وجوابه: أن الكُلي دلالته على كل جزئياته وبعضها سواء، إذ لا يُقال: دلالة إنسان على كل أفراده حقيقة وعَلَى زيد مجاز.
الثالث: أن له جهتين:
إحداهما: مِن حيث تناول اللفظ له بعد التخصيص كما كان قبله، فهو حقيقة.
والثانية: من حيث الاقتصار عليه دون ما خرج بالتخصيص، فهو مجاز.
كأنه جَمعْ بين القولين السابقين، وتحقيق المناط فيهما. وهو اختيار إمام الحرمين كما نص عليه في "البرهان".
وقال ابن القشيري والمقترح في تعليقه على "البرهان": (إنه معنى كلام القاضي).
وفيما قالاه نظر؛ فإنَّ القاضي أورده سؤالًا على نفسه، ثم أجاب عنه بأن هذا التفصيل ساقط، وذكر ما حاصله أن اللفظ إنما يكون حقيقة إذا كان الباقي منضمًّا مع الذي خرج، فبَعْد خروجه لا يبقى حقيقة، بل يجب أن يكون مجازًا، لاسيما إذا كان العام صيغة جمع وبقي بعد التخصيص واحد، فإنه مجاز وفاقًا.
وحاول ابن القشيري التوفيق بين كلام القاضي والإمام وأن كُلًّا منهما حق من وجه بما يَؤُول الأمر به إلى ما قاله إمام الحرمين من أنه حقيقة ومجاز باعتبارين.
ومنهم مَن حمل القول بكونه مجازًا على أنه أراد من حيث اللغة، والقول بكونه حقيقة من حيث الشرع، فلم يتواردَا على محل واحد.
يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ} [الممتحنة: 12]. أربعة مِن الخمسة التي ذكرت، إذْ لا تَعَرُّض فيه لحفظ العقول، وواحد آخَر تصير به المقاصد ستة وهو العِرْض.
وفي "الصحيحين " أنه - صلى الله عليه وسلم - قال في خطبته في حجة الوداع: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام" (¬1) الحديث.
والأخبار فيه كثيرة وأحكام حِفظه شهيرة في الشرع، فهو من الضروريات المعلومة من الدِّين، وحِفظه بحد القذف.
أما [مرتبته] (¬2) فيحتمل أن يكون في رُتبة الأموال، فيكون مِن أدنى الكليات، فإن [ترتيبها] (¬3) كما ذكرناه متعاطفة بـ "الفاء". ويحتمل أنْ لا يُجعل مِن الكليات، فيكون ملحقًا بها، ويحتمل أن يفصل في ذلك.
قيل: وهو الظاهر، لأنَّ الأعراض تتفاوت، فمنها ما هو من الكُليات وهي الأنساب، وهي أرفع مِن الأموال؛ فإن حِفظ النسب بتحريم الزنا تارة وبتحريم القذف المؤدِّي إلى الشك في أنساب الخلْق وبسبتهم إلى غير آبائهم تارة. وتحريم الأنساب مُقدَّم على الأموال.
ومنها ما هو دونها، وهو ما يكون مِن الأعراض غير الأنساب.
وبالجملة فلا ينبغي إهمال الأعراض مِن الكُليات؛ فلذلك ذكرته في النَّظم تبعًا لـ "جمع الجوامع" وعطفته بالواو على الأموال على ما يتبادر للذهن من الاحتمالات السابقة وهو أنه في رُتبة أدناها وهو الأموال. والله أعلم.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (رقم: 1652)، صحيح مسلم (رقم: 1679).
(¬2) في (ص، ق، ش): ترتيبه.
(¬3) في (س، ت): مرتبتها.