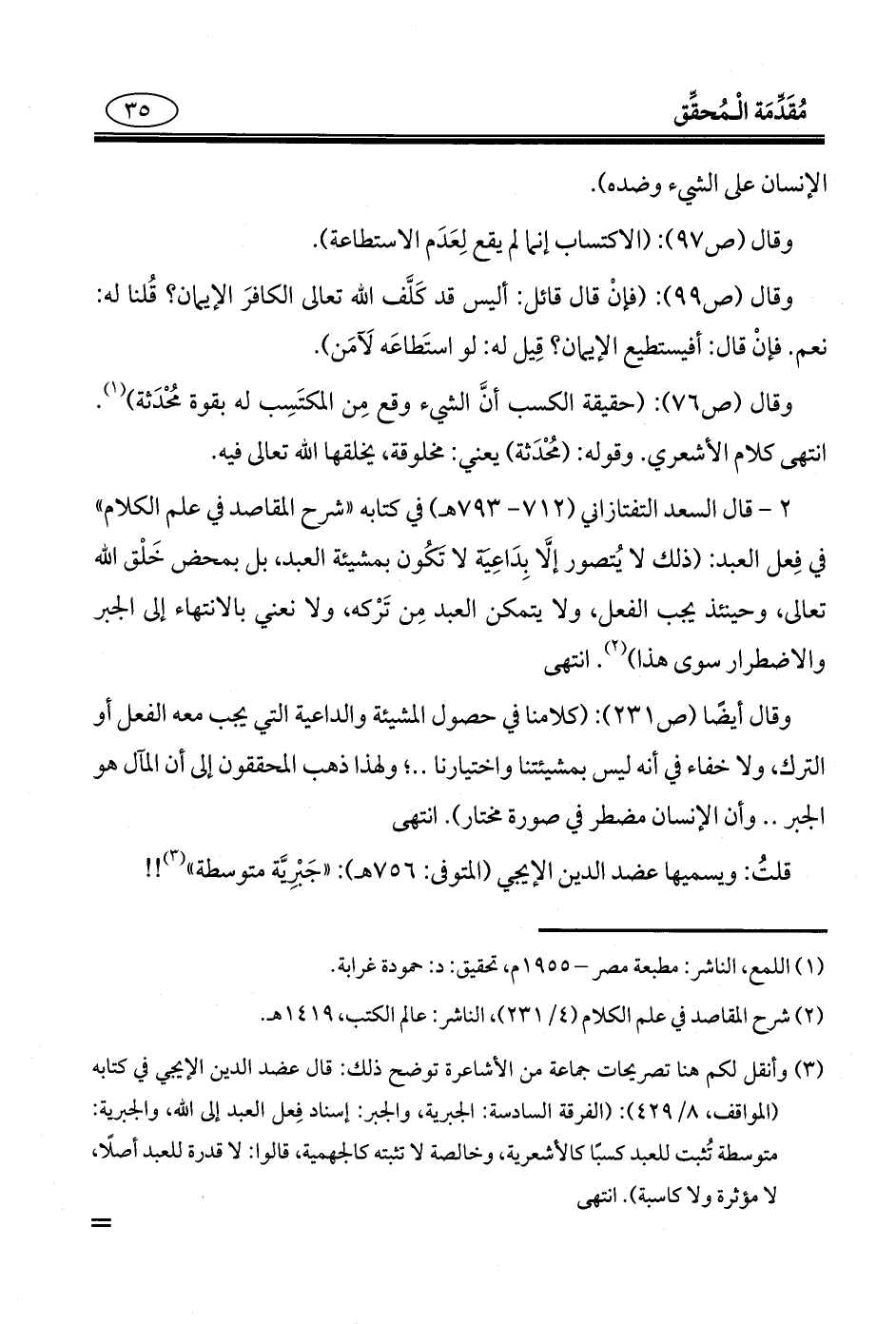
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية
الإنسان على الشيء وضده).وقال (ص 97): (الاكتساب إنما لم يقع لِعَدَم الاستطاعة).
وقال (ص 99): (فإنْ قال قائل: أليس قد كَلَّف الله تعالى الكافرَ الإيمان؟ قُلنا له: نعم. فإنْ قال: أفيستطيع الإيمان؟ قِيل له: لو استَطاعَه لَآمَن).
وقال (ص 76): (حقيقة الكسب أنَّ الشيء وقع مِن المكتَسِب له بقوة مُحْدَثة) (¬1). انتهى كلام الأشعري. وقوله: (مُحْدَثة) يعني: مخلوقة، يخلقها الله تعالى فيه.
2 - قال السعد التفتازاني (712 - 793 هـ) في كتابه "شرح المقاصد في علم الكلام" في فِعل العبد: (ذلك لا يُتصور إلَّا بِدَاعِيَة لا تَكُون بمشيئة العبد، بل بمحض خَلْق الله تعالى، وحينئذ يجب الفعل، ولا يتمكن العبد مِن تَرْكه، ولا نعني بالانتهاء إلى الجبر والاضطرار سوى هذا) (¬2). انتهى
وقال أيضًا (ص 231): (كلامنا في حصول المشيئة والداعية التي يجب معه الفعل أو الترك، ولا خفاء في أنه ليس بمشيئتنا واختيارنا .. ؛ ولهذا ذهب المحققون إلى أن المآل هو الجبر .. وأن الإنسان مضطر في صورة مختار). انتهى
قلتُ: ويسميها عضد الدين الإيجي (المتوفى: 756 هـ): "جَبْرِيَّة متوسطة" (¬3)! !
¬__________
(¬1) اللمع، الناشر: مطبعة مصر - 1955 م، تحقيق: د: حمودة غرابة.
(¬2) شرح المقاصد في علم الكلام (4/ 231)، الناشر: عالم الكتب، 1419 هـ.
(¬3) وأنقل لكم هنا تصريحات جماعة من الأشاعرة توضح ذلك: قال عضد الدين الإيجي في كتابه (المواقف، 8/ 429): (الفرقة السادسة: الجبرية، والجبر: إسناد فِعل العبد إلى الله، والجبرية: متوسطة تُثبت للعبد كسبًا كالأشعرية، وخالصة لا تثبته كالجهمية، قالوا: لا قدرة للعبد أصلًا، لا مؤثرة ولا كاسبة). انتهى =
تنبيه:
قول القائل: "لا أعلم خلافًا بين أهل العلم في كذا" لا يكون نقلًا للإجماع. قال الصيرفي: لجواز الاختلاف. وكذا قاله ابن حزم في "الإحكام". وقال في كتاب "الإعراب": إن الشافعي نَص عليه في "الرسالة"، وكذا أحمد.
قال الصيرفي: وإنما يسوغ هذا لمن بحث البحث الشديد وعلم أصولَ العلم وجُمله.
وقال ابن القطان: إنَّ قائل ذلك إنْ كان من أهل العلم فهو حُجة، وإلا فلا.
وقال الماوردي: إن لم يكن من أهل الاجتهاد المحيطين بالإجماع والاختلاف، لم يَثبت الإجماع بقوله، وإلا ففيه خِلاف لأصحابنا.
ورَدَّ ابن حزم على من يجعل مثل هذا إجماعًا بأن الخلاف قد يخفَى على الأئمة الكبار، فقدْ قال الشافعي في زكاة البقر: (لا أعلم خلافًا في أنه ليس في أقل من ثلاثين منها تبيع). مع أن في المسألة قولًا مشهورًا: إنَّ الزكاة في خمس منها كالإبل.
و[قال] (¬1) مالك في "الموطأ" في الحكم بِرد اليمين: (وهذا مما لا خلاف فيه بين أحد من الناس أَعْلمه). مع أن الخلاف شهير، فكان عثمان - رضي الله عنه - لا يرى برد اليمين ويقضي بالنكول، وكذا ابن عباس، ومن التابعين الحكَم وابن أبي ليلى، وأبو حنيفة وأصحابه، وهم كانوا القضاة في ذلك الوقت.
والله أعلم.
¬__________
(¬1) في (ص): فقد قال الشافعي وقال.
حينئذٍ قياسه عليه؟
مثاله في الصفة مثلًا: لو قيل: هل في الغنم السائمة زكاة؟ فيقول المسئول: في الغنم السائمة زكاة. فغيْر السائمة مسكوت عن حُكمه، فيجوز قياسُه على السائمة، بخلاف ما لو أَلْغَى لفظ "السائمة" وصار التقدير: "في الغنم زكاة"، فلا حاجة حينئذٍ لقياس المعلوفة بالسائمة؛ لأن لفظ "الغنم" شامل لهما.
في ذلك خلاف، والمختار الثاني، حتَّى إنَّ بعضهم حَكى فيه الإجماع، وهو ظاهر ما أَوْرَدَه ابن الحاجب في أثناء مسألة "مفهوم الصفة" عند ذِكر اعتراضات مِن جهة القائل بِنَفْي مفهوم الصفة، ومن جُملتها:
لا نُسَلِّم أن فائدة التقييد بالصفة نَفْيُ ما عداها، بل تقوية حُكم المذكور بحيث لا يجوز إخراجه مِن العموم المعروض. أيْ: كما يمتنع إخراج صورة السبب من العموم الوارد عليها.
فأجاب ابن الحاجب بأنَّ ذلك فَرعُ العموم، ولا قائل به، أمَّا القائل بالمفهوم فظاهر، وأما النافي له فلأنه يقول: إنه مسكوت عن حُكمه.
لكن ابن الحاجب لم يُصرح به في مسألتنا بخصوصها، بل فيما لو لم يُقَلْ بالمفهوم مُطلقًا. فإذا لم يُقَلْ به لِمانع، يكون كذلك؛ إذْ لا فَرق.
فلا ينبغي أنْ يُنقل عن ابن الحاجب ادِّعاء الإجماع في عَيْن المسألة، والله أعلم.
الرابع وبه قال أبو بكر الرازي من الحنفية: إنْ كان الباقي غير منحصر فحقيقة وإلا فمجاز؛ وذلك لأنه إذا بقي غير منحصر، كان معنى العام فيه وهو الاستغراق بغير حصر، بخلاف ما إذا كان الباقي محصورًا، فإنه مُغايِر حينئذٍ لمعنى العام.
ويتعجب من ابن السبكي في "شرح المختصر" في ضبط مقالة الرازي هذه بضابط قد ذكره أصحابنا في الفقه في تَزَوُّج امرأة من نساء فيهن له محَرم يجوز في غير المحصور دون المحصور.
قال إمام الحرمين: (غير الحصور كثرة يعسر العلم بقدرها على آحاد الناس).
وقال الغزالي: كل عدد لو اجتمعوا في صعيد لَعَسُر على الناظر عدتهم بمجرد النظر -كالألْف- فغير محصور، وإنْ سَهُل كالعشرة والعشرين فمحصور.
قال: (وبين الطرفين أوساط يلحق بأحدهما بالظن، وما وقع فيه الشك استفت فيه القلب). انتهى
ولكن هذا إنما هو في المحصور وغير المحصور في العُرف في الأفراد الوجودية في الخارج، وبحث الأصولي الذي عناه أبو بكر الرازي إنما هو مدلول الكُلي في الذهن.
الخامس: أنه حقيقة إن خُص بما لا يستقل من شرط أو صفة أو استثناء أو غاية، لا بالمستقل من عقل أو سمع، فإنه مجاز. وبهذا قال الكرخي من الحنفية والإمام الرازي.
وقال المازري أنه آخِر قَوليِّ القاضي، وأن أولهما كونه مجازًا مطلقًا (¬1).
السادس ونقله بعضهم عن القاضي كابن الحاجب في "مختصره": أنه حقيقة إنْ خُص بشرط أو استثناء، لا صفة وغيرها.
¬__________
(¬1) إيضاح المحصول (ص 302).
ص:
824 - وَمُكْمِلٌ لِذَا يَكُونُ لِاحِقَا ... بِهِ، كمُسْكِرٍ قَلِيلٍ وَافَقَا
825 - كَثِيرَهُ في الْحَدِّ، أَمَّا الْحَاجِي ... فَنَحْوُ بَيْع في سِوَى الْمُحْتَاجِ
826 - فَإنَّ ذَا يلْحَقُ بِالضَّرُورِي ... وَذَا كَالِاسْتِئْجَارِ لِلصَّغِير
827 - في أَنْ يُرَبَّى، وِبهَذَا مُكْمِل ... مِثْلُ خِيَارِ الْبَيْعِ حِينَ يَحْصُلُ
الشرح:
أي: ويلحق بالضروري مُكَمِّلُه في حُكمه. ومعنى كونه مُكملًا له أنه لا يستقل ضروريًّا بنفسه بل بطريق الانضمام، فله تأثير فيه لكن لا بنفسه، فيكون في حكم الضرورة مبالغةً في مراعاته.
كالمبالغة في حفظ الدين بتحريم البدعة وعقوبة المبتدع الداعي إليها، والمبالغة في حفظ النفس بإجراء القصاص في الجراحات، والمبالغة في حفظ العقل بتحريم شرب قليل المسكر والحد عليه؛ وذلك لأنَّ الكثير السكر مفسد للعقل، ولا يحصل إلَّا بإفساد كل واحد مِن أجزائه، فَحُدَّ شارب القليل؛ لأنَّ القليل متلف لجزء من العقل وإنْ قَل. وكذلك المبالغة في حفظ المال والعِرض بتعزير الغاصب ونحوه، وتعزير الساب بغير القذف، ونحو ذلك. والمبالغة في حفظ النسب بتحريم النظر والمس والتعزير عليه.
وقد نبه الشارع على إلحاق ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه". ثم قال: "ألا وإن حمَى الله محارمه" (¬1).
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (52)، صحيح مسلم (1599).