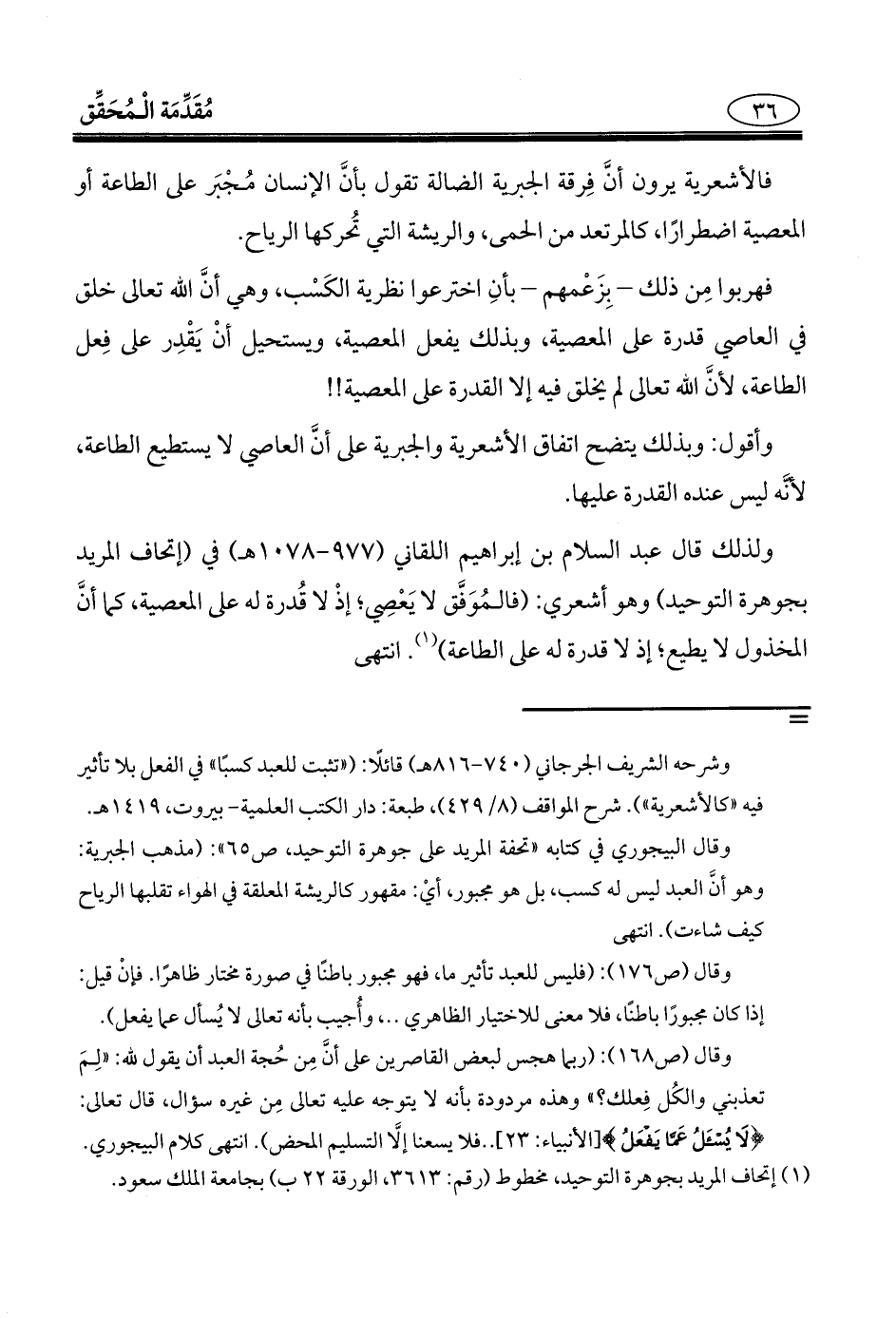
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية
فالأشعرية يرون أنَّ فِرقة الجبرية الضالة تقول بأنَّ الإنسان مُجْبَر على الطاعة أو المعصية اضطرارًا، كالمرتعد من الحمى، والريشة التي تُحركها الرياح.فهربوا مِن ذلك - بِزَعْمهم - بأنِ اخترعوا نظرية الكَسْب، وهي أنَّ الله تعالى خلق في العاصي قدرة على المعصية، وبذلك يفعل المعصية، ويستحيل أنْ يَقْدِر على فِعل الطاعة، لأنَّ الله تعالى لم يخلق فيه إلا القدرة على المعصية! !
وأقول: وبذلك يتضح اتفاق الأشعرية والجبرية على أنَّ العاصي لا يستطيع الطاعة، لأنَّه ليس عنده القدرة عليها.
ولذلك قال عبد السلام بن إبراهيم اللقاني (977 - 1078 هـ) في (إتحاف المريد بجوهرة التوحيد) وهو أشعري: (فالمُوَفَّق لا يَعْصِي؛ إذْ لا قُدرة له على المعصية، كما أنَّ المخذول لا يطيع؛ إذ لا قدرة له على الطاعة) (¬1). انتهى
¬__________
= وشرحه الشريف الجرجاني (740 - 816 هـ) قائلًا: ("تثبت للعبد كسبًا" في الفعل بلا تأثير فيه "كالأشعرية"). شرح المواقف (8/ 429)، طبعة: دار الكتب العلمية - بيروت، 1419 هـ.
وقال البيجوري في كتابه "تحفة المريد على جوهرة التوحيد، ص 65": (مذهب الجبرية: وهو أنَّ العبد ليس له كسب، بل هو مجبور، أيْ: مقهور كالريشة المعلقة في الهواء تقلبها الرياح كيف شاءت). انتهى
وقال (ص 176): (فليس للعبد تأثير ما، فهو مجبور باطنًا في صورة مختار ظاهرًا. فإنْ قيل: إذا كان مجبورًا باطنًا، فلا معنى للاختيار الظاهري .. ، وأُجيب بأنه تعالى لا يُسأل عما يفعل).
وقال (ص 168): (ربما هجس لبعض القاصرين على أنَّ مِن حُجة العبد أن يقول لله: "لِمَ تعذبني والكُل فِعلك؟ " وهذه مردودة بأنه لا يتوجه عليه تعالى مِن غيره سؤال، قال تعالى: {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ} [الأنبياء: 23] .. فلا يسعنا إلَّا التسليم المحض). انتهى كلام البيجوري.
(¬1) إتحاف المريد بجوهرة التوحيد، مخطوط (رقم: 3613، الورقة 22 ب) بجامعة الملك سعود.
ص:
277 - وَخَبَرُ الْآحَادِ مَا لَا يَنتهِي ... إلى تَوَاتُرٍ، وَغَيْرُ الْمُنْتَهِي
278 - إنْ شَاعَ عَنْ أَصْلٍ [فَذَا] (¬1) الْمَشْهُورُ ... وَ [الْمُسْتَفِيضُ اسْمَانِ] (¬2)، والْمَذْكُورُ
279 - أَقلُّهُ اثْنَانِ، وَقَوْلُ الْوَاحِد ... يُعْمَلُ في الْمُفْتَى بِهِ وَالشَّاهِدِ
الشرح:
لَمَّا بينتُ أن السُّنة والإجماع يثبتان بخبر الواحد، شرعتُ في تعريفه وتقسيمه وأحكامه، وهو جُلُّ المقصود من هذا الباب.
أما تعريفه فَـ "خبر الواحد": ما لم يَنْتَهِ إلى رتبة التواتر، إما بأن يرويه مَن هو دُون العدد الذي لا بُدَّ منه في التواتر، وهو الخمسة كما تَقدم، بأنْ يرويه أربعة فما دونها، أو يرويه عددُ التواتر ولكن لم ينتهوا إلى إفادة العِلم باستحالة تواطؤهم على الكذب، أو لم يكن ذلك في كل الطبقات، أو كان ولكن لم يخبِروا عن محسوس، أو غير ذلك مما يعتبر في التواتر كما سبق.
وقد عُلم ذلك من التقسيم أول الباب مِن أن ما لم يُفِد العِلم بنفسه من الأخبار هو الآحاد، وعُلم أيضًا أنه ليس المراد به ما يرويه الواحد فقط كما قد يُفهم مِن إطلاق خبر الواحد أو الآحاد، بل ما ذكرناه.
وقولي: (وَغَيْرُ الْمُنْتَهِي) إلى آخِره - إشارة إلى أن أرجح الأقوال وأقواها في "المشهور" أنه قسم من الآحاد، ويسمى أيضًا "المستفيض".
¬__________
(¬1) في (ق، ت، ن 1، ن 3، ن 4، ن 5): فذا. وفي (ض، ص، ش): كذا. وفي (ز، ن 2): هو. وفي (ظ): لذا.
(¬2) كذا في (ت، ن 1، ن 3، ن 4، ن هـ). لكن في (ز، ن 2): مستفيضًا سَمِّ. وفي (ض، ق، ص): المستفيض لاسما. وفي (ظ): المستفيض لاسيما. ولا (ش): المستفيض لاسمان.
ص:
471 - أَقْسَامُهُ: الْوَصْفُ، وَمنْهُ: عِلَّةُ ... ظَرْفٌ وَحَالٌ، عَدَدٌ قَدْ أثبَتُوا
الشرح:
إذا عُلم مفهوم المخالفة، فَلَهُ أقسام ذكرناها واحدًا واحدًا:
أحدها: مفهوم الصفة:
وقَدَّمْتُه، لأنه رأس المفاهيم.
قال إمام الحرمين: (ولو عبَّر مُعبِّر عن جميع المفاهيم بالصفة لَكان ذلك منقدحًا؛ لأن المعدود والمحدود موصوفان بِعَددهما وحَدِّهما) (¬1).
ثم قال بعد ذلك: (وكذا سائر المفاهيم). انتهى
ومراده أن معنى الوصفية يُدَّعَى رجوع الكل إليه باعتبارٍ وإن كان المقصود هنا نوعًا مِن ذلك خاصًّا بالاعتبار الآتي بيانه.
فبعضهم يُعبر عنه بتعليق الحكم بإحدى صِفَتَي الذات أو أوصافها، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "في سائمة الغنم زكاة" (¬2)، وهو حديث معناه ثابت في "الصحيح"، كحديث كتاب الصديق الذي أرسله إلى أَنس حين وجَّهه إلى البحرين حكاية عن فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفيه: "وفي الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين" (¬3) الحديث، وقال فيه: "فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة
¬__________
(¬1) البرهإن (1/ 301).
(¬2) سبق الكلام عليه.
(¬3) صحيح البخاري (رقم: 1386) بلفظ: (وفي صَدَقَةِ الْغَنَمِ في سَائِمَتِهَا إذا كانت أَرْبَعِينَ).
السابع: حقيقة إن خُص باستثناء، وإلا فلا. كذا قاله القاضي في "مختصر التقريب"، ولفظه: (فالصحيح عندنا من هذه المذاهب أن نقول: إذا تَقرر التخصيص باستثناء متصل، فاللفظ حقيقة في بقية المسميات، وإنْ [تَقرر] (¬1) التخصيص بدلالة منفصلة، فاللفظ مجاز، لكن يُستدل به في بقية المسميات) (¬2). انتهى
نعم، إنْ جُعِل اقتصارُه على الاستثناء كالمثال لا للحصر فيه لأنه جَعَله في مقابلة المنفصل، كان موافقًا لِمَا سبق مِن نقل المازري عنه القول الخامس.
الثامن وبه قال عبد الجبار: أنه حقيقة إنْ خُص بشرط أو صفة، لا استثناء أو غيره.
التاسع: أنه حقيقة إن خُص بدليل لفظي، سواء أكان متصلًا أَم منفصلًا، وإلا فمجاز.
العاشر: إنْ بقي بعد التخصيص جمع فهو حقيقة، وإلا فهو مجاز.
وأما قول الغزالي: (إنه إذا لم يبق بعد التخصيص جمع، لا خلاف في كونه مجازًا) ففيه نظر، فقد ذكر القاضي عن بعض أصحابنا أن اللفظ حقيقة فيما يبقى وإن كان أقل من الجمع، قال: (وهذا بعيد جدًّا).
فلعل الغزالي إنما نفى الخلاف لقول الإمام ذلك.
وممن قال بهذا القول -مع بُعده- الباجي من المالكية، ونقله القاضي أبو الطيب عن الشيخ أبي حامد احتجاجًا بقوله تعالى: {فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ} [المرسلات: 23].
وقد تعقب ابن القشيري بذلك على مقالة القاضي السابقة المشعِرة بالاتفاق؛ لاستبعاده ذلك القول وأنه لا يُعْبَأُ به.
¬__________
(¬1) كذا في (ص، ق)، لكن في (س): تقدَّر.
(¬2) التقريب والإرشاد - الصغير (3/ 67)، التلخيص (2/ 41).
وقولي: (أَمَّا الْحَاجِي) بيان للقسم الثاني وهو الذي لا يكون في محل الضرورة بل في محل الحاجة. ويقال له أيضًا: "المصلحي" كما عبر بذلك البيضاوي، كالبيع والإجارة؛ لأنَّ مالك الشيء قد يُضَر بإعارته؛ ولذلك قال إمام الحرمين: (إنَّ مَن زعم أنَّ الإجارة خارجة عن مقتضَى القياس فليس على بصيرة؛ لأنَّ الحاجة أصل).
وكالمساقاة والقراض؛ لأنه ليس كل أحد يَعرف عمل الأشجار ولا التجارة، أو لاشتغال الملاك بأهم من ذلك.
ومن ذلك أيضًا: نَصْبُ الولي [للصغير] (¬1)، فإنَّ مصالح النكاح غير ضرورية ولكن واقعة في محل الحاجة، فإنها داعية إلى الكُفْء الموافق، وهو لا يوجد في كل وقت، فكل هذه لا يَلْزَم مِن فواتها فوات الشيء من الضروريات الخمس.
وادَّعَى إمام الحرمين أن البيع ضروري، ولعله أراد ما كَثُرت شدة الحاجة إليه بحيث صار كالضروري؛ لأنَّ الناس لو لم يتبادلوا ما بأيديهم لَجَرَّ ذلك ضرورة.
وقولي: (في سِوَى الْمُحْتَاجِ) إلى آخِره أي: إنما يكون البيع حاجيًّا في غير هذه الصورة، فإنها من الضروريات، كالإجارة على تربية الطفل وشراء المطعوم والملبوس له حيث كان في معرض التلف من الجوع والبرد.
وحاصله أن الحاجي يتفاوت، حتى أن بعضه ينتهي إلى رتبة الضروري؛ لشدة الاحتياج، وهو نادر كما في هذه الصورة. وإنما لم يكن هذا من الضروري نفسه لإمكان حصول المقصود بوضع اليد قهرًا عند خوف الهلاك وغرم قيمته، كواجد طعام الغير في المخمصة.
وقولي: (وِلهَذَا مُكْمِلُ) أي: للحاجي مُكمل مُلْحَق به في تعليله بالحاجة، كرعاية
¬__________
(¬1) في (س، ت): للصغيرة.