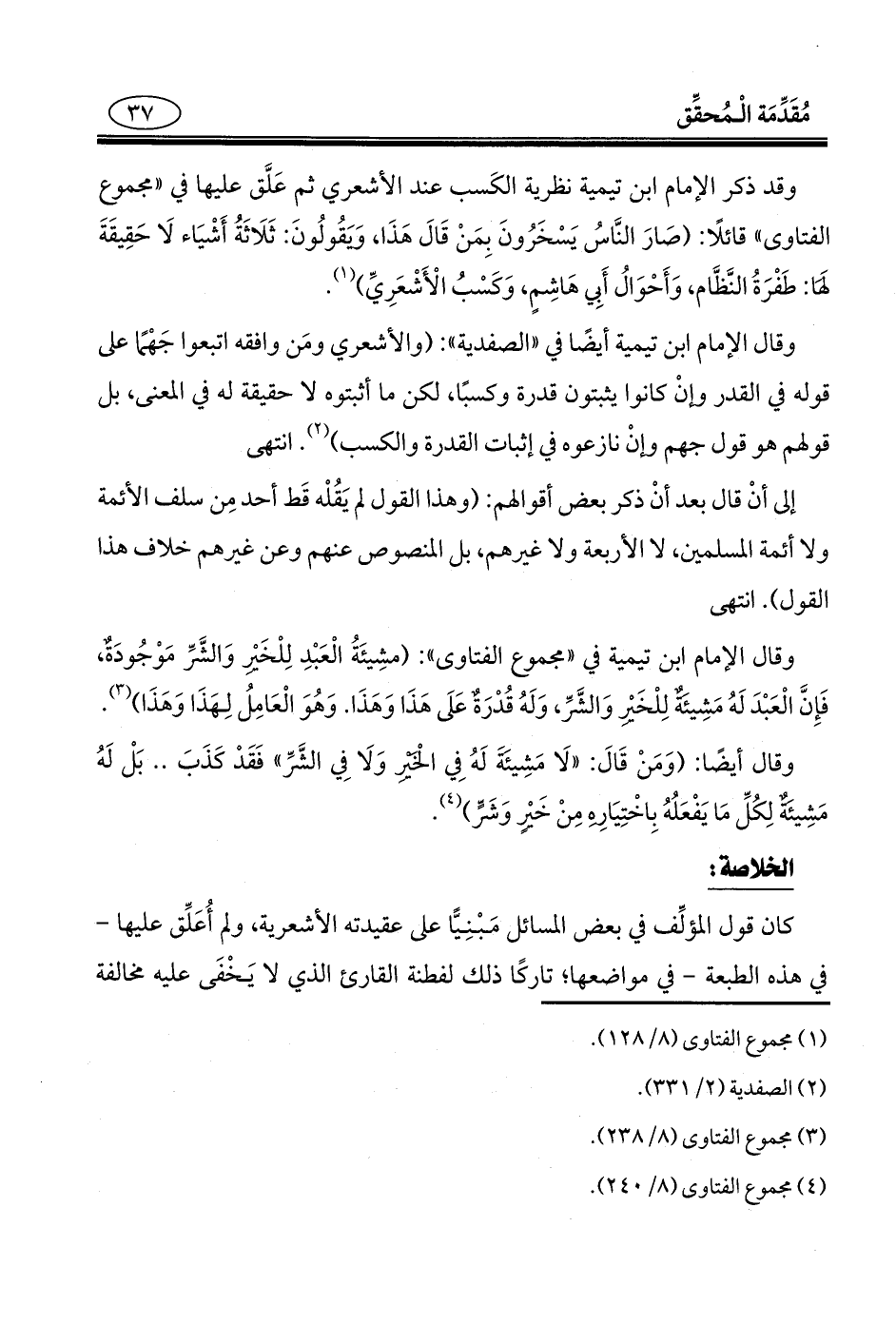
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية
وقد ذكر الإمام ابن تيمية نظرية الكَسب عند الأشعري ثم عَلَّق عليها في "مجموع الفتاوى" قائلًا: (صَارَ النَّاسُ يَسْخَرُونَ بِمَنْ قَالَ هَذَا، وَيَقُولُونَ: ثَلَاثَةُ أَشْيَاء لَا حَقِيقَةَ لَهَا: طَفْرَةُ النَّظَّام، وَأَحْوَالُ أَبِي هَاشِمٍ، وَكَسْبُ الْأَشْعَرِيِّ) (¬1).وقال الإمام ابن تيمية أيضًا في "الصفدية": (والأشعري ومَن وافقه اتبعوا جَهْمًا على قوله في القدر وإنْ كانوا يثبتون قدرة وكسبًا، لكن ما أثبتوه لا حقيقة له في المعنى، بل قولهم هو قول جهم وإنْ نازعوه في إثبات القدرة والكسب) (¬2). انتهى
إلى أنْ قال بعد أنْ ذكر بعض أقوالهم: (وهذا القول لم يَقُلْه قَط أحد مِن سلف الأئمة ولا أئمة المسلمين، لا الأربعة ولا غيرهم، بل المنصوص عنهم وعن غيرهم خلاف هذا القول). انتهى
وقال الإمام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى": (مشِيئَةُ الْعَبْدِ لِلْخَيْرِ وَالشَّرِّ مَوْجُودَةٌ، فَإِنَّ الْعَبْدَ لَهُ مَشِيئَةٌ لِلْخَيْرِ وَالشَّرِّ، وَلَهُ قُدْرَةٌ عَلَى هَذَا وَهَذَا. وَهُوَ الْعَامِلُ لِهَذَا وَهَذَا) (¬3).
وقال أيضًا: (وَمَنْ قَالَ: "لَا مَشِيئَةَ لَهُ فِي الْخَيْر وَلَا فِي الشَّرِّ" فَقَدْ كَذَبَ .. بَلْ لَهُ مَشِيئَةٌ لِكُلِّ مَا يَفْعَلُهُ بِاخْتِيَارِه مِنْ خَيْرِ وَشَرٍّ) (¬4).
الخلاصة:
كان قول المؤلِّف في بعض المسائل مَبْنِيًّا على عقيدته الأشعرية، ولم أُعَلِّق عليها - في هذه الطبعة - في مواضعها؛ تاركًا ذلك لفطنة القارئ الذي لا يَخْفَى عليه مخالفة
¬__________
(¬1) مجموع الفتاوى (8/ 128).
(¬2) الصفدية (2/ 331).
(¬3) مجموع الفتاوى (8/ 238).
(¬4) مجموع الفتاوى (8/ 240).
وقد سبق عن الماوردي والأستاذ أبي إسحاق وجمعٍ أنه قسم ثالث غير المتواتر والآحاد، وذهب أبو بكر الصيرفي والقفال الشاشي إلى أنه و"المتواتر" بمعنًى واحد.
وثالثها: أن "المشهور" أعم من "المتواتر"، وهو طريقة المحدثين.
قال ابن الصلاح: (ومعنى الشهرة مفهوم، وهو ينقسم إلى: صحيح، كحديث: "إنما الأعمال بالنية" (¬1)، وغير صحيح، كحديث: "طلب العلم فريضة على كل مسلم" (¬2). ونقل عن أحمد أن أربعة أحاديث تدور في الأسواق ليس لها أصل) (¬3). إلى آخِره.
ثم قال: وينقسم إلى: ما هو مشهور بين أهل الحديث وغيرهم، نحو: "المسلم مَن سلم المسلمون من لسانه ويده" (¬4)، وبين أهل الحديث خاصة، كقنوته - صلى الله عليه وسلم - بعد الركوع شهرًا يدعو على رعل وذكوان) (¬5) (¬6).
ثم ذكر وَجْه اختصاصه بالشهرة عندهم، ثم قال: (ومن المشهور المتواتر). إلى آخِر ما
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.
(¬2) سنن ابن ماجه (رقم: 224)، مسند أبي يعلى (2837)، المعجم الصغير للطبراني (1/ 36، رقم: 22)، وغيرها. قال الحافظ السخاوي في (المقاصد الحسنة، ص 442): (قال العراقي: "قد صحح بعض الأئمة بعض طُرقه. . "، وقال المِزِّي: "إنَّ طُرقه تبلغ به رُتبة الحسن"). وقال الألباني في (تخريج أحاديث مشكلة الفقر، ص 61 - 62) بعد أنْ ذكر طرقه: (وبالجملة فَجُلّ طُرُق هذا الحديث واهية؛ ولذلك ضَعَّفه جماعة من الأئمة. .، لكن بعض طرقه الأخرى مما يقوي بعضه بعضًا، بل أحدهما حسن. . فالحديث بمجموع ذلك صحيح بلا ريب عندي).
(¬3) مقدمة ابن الصلاح (ص 265).
(¬4) صحيح البخاري (10)، صحيح مسلم (41).
(¬5) صحيح البخاري (958)، صحيح مسلم (677).
(¬6) مقدمة ابن الصلاح (ص 265).
عن أربعين شاة واحدة، فليس فيها صدقة" (¬1). فإنَّ الغنم ذات، والسوم والعَلف وَصْفان لها، ومثله تعليق [النفقةِ] (¬2) البينونة على الحمل، وشرط ثمرة النخل للبائع بما إذا كانت مؤبَّرة.
فهو يدل على أنْ لا زكاة في المعلوفة، وأنْ لا نفقة [للحائل] (¬3)، وأنْ لا ثمرة لبائع النخل غير المؤبَّرة.
وربما عُبِّر عن ذلك بتقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخَر مختص ليس بشرطٍ ولا استثناء ولا غاية.
وبالجملة فليس المراد بالصفة النعت فقط كما هو اصطلاح النحاة؛ ولذلك يُمَثِّلون ب "مَطْل الغَنِي ظُلْم" (¬4) مع أن التقييد به إنما هو بالإضافة.
نعم، قد يُدَّعَى بأنَّ هذا نَعت محذوف منعوته، إذِ التقدير: مطل الشخص الغني. وإنَّما إدخال الإضافة في مفهوم الصفة في نحو: "في سائمة الغنم زكاة" فإن التقييد فيه بالإضافة كما مَثَّل به البيضاوي، لا بلفظ "الغنم"؛ لئلَّا يكون ذلك من مفهوم اللقب؛ لأنه اسم جامد، فلا فرق حينئذٍ في قوله: "في الغنم السائمة زكاة" و"في سائمة الغنم زكاة" في أن كُلًّا منهما مِن مفهوم الصفة، إلَّا أن ظاهر كلام البيضاوي استواؤهما في المفهوم.
ولكن الظاهر التغاير؛ فالقيد في الأول "الغنم" بوصف السوم، وفي الثاني "السائمة" بوصف كونها من الغنم.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (رقم: 1386).
(¬2) في (ز، ق): نفقة.
(¬3) كذا في (ت، ض). وفي سائر النسخ: الحائل.
(¬4) صحيح البخاري (رقم: 2166)، صحيح مسلم (رقم: 1564).
وأما شُبَه هذه المذاهب فَلَسْنَا بصدد ذِكرها؛ قصدًا للاختصار.
نعم، ننبه هنا على أمور:
أحدها: قد علمت أن هذا الخلاف إنما هو في العام المخصوص، أما العام المراد به الخصوص فمجاز قطعًا إلا على الجهة التي سبق في كلام السبكي أنه يمكن أن يَطْرقه الخلاف منها.
الثاني: فائدة الخلاف في هذه المسألة الخلاف في المسألة الآتية، فمَن يقول: حقيقة، يقول بأنه يُحتج به في الأفراد الباقية. ومَن يقول: مجاز، فلا إلا بقرينة تدل على بقاء الحكم فيه.
الثالث: إنما أطلقتُ في النَّظم كونه حقيقة ولم أُشِر إلى التعريض بشيء من المذاهب فيه بخلاف المسألة الآتي ذِكرها، وهي كونه حُجة في الباقي، فإني أومأت إلى بعض ما فيها من الأقوال؛ لأن الأهم في الباب بحث كونه حُجة أو لا.
المسألة الرابعة:
إذا خُص العام بشيء من المخصصات، هل تبقى حُجيته فيما بقي كما كانت قبل التخصيص؟ فيه مذاهب:
أصحها: أنه إنْ خُصَّ بمبهَم فليس بحجة. كما لو قال: (اقتلوا المشركين إلا بعضهم)، لا يُستدل به على الأمر بقتل فرد من الأفراد؛ إذ ما مِن فرد إلا ويجوز أن يكون هو المخرج.
ومنه قوله تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} [المائدة: 1] حتى ادَّعَى بعضهم الاتفاق فيه كالقاضي وابن السمعاني والأصفهاني في "شرح المحصول"، وكذا الآمدي، وهو ظاهر تقييد ابن الحاجب والبيضاوي وغيرهما محل الخلاف بالمخصص بمعيَّن.
وليس حكاية الاتفاق بصحيحة؛ ففي "الوجيز" لابن برهان حكاية الخلاف في هذه
الكفاءة ومهر المثل في التزويج، فإنه أفضى إلى دوام النكاح وتكميل مقاصده وإنْ [حصل] (¬1) أصل الحاجة بدون ذلك. وكذلك إثبات الخيار في البيع بأنواعه؛ لِمَا فيه من التروي وإنْ كان أصل الحاجة حاصلًا بدونه.
وقولي: (حِينَ يَحْصُلُ) أي حين يحصل البيع، فإنه حينئذٍ سبب الخيار كما هو مُقَرر موضح في الفقه. والله أعلم.
ص:
828 - ثُمَّ: الَّذِي يُعْرَفُ بِالتَّحْسِيني ... مَا لَا يُنَافِي قَاعِدَاتِ الدِّينِ
829 - كَالسَّلْبِ في أَهْلِيَّةِ الشَّهَادَهْ ... مِنَ الرَّقِيقِ؛ لِانْحِطَاط عَادَهْ
830 - وَمَا يُنَافِي كَكِتَابَةٍ فَهِيْ ... بَيْعُ امْرِئٍ مَالًا لَهُ بِمَالِه
الشرح:
القسم الثالث: ما ليس ضروريًّا ولا حاجيًّا ولكنه في محل التحسين، وذلك ضربان:
أحدهما: ما ليس فيه منافاة لقاعدة من قواعد الشرع، وإليه الإشارة بقولي (من قَاعِدَاتِ الدَّينِ) أي: لا تعارضه قاعدة شرعية، كسلب الرقيق أَهْلِيَّة الشهادة؛ لانحطاطه في محاسن العادات عن المناصب الشريفة من قضاءٍ وولايةٍ وشهادةٍ ونحو ذلك.
نعم، سلب الولاية عنه من الحاجي؛ لأنها تستدعي فراغًا، والرقيق مستغرق في خدمة السيد، فتفويض أمر الطفل ونحوه إليه إضرار بذلك.
وأما روايته وفتواه فإنما جازَا منه؛ لعدم الضرر بما يترتب عليهما؛ فلذلك فارقَا الشهادة
¬__________
(¬1) كذا في (س، ت)، لكن في (ص، ق، ض، ش): حصلت.