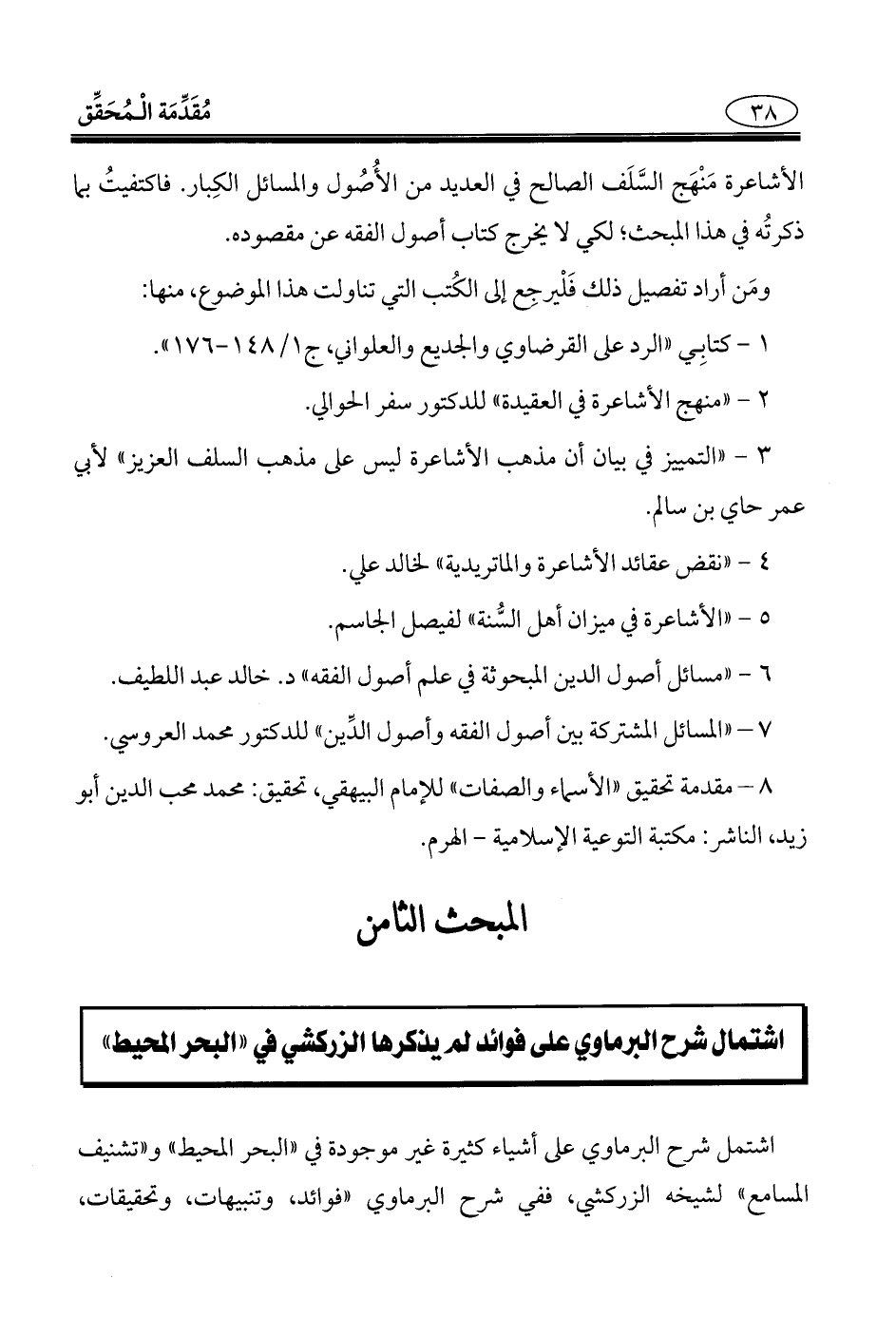
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية
الأشاعرة مَنْهَج السَّلَف الصالح في العديد من الأُصُول والمسائل الكِبار. فاكتفيتُ بما ذكرتُه في هذا المبحث؛ لكي لا يخرج كتاب أصول الفقه عن مقصوده.ومَن أراد تفصيل ذلك فَلْيرجِع إلى الكُتب التي تناولت هذا الموضوع، منها:
1 - كتابِي "الرد على القرضاوي والجديع والعلواني، ج 1/ 148 - 176".
2 - "منهج الأشاعرة في العقيدة" للدكتور سفر الحوالي.
3 - "التمييز في بيان أن مذهب الأشاعرة ليس على مذهب السلف العزيز" لأبي عمر حاي بن سالم.
4 - "نقض عقائد الأشاعرة والماتريدية" لخالد علي.
5 - "الأشاعرة في ميزان أهل السُّنة" لفيصل الجاسم.
6 - "مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه" د. خالد عبد اللطيف.
7 - "المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدَّين" للدكتور محمد العروسي.
8 - مقدمة تحقيق "الأسماء والصفات" للإمام البيهقي، تحقيق: محمد محب الدين أبو زيد، الناشر: مكتبة التوعية الإسلامية - الهرم.
المبحث الثامن: اشتمال شرح البرماوي على فوائد لم يذكرها الزركشي في "البحر المحيط"
اشتمل شرح البرماوي على أشياء كثيرة غير موجودة في "البحر المحيط" و"تشنيف المسامع" لشيخه الزركشي، ففي شرح البرماوي "فوائد، وتنبيهات، وتحقيقات،
سبق نقله عنه.
وفسره الماوردي في "الحاوي" والروياني في "البحر" بما يقتضي أنه أَخَص من "المتواتر" وأعلى منه، فيكون قولًا رابعًا، فقالا: (الاستفاضة أن ينتشر من ابتدائه بين البر والفاجر، ويتحققه العالم والجاهل، ولا يشك فيه سامع، إلى أن ينتهي) (¬1).
عَنَيا استواء الطرفين و [الواسطة] (¬2).
قالا: (وهو أقوى الأخبار وأثبتها حُكمًا. و"التواتر": أن يبتدئ به الواحد بعد الواحد حتى يكثر عددهم، ويبلغوا قدرًا ينتفي عن مِثلهم التواطؤ والغلط، فيكون في أوله من أخبار الآحاد، وفي آخِره من "المتواتر") (¬3).
ومرادهما بِـ"أوله" أول أمره، لا أول الطبقات من الأسفل.
ثم قالا: (والفرق بينهما من ثلاثة أوجه، أحدها: هذا، وثانيها: أن الاستفاضة لا يراعَى فيها عدالة المخبِر، بخلاف المتواتر. وثالثها: أن الانتشار في الاستفاضة من غير قصد، والانتشار في المتواتر بالقصد، ويستويان في: انتفاء الشك، ووقوع العِلم بهما، وعدم الحصر في العَدد، وانتفاء التواطؤ على الكذب من المخبِرين) (¬4).
ومَثَّلا "المستفيض" بعدد الركعات، و"المتواتر" بوجوب الزكوات.
وما اشترطاه في الاستفاضة من عدد يمتنع تواطؤهم على الكذب مفرَّع على قولهما في شهادة الاستفاضة بذلك، وبه قال ابن الصباغ والغزالي والمتأخرون.
¬__________
(¬1) الحاوي الكبير (16/ 85).
(¬2) في (ص): الوسط. وفي (ض): الوسطة.
(¬3) المرجع السابق.
(¬4) الحاوي الكبير (16/ 85).
فمفهوم الأول عدم وجوب الزكاة في معلوفة الغنم، ومفهوم الثاني عدم الوجوب في سائمة غيْر الغنم مِن الإبل والبقر.
قال ابن السبكي في "منع الموانع": (إنَّ هذا هو التحقيق، أما عدم وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة بالنسبة للتركيب الثاني فمِن باب مفهوم اللقب، كما أن عدم وجوب الزكاة في الإبل والبقر بالنسبة إلى قولنا: "في الغنم السائمة الزكاة" مِن مفهوم اللقب أيضًا؛ لأن المقيد في هذا - وهو "الغنم" - لم يشمل غير الغنم، فلم يخرج بالصفة التي لو أُسقطت لم يَخْتَل الكلام. والمقيد في "سائمة الغنم" - وهو "السائمة" - لم يشمل المعلوفة حتَّى يخرج بقيد الإضافة للغنم التي لو أُسقطت لاختل الكلام؛ ولذلك لم يَقُل أَبو عُبَيد في "مَطْل الغَنِي ظُلم" إلَّا أن مفهومه أن مَطْل غير الغَنِي ليس بظلم، لا أن غير المَطْل ليس بظلم، ولا أن الغَنِي الذي ليس بمماطل ليس بظالم.
وقد عُلم بما تَقرر أن لكل من التركيبين منطوقًا ومفهوم صفة ومفهوم لقب، فمنطوقهما واحد، وهو وجوب الزكاة في السائمة مِن الغنم، ومفهوم الصفة فيهما مختلف، وكذا مفهوم اللقب أيضًا فيهما مختلف كما سبق تقريره) (¬1). انتهى ملخصًا.
قلتُ: قد تَقرر أنَّه ليس مرادهم بالصفة النعت الذي هو أحد التوابع في النحو، بل الأَعَم منه ومما يكون صفة في الأصل، فمعروض (¬2) الصفة في "سائمة الغنم" هو لفظ "الغنم" وإنْ تقدمت صفته؛ لكونها أُضِيفت له.
ولذلك وقع الخلاف - في إضافة الصفة للموصوف - بين البصريين والكوفيين، فالكوفيون لَمَّا جَوَّزوه لم يحتاجوا إلى تأويل، والبصريون أَوَّلُوه، فلم يخرج - على الرأيين -
¬__________
(¬1) منع الموانع (ص 514 - 517).
(¬2) جاء في هامش (ص): معروض الصفة هو الموصوف، وهو الغنم.
الحالة، بل صحح العمل به مع الإبهام.
قال: (لأنَّا إذا نظرنا إلى فرد، شككنا فيه هل هو مِن المخرج؟ أم لا؟ والأصل عدمه، فيبقى على الأصل ويُعمل به إلى أن يُعْلم بالقرينة أن الدليل المخصِّص معارِض لِلَّفظ العام، وإنما يكون معارِضًا عند العِلم به). انتهى
وهو صريح في الإضراب عن المخصِّص والعمل بالعام في جميع أفراده. وهو بعيد وإنْ قال به بعض الحنفية كما نقله ابن الساعاتي في "البديع"، وكذا صاحب "اللباب" وأبو زيد وغيرهم، وحكاه أبو الحسين بن القطان من الشافعية عن بعض أصحابنا.
وبالجملة فالراجح المنع؛ لأن إخراج المجهول مِن المعلوم يُصَيِّر المعلوم مجهولًا، وهذا كما لو قال: (بِعْتُك هذه الصبرة إلا صاعًا منها)، لا يصح.
فالإضراب عن التخصيص بالمبهَم والعمل بالعموم -ناءٍ عن قواعد الشرع، ويلزم أن مَن طلق إحدى امرأتيه يَطَأهُما جميعًا، ومَن اشتبه عليه الطهور من إناءين، يستعملهما. ولكنه رأي ضعيف، وهو أنه يهجم.
نعم، لو قيل: يُحتج به إلى أنْ يبقى فرد، كان له وجه، كمن اشتبه مَحْرمه بنساء غير محصورات، ولو حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر كثير فأكله إلا تمرة، لم يحنث.
بخلاف اختلاط المحرم بالمحصور فإنَّ الكل حرام، حتى لو وطأَ رجلان امرأة وطئًا يلحق به النسب فأتت بولد وأرضعت طفلًا بلبنه [ولم] (¬1) يثبت نَسبه وأراد أن يتزوج ببنت أحدهما، لم تَحِل على الأصح.
وقيل: يحِل أن يتزوج بنت مَن شاء منهما؛ لأن الأصل في كل واحدة الِحل.
¬__________
(¬1) في (ص): فلم.
والقضاء والولاية.
ومن ذلك أيضًا اعتبار الولي في النكاح؛ لاستحياء النساء من مباشرة العقود على فروجهن؛ لإشعاره بتوقان نفوسهن إلى الرجال، وهو غير لائق بالمروءة.
وكذلك اعتبار الشهادة في النكاح؛ لتعظيم شأنه وتميزه عن السفاح بالإعلان والإظهار؛ ولذلك اكتفى مالك [بالإعلان] (¬1) دون الشهادة. ولو علل بإثباته عند التنازع لكان حاجيًّا، لا تحسينيًّا، كما لو عُلِّل اعتبار الولي بفتور رأي المرأة في الانقياد للأزواج وسرعة الاغترار بالظواهر لَكان حاجيًّا. ولكن لا يصح التعليل بذلك في سلب عبارتها وفي نكاح الكفء.
ومن ذلك أيضًا: تحريم القاذورات، فإن نفرة الطباع معنى يناسب تحريمها حتى يحرم التضمخ بالنجاسة بلا عُذر، ولبس جلد الميتة ونحو ذلك.
الثاني من التحسين: ما ينافي قاعدة شرعية، كالكتابة، فإنها مِن حيث كونها [مكرمة] (¬2) في العادة مُستحسنة احتمل الشرع فيها خرم قاعدة ممهدة وهي امتناع بَيعْ الإنسان مال نفسه بمال نفسه ومعاملة عبده. ومِن ثَمَّ لم تجب الكتابة عند المعظم. وفي قول حكاه صاحب "التقريب": إنها تجب إذا طلبها العبد وعَلِم السيد فيه خيرًا؛ عملا بالأمر الوارد في الإيجاب. والمعظم حملوه على الندب؛ لِمَا تقدم من المعنى.
¬__________
(¬1) في (ق، ص): بالإعلام.
(¬2) ليس في (س، ت، ض).