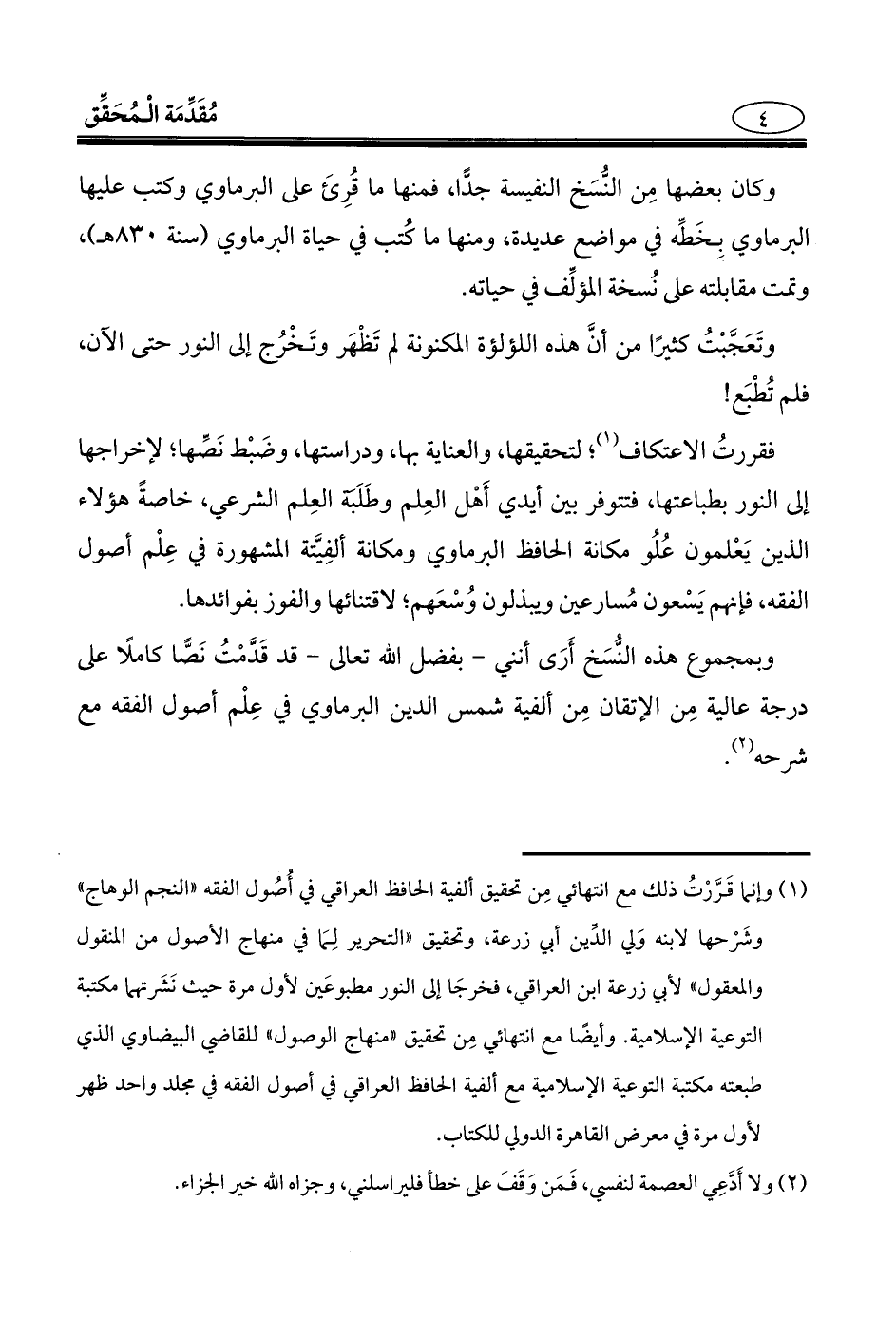
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية
وكان بعضها مِن النُّسَخ النفيسة جدًّا، فمنها ما قُرِئَ على البرماوي وكتب عليها البرماوي بِخَطِّه في مواضع عديدة، ومنها ما كُتب في حياة البرماوي (سنة 830 هـ)، وتمت مقابلته على نُسخة المؤلِّف في حياته.وتَعَجَّبْتُ كثيرًا من أنَّ هذه اللؤلؤة المكنونة لم تَظْهَر وتَخْرُج إلى النور حتى الآن، فلم تُطْبَع!
فقررتُ الاعتكاف (¬1)؛ لتحقيقها، والعناية بها، ودراستها، وضَبْط نَصِّها؛ لإخراجها إلى النور بطباعتها، فتتوفر بين أيدي أَهْل العِلم وطَلَبة العِلم الشرعي، خاصةً هؤلاء الذين يَعْلمون عُلُو مكانة الحافظ البرماوي ومكانة ألفِيَّته المشهورة في عِلْم أصول الفقه، فإنهم يَسْعون مُسارعين ويبذلون وُسْعَهم؛ لاقتنائها والفوز بفوائدها.
وبمجموع هذه النُّسَخ أَرَى أنني - بفضل الله تعالى - قد قَدَّمْتُ نَصًّا كاملًا على درجة عالية مِن الإتقان مِن ألفية شمس الدين البرماوي في عِلْم أصول الفقه مع شرحه (¬2).
¬__________
(¬1) وإنما قَرَّرْتُ ذلك مع انتهائي مِن تحقيق ألفية الحافظ العراقي في أُصُول الفقه "النجم الوهاج" وشَرْحها لابنه وَلي الدَّين أبي زرعة، وتحقيق "التحرير لِمَا في منهاج الأصول من المنقول والمعقول" لأبي زرعة ابن العراقي، فخرجَا إلى النور مطبوعَين لأول مرة حيث نَشَرتهما مكتبة التوعية الإسلامية. وأيضًا مع انتهائي مِن تحقيق "منهاج الوصول" للقاضي البيضاوي الذي طبعته مكتبة التوعية الإسلامية مع ألفية الحافظ العراقي في أصول الفقه في مجلد واحد ظهر لأول مرة في معرض القاهرة الدولي للكتاب.
(¬2) ولا أَدَّعِي العصمة لنفسي، فَمَن وَقَفَ على خطأ فليراسلني، وجزاه الله خير الجزاء.
الشرح:
أيْ: إنَّ كُلًّا مِن النص والظاهر يُسمى "مُحْكَمًا"، مِن الإحكام وهو الإتقان؛ لأنه أُحْكِمَ بظهور المراد منه، إما بلا احتمال أصلًا أو برجحان احتمال يظهر المراد فيُحْمل عليه، فهو بإزاء القدر المشترك بين القسمين وهو عدم المرجوحية. وهذا أحسن مِن تعبير بعضهم بالراجحية؛ لأن ما لا احتمال فيه لا يُقال له: دراجح.
فَـ "المُحْكَم" هو: المتضح المعنى.
ومقابِلُه يسمى "المتشابه": وهو ما لم يتضح فيه المعنى. سُمي بذلك لِتَشابه المعاني فيه وعدم ظهور المراد منها، فيدخل تحته:
- ما احتمل معنيين على السواء: وهو "المُجْمَل"، وسيأتي بيان جهات الاستواء.
- وما كان ظاهرًا في أحدهما أو أحدها ولكن قام دليل على إرادة المرجوح، فَيُؤَوَّل اللفظ بالحمل عليه.
فمدلول "المتشابه" أمران: المجمل، والمؤَوَّل؛ باعتبار القَدْر المشترك بينهما وهو عدم الرجحان.
وفي "تفسير الماوردي" عن الشَّافعي رحمه الله أن: ("المحكم" ما لا يحتمل من التَّأويلِ إلَّا وجهًا واحدًا، و"المتشابه" ما احتمل أَوْجُهًا) (¬1).
والمراد بِ "الوجه الواحد": الذي يتعين العمل به سواء أكان لا احتمال معه أو معه احتمال مرجوح. وبِـ "الأوْجُه": ما ليس فيه مُتَعَيّن للعمل كما بيناه.
بل قال الماوردي: (ويحتمل أن "المحكَم" ما كانت معاني أحكامه معقولة، بخلاف
¬__________
(¬1) تفسير النكت والعيون (1/ 369).
فواضح؛ لأنه عام، وإن لم يقترن بذلك وقُلنا: لا عموم فيه في الإثبات، فهو عام باعتبار قابليته لِأنْ يكون عامًّا بِشَرْطه. فقبوله لتخصيص حُكمه لذلك) (¬1). انتهى
وفي الأخير نظر؛ لأن المفرد كَ "رجُل" كذلك، فيكون متعددًا بالقابلية، ولكنه حقه أن يزيد في الجواب بأنَّ الجمع المنكَّر إذا لم يكن عامًّا، فتعدده تَعدُّد أجزاء، لا جزئيات كما قُلنا بنحوه في العدد.
ولا يقال: فيه عموم بدلي، فيتعدد باعتباره.
لأنَّا نقول: عندما يكون دالًّا على فرد لا يكون دالًّا على آخَر؛ فلا تَعدُّد، وإلا يَلزم أن يكون نحو: "رجُل" في الإثبات متعدد المعنى، وهو باطل.
نعم، كَوْن الإخراج مِن الحكم لا مِن اللفظ سيأتي إيضاحه.
وقد تبين بذلك المخصَّص (بفتح الصاد)، وأنه العام بمعنى حُكمه، لا لفظه، فاعلمه.
الثاني:
قد يقال: يَرِد على تعريف "التخصيص" بما ذُكِر أن النادر وغير المقصود داخل لا العموم على المرجَّح كما سبق، وقَصْر العام عليهما ليس تخصيصًا شرعيًّا، خلافًا للحنفية.
فلذلك ضُعِّفَ تأويلهم حديث: "أيما امرأة نكحت نفسها" بالحمل على المكاتبة أو المملوكة -بأنه نادرٌ؛ فلا يُقصَر الحكم عليه.
فالجواب: أن المراد أنه مع ندوره لا يكون فيه دليل على تخصيص العام بذلك.
الثالث: أورد القرافي دخول النسخ لبعض أفراد العام باعتبار كون تخصيصها إنما ورد بعد دخول وقت العمل كما سيأتي إيضاحه.
¬__________
(¬1) منع الموانع (ص 180 - 181)، الناشر: دار البشائر الإسلامية.
وأما "الظاهر" فهو: ما يحتمل احتمالًا، مرجوحًا، بأنْ يكون قد وُضع للتعليل لكنه استعمل في معنى غيره. فإذا ورد فإنما يحمل على الأصل مع احتمال أن يراد غيره، بخلاف ما لم يُستعمل في غير التعليل.
فأما "الصريح" الذي لا يحتمل غير العِلية فمثل أن يقال: "لِعِلة كذا" أو "لِسَبب" أو "لأَجْل" أو "مِن أَجْل". كقوله تعالى: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ} [المائدة: 32]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما جُعل الاستئذان مِن أَجْل البصر" (¬1). رواه الشيخان، وقوله: "إنما نهيتكم مِن أَجْل الدافة التي دفت، فكُلوا وادخروا" (¬2). رواه مسلم. أي: لأجل التوسعة على الطائفة التي قَدِمت المدينة أيام التشريق. والدافة: القافلة السائرة.
وَنَحْوِ "كَيْ" سواء كانت مجردة عن "لا" نحو قوله تعالى: {كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ} [طه: 40] أو مقرونة بها نحو: {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ} [الحشر: 7] أي: إنما وجب تخميسه لئلَّا يتناوله الأغنياء منكم؛ فلا يحصل للفقراء شيء.
وذكر ابن السمعاني أن "لأجْل" و"كَيْ" دُون ما قَبْلهما في الصراحة. وربما يفهم ذلك [مِن النَّظْم مِن] (¬3) ترتيبها في الذكر.
وقولي: (وَمَا كَمِثْلِ) أي: وما كان كمثل ما ذكر من هذه الصيغ، نحو: "إذًا" في قوله - صلى الله عليه وسلم - لأُبي بن كعب وقد قال له: "أجعل لك صلاتي كلها": "إذًا يغفر الله لك ذنبك كله" (¬4). وفي
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (رقم: 5887)، صحيح مسلم (رقم: 2156).
(¬2) صحيح مسلم (رقم: 1971).
(¬3) كذا في (ص، ق)، لكن في (س): في النظم و.
(¬4) سنن الترمذي (رقم: 2457) بلفظ: (إِذًا تُكفَى هَمَّكَ وَيُغْفَرُ لك ذَنْبُكَ). قال الألباني: حسن. (صحيح الترمذي: 2457).