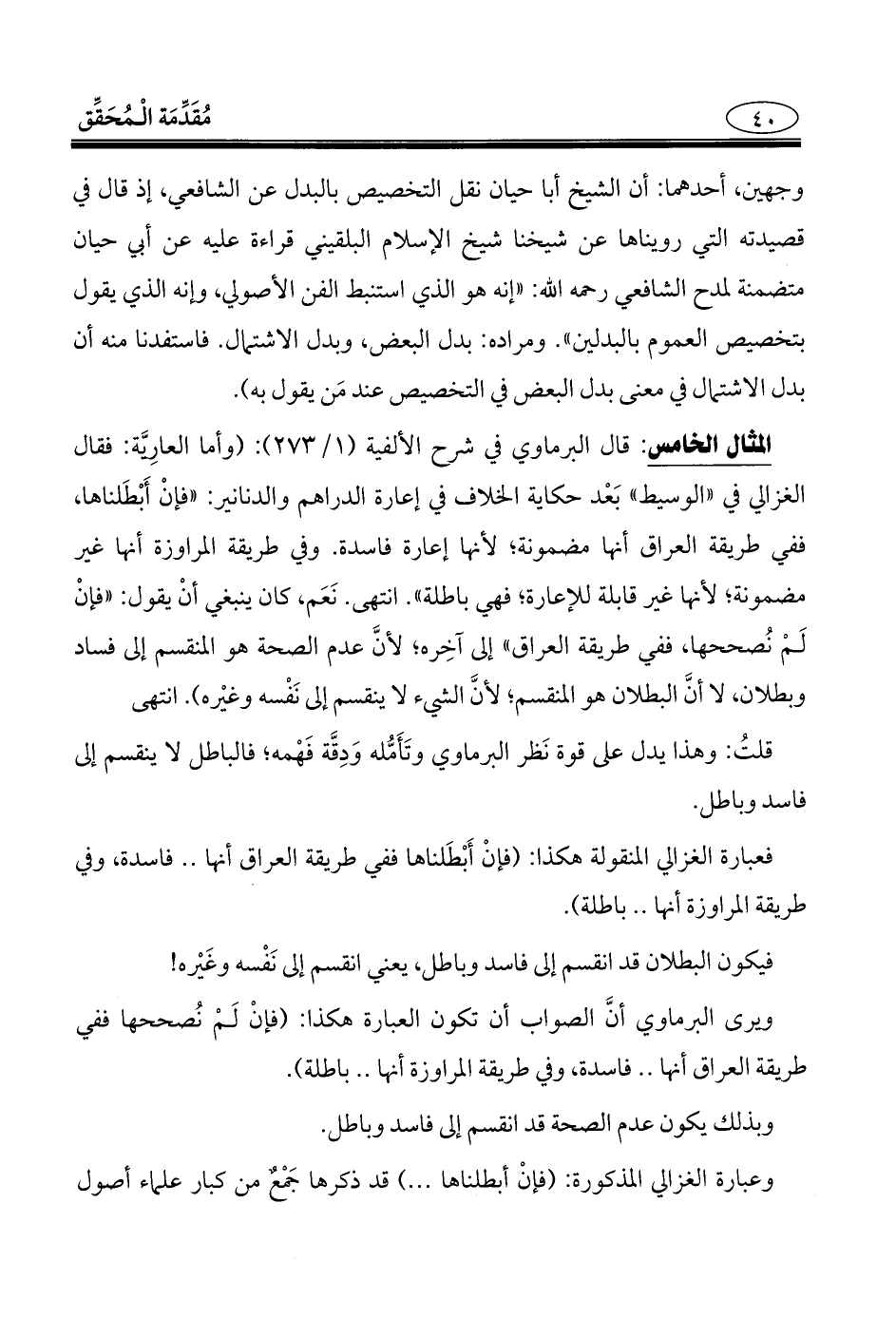
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية
وجهين، أحدهما: أن الشيخ أبا حيان نقل التخصيص بالبدل عن الشافعي، إذ قال في قصيدته التي رويناها عن شيخنا شيخ الإسلام البلقيني قراءة عليه عن أبي حيان متضمنة لمدح الشافعي رحمه الله: "إنه هو الذي استنبط الفن الأصولي، وإنه الذي يقول بتخصيص العموم بالبدلين". ومراده: بدل البعض، وبدل الاشتمال. فاستفدنا منه أن بدل الاشتمال في معنى بدل البعض في التخصيص عند مَن يقول به).المثال الخامس: قال البرماوي في شرح الألفية (1/ 273): (وأما العارِيَّة: فقال الغزالي في "الوسيط" بَعْد حكاية الخلاف في إعارة الدراهم والدنانير: "فإنْ أَبْطَلناها، ففي طريقة العراق أنها مضمونة؛ لأنها إعارة فاسدة. وفي طريقة المراوزة أنها غير مضمونة؛ لأنها غير قابلة للإعارة؛ فهي باطلة". انتهى. نَعَم، كان ينبغي أنْ يقول: "فإنْ لَمْ نُصححها، ففي طريقة العراق" إلى آخِره؛ لأنَّ عدم الصحة هو المنقسم إلى فساد وبطلان، لا أنَّ البطلان هو المنقسم؛ لأنَّ الشيء لا ينقسم إلى نَفْسه وغيْره). انتهى
قلتُ: وهذا يدل على قوة نَظر البرماوي وتَأَمُّله وَدِقَّة فَهْمه؛ فالباطل لا ينقسم إلى فاسد وباطل.
فعبارة الغزالي المنقولة هكذا: (فإنْ أَبْطَلناها ففي طريقة العراق أنها .. فاسدة، وفي طريقة المراوزة أنها .. باطلة).
فيكون البطلان قد انقسم إلى فاسد وباطل، يعني انقسم إلى نَفْسه وغَيْره!
ويرى البرماوي أنَّ الصواب أن تكون العبارة هكذا: (فإنْ لَمْ نُصححها ففي طريقة العراق أنها .. فاسدة، وفي طريقة المراوزة أنها .. باطلة).
وبذلك يكون عدم الصحة قد انقسم إلى فاسد وباطل.
وعبارة الغزالي المذكورة: (فإنْ أبطلناها ... ) قد ذكرها جَمْعٌ من كبار علماء أصول
ص:
280 - وَهَكَذَا رَاوٍ وَلَوْ في دِينِي ... سَمْعًا، وَلَا يُشْعِرُ بِالْيَقِينِ
281 - إلَّا إذَا انْضَمَّ لَهُ قَرِينَه ... وَشَرْطُهُ أَذْكُرُهُ مُبِينَه
282 - عَدَالَةُ الرَّاوِي، كَذَا مُرُوءَتُه ... وَضَبْطهُ، فَهَذِهِ شَرِيطَتُهْ
الشرح:
هو بيان لحكم خبر الآحاد، والكلام فيه في ثلاثة مواضع: في الاحتجاج به، وهل يفيد الظن؟ أو اليقين؟ وفي شروطه.
الاول:
يُعمل به بإجماع في ثلاثة أماكن:
- في الفتوى، ومنها الحكم؛ لأنه في المعنى فتوى، وزيادة التنفيذ بشروطه المعروفة، فلذلك استغنيت عن التصريح به بذلك.
- وفي الشهادة، سواء شُرط العدد أو لا؛ لأنه لم يخرج عن الآحاد.
- وفي الرواية في الأمور الدنيوية، كالمعاملات ونحوها. وأما في الأمور الدينية فعلَى الصحيح من الخلاف الآتي بيانه؛ ولذلك قلت: (وَلَوْ في دِينِي) إيماءً إلى أنه محل الخلاف.
وممن صرح بأن الثلاثة الأُولى محل وفاق القفال الشاشي في كتابه والماوردي والروياني وابن السمعاني، حيث قسموا خبر الواحد إلى ما يحتج به فيه بالإجماع، كالشهادات والمعاملات، ومنها الإخبار بإذن صاحب الدار في دخولها وأكل الهدية بإخباره.
قال القفال: ولا خلاف في قبوله؛ لقوله تعالى: {إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا} [الأحزاب: 53].
6] مفهوم ذلك يدل على أن غير الفاسق لا نَتبَيَّنه، وتَمسك أيضًا في إثبات الرؤية بقوله تعالى: {كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ (15)} [المطففين: 15] فإنَّ مفهومه إثبات الرؤية لأهل الجنان.
وجرى على القول به أكثر أصحابه.
وفي "صحيح البخاري" في "كتاب الجنائز" و"مسلم" في "كتاب الإيمان" عن ابن مسعود قال: (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن مات يُشرك بالله شيئًا، دخل النار". وقلتُ: مَن مات لا يشرك بالله شيئًا، دخل الجنَّةَ) (¬1).
قيل: وهذا مصير منه إلى القول بالمفهوم؛ لأن الجملة حالية، ومفهوم الحال من باب الصفة كما سيأتي.
قلتُ: وقد سبق في "باب القياس" احتمال أنَّه من باب قياس العكس، فلا امتناع أنَّه يدل بالطريقين. وهو يُشْبه قول الشَّافعي في مفهوم الموافقة: إنه مِن باب القياس. لكن ذاك قياس مستوٍ، وهذا قياس عكس، وسبق أنَّه جاء مرفوعًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلم يحتج لمفهوم ولا قياس.
المذهب الثاني: نَفْي حُجيته، وإليه ذهب أَبو حنيفة وأصحابه، ووافقهم من أصحابنا ابن سريج والقفال وأَبو بكر الفارسي وطوائف مِن المالكية، ونقله الإمام في "المعالم" عن مالك، لكن القاضي عبد الوهاب في "الملخص" نقل عن أصحاب مالك أنَّه حجة وأنه ظاهر قول مالك.
انتهى واختاره الغزالي والآمدي وصاحب"المحصول" على خِلاف ما اختاره في "المعالم".
الثالث قاله الماوردي: التفصيل بين أن يقع ذلك جرابًا لسؤال فلا يكون حجة، أو
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (1181)، صحيح مسلم (92).
الثالث: أنه ليس بحجة مطلقًا. ونُقل عن عيسى بن أبان وأبي ثور، وحكاه القفالُ الشاشي عن أهل العراق، والغزاليُّ عن القدرية، ونقله إمام الحرمين وابن القشيري عن كثير من الشافعية والمالكية والحنفية.
وعن الجبائي وابنه قالوا: لأنَّ اللفظ موضوع للاستغراق، وإنما يخرج عنه بقرينة، ومقدار تأثير القرينة في اللفظ مجهول؛ فيصير مُجْمَلًا.
قال بعض مَن قال به: ويجاب عما قيل مِن عمل الصحابة إما بأن ذلك لقرائن شاهدوها، أو لغير ذلك.
وهو مردود بأن الأصل عدم القرائن.
وربما قَرر بعضهم الدليل بأن التخصيص قد دل على أن العموم غير معمول به، بل يتوقف على دليل.
ولا يخفَى فسادُه؛ فإنَّ الدليل إنما دل على عدم العمل به في المُخْرَج، لا مطلقًا.
الرابع: أنه حُجة إنْ خُص بمتصل كالشرط والاستثناء والصفة، وإنْ خُص بمنفصل فهو مجُمَل في الباقي. حكاه الأستاذ أبو منصور عن الكرخي والبلخي، وكذا نقله في "المعتمد" وأبو بكر الرازي في "أصوله" عن الكرخي.
الخامس: وبه قال أبو عبد الله البصري: إنْ كان لفظ العموم مُنبئًا عما بقي قبل التخصيص كـ {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: 5]، فهو حجة، فإنه يُنبئ عن الحربي كما يُنبئ عن المستأمن. وإنْ لم يكن مُنبئًا، فليس بحجة، كـ {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} [المائدة: 38]، فإنه لا ينبئ عن النِّصاب والحِرْز. فإذا انتفى العمل به عند عدم النصاب والحرز، لم يُعمل به عند وجودهما.
السادس قول عبد الجبار: حُجة إنْ كان لا يتوقف على البيان، كَـ "المشركين"، فإنه بيِّن
قال: لأن كونه نَجسًا يناسب إذلاله، وكونه يُقابَل في البيع بِعوَض يقتضي إعزازه، والجمع بينهما متعذر. فهذا وإنْ تُخيِّلَت مناسبته أولًا لكن يتبين خلاف ذلك؛ إذِ المَعْنِي بكونه نجسًا مَنعْ الصلاة معه، فإنَّ ذلك مِن جُملة أحكام النجس، وحينئذٍ فالتعليل بكون النجاسة تناسب الإذلال ليس بإقناعي.
نعم، قد يمثَّل له بمن وكّل في شراء عبد من عبدين أو ثلاثة فإنه يصح؛ لأنه غرر قليل تدعو الحاجة إليه، فَأَشْبَه خيار الثلاث، فإن الرؤساء لا يحضرون الأسواق لاختيار المبيع، فيشتري الوكيل واحدًا مِن ثلاثة، ويختار الموكل ما شاء. فهذا وإنْ تُخيِّلَت مناسبته أولًا فعند التأمل يظهر أنه غير مناسب؛ لأنه يمكن أن يشتري ثلاثة في ثلاثة عقود بشرط الخيار، فيختار الموكل منها ما يريد. والله أعلم.
ص:
831 - فَإنْ يَكُنْ مُنَاسِبٌ قَدِ [اعْتُبرْ] (¬1) ... بِنَصٍّ اوْ إجْمَاعِهِمْ حَيْثُ أُثِرْ
832 - في عَيْنِ حُكْمٍ عَيْنُ وَصْفٍ، [سَمِّ] (¬2) ... "مُؤثّرا"، وَغَيْرَهُ في الرَّسْمِ
833 - "مُلَاِئمًا"، أَمَّا الَّذِى لَمْ يُعْتَبر ... وَجَاءَ بِالْإلْغَا دَلِيلٌ مُعْتَبَرْ
834 - فَلَيْسَ عِلَّةً، وَمَا لَا يُلْغَى ... فَذَاكَ "مُرْسَلٌ" يَكُونُ مُلْغَى
الشرح: لا بُدَّ في كون الوصف المناسب المعلَّل به [معتبَرًا] (¬3) أنْ يُعْلَم مِن [الشارع] (¬4)
¬__________
(¬1) في (ت): اعتبره
(¬2) في (ض، س): اسم.
(¬3) من (ت، س).
(¬4) كذا في (ص، ق)، لكن في سائر النسخ: الشرع.