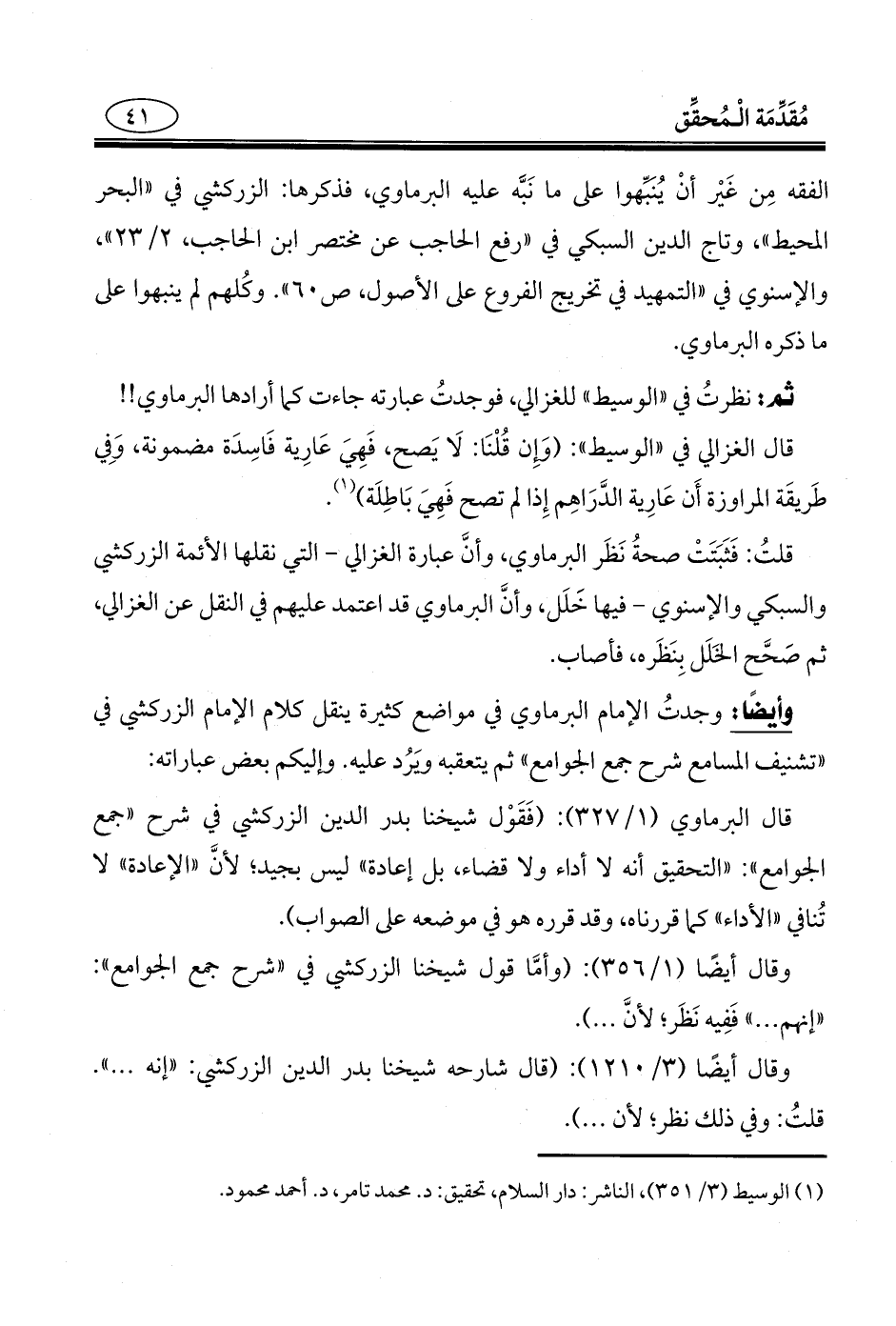
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية
الفقه مِن غَيْر أنْ يُنَبِّهوا على ما نَبَّه عليه البرماوي، فذكرها: الزركشي في "البحر المحيط"، وتاج الدين السبكي في "رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، 2/ 23"، والإسنوي في "التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، ص 60". وكُلهم لم ينبهوا على ما ذكره البرماوي.ثم: نظرتُ في "الوسيط" للغزالي، فوجدتُ عبارته جاءت كما أرادها البرماوي! !
قال الغزالي في "الوسيط": (وَإِن قُلْنَا: لَا يَصح، فَهِيَ عَارِية فَاسِدَة مضمونة، وَفي طَريقَة المراوزة أَن عَارِية الدَّرَاهِم إِذا لم تصح فَهِيَ بَاطِلَة) (¬1).
قلتُ: فَثَبَتَتْ صحةُ نَظَر البرماوي، وأنَّ عبارة الغزالي - التي نقلها الأئمة الزركشي والسبكي والإسنوي - فيها خَلَل، وأنَّ البرماوي قد اعتمد عليهم في النقل عن الغزالي، ثم صَحَّح الخَلَل بِنَظَره، فأصاب.
وأيضًا: وجدتُ الإمام البرماوي في مواضع كثيرة ينقل كلام الإمام الزركشي في "تشنيف المسامع شرح جمع الجوامع" ثم يتعقبه ويَرُد عليه. وإليكم بعض عباراته:
قال البرماوي (1/ 327): (فَقَوْل شيخنا بدر الدين الزركشي في شرح "جمع الجوامع": "التحقيق أنه لا أداء ولا قضاء، بل إعادة" ليس بجيد؛ لأنَّ "الإعادة" لا تُنافي "الأداء" كما قررناه، وقد قرره هو في موضعه على الصواب).
وقال أيضًا (1/ 356): (وأمَّا قول شيخنا الزركشي في "شرح جمع الجوامع": "إنهم ... " فَفِيه نَظَر؛ لأنَّ ... ).
وقال أيضًا (3/ 1210): (قال شارحه شيخنا بدر الدين الزركشي: "إنه ... ". قلتُ: وفي ذلك نظر؛ لأن ... ).
¬__________
(¬1) الوسيط (3/ 351)، الناشر: دار السلام، تحقيق: د. محمد تامر، د. أحمد محمود.
قال الماوردي ومن بعده: (لا يراعى فيه عدالة المخبر، وإنما يراعى سكون النفْس إلى خبره، فيقبل من كل بر وفاجر، ومسلم وكافر، وحر وعبد، فإذا قال الواحد منهم: "هذه هدية فلان إليك"، أو: "هذه الجارية وهبها فلان لك"، أو: "كنت أمَرتَه بشرائها فاشتراها"، كُلِّف المخبَر قبول قوله إذا وقع في نفسه صِدقه، ويحل له الاستمتاع بالجارية والتصرف في الهدية، وكذا الإذن في دخول الدار. وهذا شيء متعارَف في الأمصار مِن غير نكير) (¬1).
ويلتحق بذلك خبر الصبي فيه على الصحيح.
قلت: وعَدُّ هذا ونحوه من المعاملات الدنيوية فيه نظر، وإنما ينبغي أن يكون قِسمًا من الديني وقع فيه الإجماع؛ لاطِّراد العادات فيه والتعارف، وإلا فأكل الهدية والتصرف فيها ووطء الجارية حُكم شرعي، ويرشد إلى ما قُلتُه أن الفتوى والشهادة إجماع مع أنهما من الديني أيضًا؛ ولذلك أشار الشافعي في الاستدلال بحمل ما سواهما من الديني عليهما؛ إذْ لا فارق، وذلك أنه لَمَّا صنف كتابًا في إثبات العمل بخبر الواحد، أوسع فيه الباع، وساق فيه نحو الثلاثمائة حديث عُمِل فيها بخبر الواحد.
قال بعد ذلك: ومَن الذي يُنكر خبر الواحد والحكام آحاد والمفتون آحاد والشهود آحاد؟ !
وقد افتتح الشافعي كت هذا الكتاب بحديث: "رحم الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها" (¬2). الحديث المشهور.
ظ عترض ابن داود بأنه أثبت خبر الواحد بخبر الواحد، فقال أصحابه: إن ما قاله
¬__________
(¬1) الحاوي الكبير (16/ 86).
(¬2) سنن الترمذي (2656)، سنن ابن ماجه (رقم: 230) وغيرهما، ولفظ ابن ماجه: (نَضَّرَ الله امْرَأً سمع مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا). قال الألباني: صحيح. (صحيح سنن الترمذي: 2656).
ابتداءً فيكون حُجة؛ لأنه لا بُدَّ لتخصيصه بالذكر من موجِب، فلَمَّا خرج عن الجواب، ثبت وروده للبيان. قال: (وهذا هو الظاهر مِن مذهب الشَّافعي وقول جمهور أصحابنا) (¬1).
قيل: وينبغي أن لا يُعد هذا مذهبًا ثالثًا؛ لأنَّ مِن شرط القول بالمفهوم في الأصل أن لا يظهر للتخصيص بالذِّكْر فائدة غَيْر نَفْي الحكم.
الرِّبَا: قول إمام الحرمين في "البرهان" (¬2) بالتفصيل بين:
- أن يكون الوصف مناسبًا، فيكون حُجة، نحو: "في الغنم السائمة الزكاة"، فإنَّ خفة المؤونة مناسبة للمواساة بالزكاة.
- وبين ما لا مناسبة فيه، فلا، نحو: "الإنسان الأبيض ذو إرادة".
قال ابن السمعاني: (وهو خلاف مذهب الشَّافعي، فإن العِلة ليس مِن شرطها الانعكاس) (¬3).
لكن الإمام قد أورد هذا على نفسه، وأجاب بأن قضية اللسان هي الدالة عند إحالة الوصف على ما عداه بخلافه. وقال: إن هذا وضع اللسان ومقتضاه، بخلاف العِلل المستنبطة.
الخامس: قول البصري، وهو أَبو عبد الله كما حكاه عنه صاحب "المعتمد" أنَّه حُجة في ثلاث صور:
إحداها: أن يكون الخطاب وَرَد للبيان، كالسائمة في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "في الغنم السائمة زكاة"، فإنه ورد بيانًا لآية الزكاة.
¬__________
(¬1) الحاوي الكبير (16/ 68).
(¬2) البرهان في أصول الفقه (1/ 309 - 310).
(¬3) قواطع الأدلة في أصول الفقه (2/ 163).
في الذمي قَبْل إخراجه، بخلاف نحو: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ} [الأنعام: 73] فإنه مفتقر إلى البيان قبل إخراج الخاص من عموم اللفظ؛ ولذلك بَيَّنه - صلى الله عليه وسلم - وقال: "صَلُّوا كما رأيتموني أصلي" (¬1).
السابع: أنه حُجة في أقَل الجمع، اثنين أو ثلاثة على الخلاف السابق، لا فيما زاد. حكاه القاضي والغزالي وابن القشيري، وقال: إنَّه تَحكُّمٌ. وقال الهندي: (لعله قول مَن لا يُجوِّز التخصيص إليه) (¬2).
الثامن: وحكاه الغزالي في "المنخول" عن أبي هاشم: أنه يُتمسَّك به في واحد، ولا يُتمسك به في جمع.
التاسع: الوقف، فلا يُقضَى بأنه خاص أو عام إلا بدليل. حكاه ابن القطان وجعله مُغايرًا لقول ابن أبان بعد أن نقل عنه القول بأن الباقي على الخصوص. لكن على كل حالٍ لا يخرج عن الثمانية السابقة.
نعم، مَن يقول: (إنه مُجْمَل) اختلفوا كما قال الشيخ أبو حامد: هل هو مجمل من حيث اللفظ والمعنى فإنه لا يُعقل المراد من ظاهره إلا بقرينة؟ أو مجمل من حيث المعنى فقط؟ وجهان لأصحابنا، الأكثرون على الثاني؛ لافتقار العام المخصوص لقرينة تُبَين ما هو مراد به، وافتقار العام المراد به خاص إلى قرينة تُبيِّن ما ليس مرادًا به.
فتزيد المذاهب.
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.
(¬2) نهاية الوصول (4/ 1488).
التفات إليه، ويظهر ذلك بتقسيم المناسب. وهو ينقسم إلى: مُؤَثِّر، وملائِم، وغريب، ومُلْغًى، ومُرْسَل.
لأنه إما أنْ يُعْلَم أن الشرع اعتبره، أو يُعْلم أنه ألغاه، أو لا يُعلم أنه اعتبره ولا ألغاه.
والمراد بالعِلم هنا ما هو أعم مِن اليقين والظن، وذلك إما بالنص أو الإجماع.
والمراد بِ "اعتبار الشرع" أنْ يورد الفروع على وَفْقه، لا أنْ يَنُصَّ على العلة أو يُومئ إليها، هالا لم تكن العِلية مستفادة بالمناسبة.
فإنْ عُلم أن الشارع اعتبره، فهو على أربعة أقسام:
- إما أنْ يُعْلَم بالنص أو بالإجماع أنه اعتبر عَيْن الوصف في عَيْن الحكم (والمراد بِالعَيْن: النوع، لا المشخص مِن النوع).
- أو أنه اعتبر عَيْن الوصف في جِنس الحكم.
- أوجنس الوصف في عَيْن الحكم.
- أو جنسه في جنسه.
فالأول - وهو ما اعتبر نوعه في نوعه - إنِ اعتبر مع ذلك جنسه في جنسه، سُمِّي "المُؤَثِّر"؛ لحصول التأثير فيه عيْنًا وجنسًا، هالا فيُسمى "الغريب". ولم أتعرض له في النَّظم؛ لأنه لا يُعَلَّل به اتفاقًا.
وأما الثلاثة الأخرى فتسمى "الملائم"؛ لكونها موافقة لِمَا اعتبره الشرع. أي: [ما] (¬1) دل عليه النص أو الإجماع. أي: دل على إيراد الفروع على وَفْق ذلك، لا النص أو الإجماع أنَّ هذا عِلةُ هذا، فإن ذلك ليس مِن المناسبة كما سبق تقريره.
¬__________
(¬1) كذا في (ص)، لكن في (ق، س): مما.