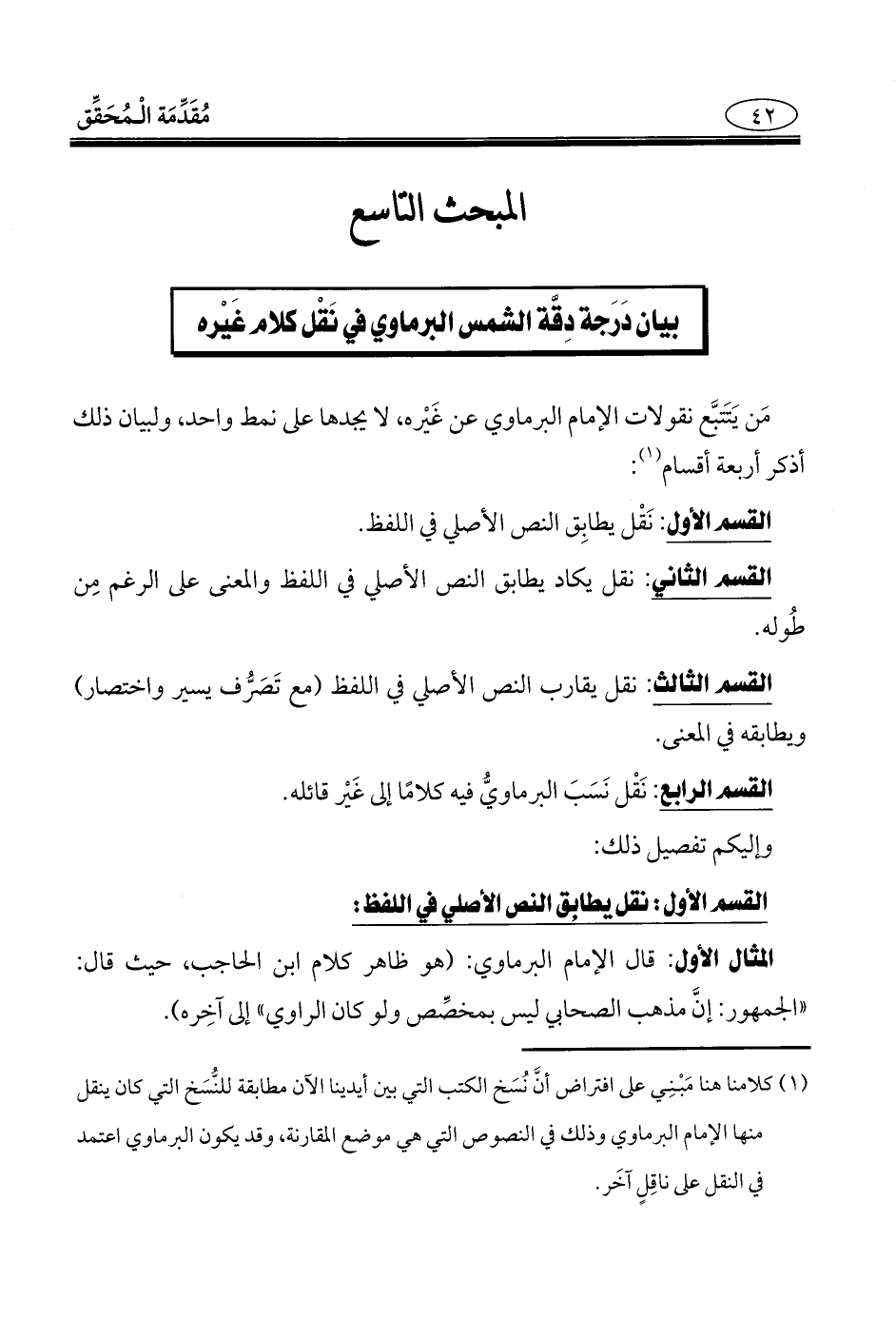
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية
المبحث التاسع: بيان دَرَجة دِقَّة الشمس البرماوي في نَقْل كلام غَيْرهمَن يَتَتبَّع نقولات الإمام البرماوي عن غَيْره، لا يجدها على نمط واحد، ولبيان ذلك أذكر أربعة أقسام (¬1):
القسم الأول: نَقْل يطابِق النص الأصلي في اللفظ.
القسم الثاني: نقل يكاد يطابق النص الأصلي في اللفظ والمعنى على الرغم مِن طُوله.
القسم الثالث: نقل يقارب النص الأصلي في اللفظ (مع تَصَرُّف يسير واختصار) ويطابقه في المعنى.
القسم الرابع: نَقْل نَسَبَ البرماويُّ فيه كلامًا إلى غَيْر قائله.
وإليكم تفصيل ذلك:
القسم الأول: نقل يطابِق النص الأصلي في اللفظ:
المثال الأول: قال الإمام البرماوي: (هو ظاهر كلام ابن الحاجب، حيث قال: "الجمهور: إنَّ مذهب الصحابي ليس بمخصَّص ولو كان الراوي" إلي آخِره).
¬__________
(¬1) كلامنا هنا مَبْنِي على افتراض أنَّ نُسَخ الكتب التي بين أيدينا الآن مطابقة للنُّسَخ التي كان ينقل منها الإمام البرماوي وذلك في النصوص التي هي موضع المقارنة، وقد يكون البرماوي اعتمد في النقل على ناقِلٍ آخَر.
باطل؛ لأن الشافعي - رضي الله عنه - إنما استدل بما تضمنه مجموع ما ذكره من الأحاديث، وسنشير إلى بعض شيء منها.
وحاصل ما في العمل بخبر الواحد في الأمور الدينية من الخلاف المنتشر المشهور أقوال:
أحدها: أن العمل به جائز عقلًا، وواجب سمعًا. وهو قول الجمهور. قال أبو العباس ابن القاص: لا خلاف بين أهل الفقه في قبول خبر الآحاد، وإنما دفع بعض أهل الكلام خبر الآحاد لعجزه عن السُّنن، زعم أنه لا يقبل منها إلا ما تواتر بخبر مَن لا يجوز عليه الغلط والنسيان، وهذا ذريعة إلى إبطال السُّنن، فإنَّ ما شَرَطَه لا يكاد يوجد إليه سبيل.
وقد استدل الشافعي بقضية أهل قباء لَمَّا أتاهم آتٍ وقال: إن القبلة قد حولت. فرجعوا إليه (¬1)، وبإرساله - صلى الله عليه وسلم - عماله واحدًا بعد واحد؛ ليخبروا الناس بالشرائع. وبسط كلامه في ذلك في "الرسالة" بسطًا شافيًا.
ومما احتجوا به أيضًا قوله تعالى: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6]، وقوله تعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ} [التوبة: 122]، وغير ذلك من الأدلة.
ولسنا بصدد ذلك في هذا الشرح المختصر، فأصحاب هذا القول اتفقوا على أن الدليل السمعي دل عليه من الكتاب والسُّنة وعمل الصحابة ورجوعهم كما ثبت ذلك بالتواتر. واختلفوا في أن الدليل العقلي هل دَلَّ على وجوب العمل مع ذلك؟ أم لا؟
فالأكثرون على المنع، وهو معنى قولي في النظم: (سَمْعًا) أيْ: فقط؛ إذ مفهومه أنه لا يُعمل به بغير السمع.
وذهب الأقلون إلى أن العقل دل أيضًا، فنقل ذلك عن أحمد وابن سريج والصيرفي
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (رقم: 4216)، صحيح مسلم (رقم: 527).
الثانية: أن يكون ورد للتعليم، أي: الابتداء بما لم يَسْبق حُكمه لا مُجْمَلًا ولا مُبَيَّنًا، كحديث: "إذا اختلف المتبايعان، تحالفا" (¬1)، فإنَّ في رواية: "إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة، تحالفا" (¬2) مفهومه أن السلعة إذا لم تكن قائمة، لا تحالف، وهو من مفهوم الحال الآتي
¬__________
(¬1) قال الحافظ ابن الملقن في (البدر المنير، 6/ 597 - 605): (هَذِه رِوَايَة غَرِيبَة عَلَى هَذَا النمط لم أرها كَذَلِك فِي شَيْء من كُتب الحدِيث ... ، نعم "التراد" بِدُونِ التَّحْلِيف ورد فِي هَذَا الحدِيث من طُرق).
ثم ذكر هذه الطرق، وقال: (فَهَذَا مَا حَضَرنَا من طُرق هَذَا الحدِيث وَاخْتِلَاف أَلْفَاظه ... ، وَبِالجمْلَةِ وَكُل طرق هَذَا الحدِيث لَا تَخْلُو من عِلّة).
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في (التلخيص الحبير، 3/ 13): (أَمَّا رِوَايَةُ التَّحَالُفِ فَاعْتَرَفَ الرَّافِعِيُّ فِي "التَّذْنِيبِ" أنَّهُ لَا ذِكْرَي فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الحْدِيثِ، وَإِنَّمَا تُوجَدُ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ).
وقال الألباني في (إرواء الغليل: 1322): (قد ذكر المؤلف رحمه الله في ألفاظ الحديث: "تحالفا" ولم أره فى شيء من هذه الطرق، والظاهر أنَّه مما لا أصل له).
قلتُ: في سنن الدَّارَقُطني (3/ 18)، سنن البيهقي الكبرى (رقم: 10591) واللفظ للبيهقي: (إذَا اخْتَلَفَ الْمُتبَايِعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُما شَاهِد، اسْتُحْلِفَ الْبَائِعُ). وقال الإمام البيهقي: (هذا الحديث أيضًا مُرْسَل؛ أَبو عبيدة لَمْ يُدْرِك أباه).
(¬2) المعجم الكبير للطبراني (رقم: 10365) بلفظ: (إذا اخْتَلَفَ المتبايِعَانِ وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ بعينها فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ أو يَتَرَادَّانِ). ونحوه في المعجم الأوسط (4/ 105، رقم: 3720).
قال الحافظ ابن الملقن في (البدر المنير، 6/ 605): (كل طُرُق هذا الحديث لا تخلو من علة).
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في (التلخيص الحبير، 3/ 32) بعد أنْ ذكر رواية "المعجم الأوسط": (انْفَرَدَ بِهَذ الزِّيَادَةِ - وَهِيَ قَوْلُهُ: "وَالسِّلْعَةُ قَائِمَة" - ابْنُ أَبِي لَيْلَى. . وَهُوَ ضَعِيفٌ سيء الحفْظِ، وَأُمَّا قَوْلُهُ فِيهِ: "تحَالَفَا" فَلَمْ يَقَعْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْهُمْ، وَإِنَّمَا عِنْدَهُمْ: "وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيعَ").
وقال الألباني في (إرواء الغليل: 1322) بعد أن ذكر إسناد رواية "المعجم الكبير": (رجاله ثقات رجال الشيخين غير النرسى والعطار، فلم أعرفهما).
تنبيهات
الأول: محل هذا الخلاف -كما ذكرنا- في العام المخصوص، أما المراد به خاص فلا يصح الاحتجاج بظاهره كما قاله الشيخ أبو حامد في "كتاب البيع" من "تعليقته"، وفيه ما يدل على أنَّ ابن أبي هريرة قاله أيضًا.
قلتُ: وهو مُشْكل؛ لأن المراد إنْ كان الاحتجاج به في الخاص الذي أُريدَ به فلا يُتصور فيه خلاف، أو فيما عدَاه فليس مرادا قطعًا، فكيف يُستدَل بالعام عليه؟ !
الثاني: قد ذكرنا أن الخلاف في هذه المسألة مُفرَّع على التي قبلها.
نعم، مَن جوَّز التعلق به مع كونه مجازًا -كالقاضي- يبقى الخلاف على قوله لفظيًّا كما قاله أبو حامد وغيره؛ لأنه هل يُحتج به ويُسمَّى مجازًا؟ أو لا يُسمى مجازًا؟
وقال صاحب "الميزان" (¬1) -من الحنفية- أنَّ المسألة مُفرَّعة على أن دلالة العام على أفراده قطعية؟ أو ظنية؟ فمَن قال: قطعية، جعل الذي خُص كالذي لم يُخص.
قيل: وفيه نظر.
وقيل: مُفرَّعة على أن اللفظ العام هل يتناول الجنس؟ أوْ لا وتندرج الآحاد تحته؛ ضرورةَ اشتماله عليها؟ أو يتناول الآحاد واحدًا واحدًا حتى يستغرق الجنس؟
فالمعتزلة قالوا بالأول، فعند الإطلاق يظهر عمومه، فإذا خُص، تبيَّن أنه لم يُرد العموم. وعند إرادة عدم العموم ليس بعض أَوْلى مِن بعض، فيكون مجمَلًا.
الثالث: قولي: (وَلَوْ مُنْفَصِلًا مِنْهُ عُنِي أَوْ لَمْ يَكُنْ عُمُومُهُ قَدْ أَنْبَأَ عَنْهُ) تَعريضٌ ببعض ما
¬__________
(¬1) ميزان الأصول في نتائج العقول (ص 290 - 292).
أما لو دَلَّ على الاعتبار بمعنى الموافقة والإيماء والتنبيه ففيه خلاف: هل هو من المؤثر؟ أو من الملائم؟ حكاه الهندي.
وأما ما عُلم أن الشرع ألغاه فهو مُلْغًى بلا خلاف. وما لم يُعْلم هل اعتبره الشرع؟ أو لا؟ هو المسمى بـ "المُرْسَل".
وقبل الكلام على هذه الأقسام وأمثلتها نقول: كُل مِن الوصف والحكم نوع، وما هو أَعَم منه جِنس، وله مراتب: عالٍ، وسافل، ومتوسط.
والعبرة دائمًا بالأسفل القريب مِن العَين في الوصف وفي الحكم.
فأعم الأوصاف وصف يُناط به الحكم، ثم كونه مناسبًا، ثم كونه -مثلًا- ضروريًّا، ثم كونه لحفظ النفوس.
وأَعَم أجناس الحكم كَوْنه حُكمًا شرعيًّا، ثم كونه واجبًا، ثم كونه عبادة، ثم كونه صلاة، ثم كونه ظهرًا.
إذا عُلِم ذلك:
فمثال "المؤثر" الذي دل على اعتبار عين الوصف [فيه] (¬1) في عين الحكم: نفس السُّكْر عِلة للتحريم في الخمر، اعتبر عَيْنه في عَين الحكم وهو التحريم حيث حرم الخمر، فيلحق به النبيذ.
ونحوه: مَس الذكر، اعتبر عينه في عين الحكم، وهو الحدث؛ لحديث: "مَن مس ذكره فليتوضأ" (¬2).
¬__________
(¬1) كذا في (ص، ق)، وفي سائر النسخ: منه.
(¬2) مسند أحمد (7076)، سنن أبي داود (رقم: (181)، وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (صحيح أبي=