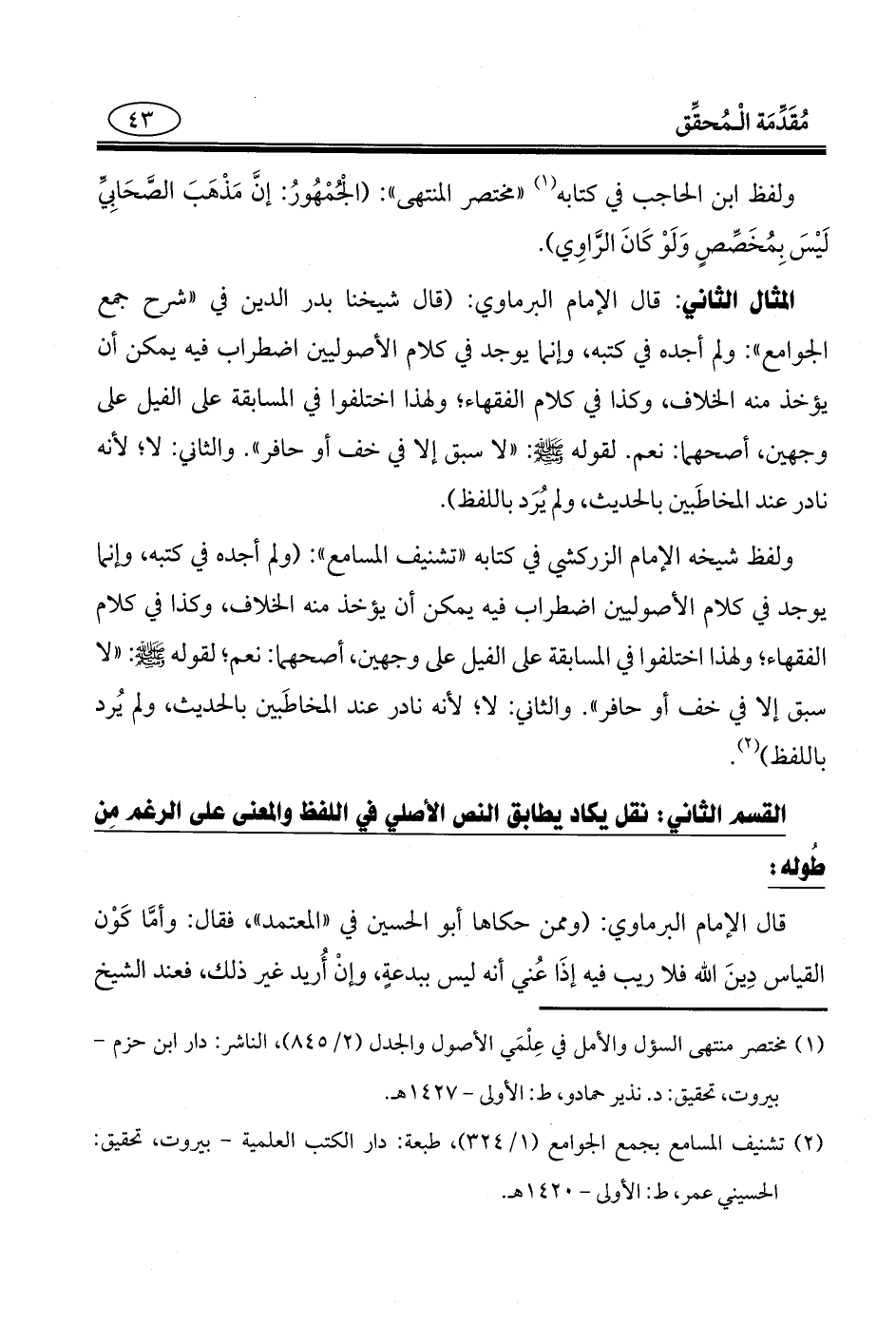
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية
ولفظ ابن الحاجب في كتابه (¬1) "مختصر المنتهى": (الْجُمْهُورُ: إنَّ مَذْهَبَ الصَّحَابِيِّ لَيْسَ بِمُخَصِّصٍ وَلَوْ كَانَ الرَّاوِي).المثال الثاني: قال الإمام البرماوي: (قال شيخنا بدر الدين في "شرح جمع الجوامع": ولم أجده قي كتبه، وإنما يوجد في كلام الأصوليين اضطراب فيه يمكن أن يؤخذ منه الخلاف، وكذا في كلام الفقهاء؛ ولهذا اختلفوا في المسابقة على الفيل على وجهين، أصحهما: نعم. لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا سبق إلا في خف أو حافر". والثاني: لا؛ لأنه نادر عند المخاطَبين بالحديث، ولم يُرَد باللفظ).
ولفظ شيخه الإمام الزركشي في كتابه "تشنيف المسامع": (ولم أجده في كتبه، وإنما يوجد في كلام الأصوليين اضطراب فيه يمكن أن يؤخذ منه الخلاف، وكذا في كلام الفقهاء؛ ولهذا اختلفوا في المسابقة على الفيل على وجهين، أصحهما: نعم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا سبق إلا في خف أو حافر". والثاني: لا؛ لأنه نادر عند المخاطَبين بالحديث، ولم يُرد باللفظ) (¬2).
القسم الثاني: نقل يكاد يطابق النص الأصلي في اللفظ والمعنى على الرغم مِن طُوله:
قال الإمام البرماوي: (وممن حكاها أبو الحسين في "المعتمد"، فقال: وأمَّا كَوْن القياس دِينَ الله فلا ريب فيه إذَا عُني أنه ليس ببدعةٍ، وإنْ أُريد غير ذلك، فعند الشيخ
¬__________
(¬1) مختصر منتهى السؤل والأمل في عِلْمَي الأصول والجدل (2/ 845)، الناشر: دار ابن حزم - بيروت، تحقيق: د. نذير حمادو، ط: الأولى - 1427 هـ.
(¬2) تشنيف المسامع بجمع الجوامع (1/ 324)، طبعة: دار الكتب العلمية - بيروت، تحقيق: الحسيني عمر، ط: الأولى - 1420 هـ.
والقفال - مِنَّا - وأبي الحسين البصري من المعتزلة.
قالوا: لاحتياج الناس إلى معرفة بعض الأشياء من جهة الخبر، وفي ترك ذلك أعظم الضرر، ولأن العمل به يفيد دفع ضرر مظنون؛ فكان العمل به واجبًا، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - مبعوث إلى جميع الناس ولا يمكن مشافهة الكل، فلا بُدَّ من بعث الرُّسل، وإرسال عدد التواتر لكل الأقطار قد يتعذر؛ فلا يَلزم ذلك، فوجب قطعًا أن يُكتفَى بالآحاد.
وذكروا نحو ذلك مما لا ينتهض - عند التأمل - أن يدل عقلًا.
وقد استغرب عزو ذلك إلى غير أبي الحسين المعتزلي مع أنهم أئمة أهل السُّنة، فقيل: لأن القفال كان أول أمره معتزليًّا، فَلَعَلَّه قال ذلك وقت اعتزاله، وابن سريج كان يناظر ابن داود، فلعله بالغ في الرد عليه؛ فَتُوُهِّم منه هذا القول.
وأما أحمد - رضي الله عنه - فيمكن الاعتذار عنه بأنه أراد أنه ليس في العقل ما يمنع العمل به، أو قصد ما هو معلوم من أن الأدلة النقلية لا تخلو عن مقدمة عقلية في الدلالة وإنْ كانت محذوفة؛ للعلم بها، فلا منع أنْ يُصرِّح بها عند وجود المعاند. وربما يُعتذَر عن الجميع بذلك.
ومَن قال بهذا فوجوب العمل به عنده قطعي، ومَن قال بالأول فكذلك أيضًا؛ لأن ما استدلوا به مقطوع به بالضرورة.
قال ابن دقيق العيد: والحقُّ عندنا في الدليل - بعد اعتقاد أن المسألة عِلمية - أنَّا قاطعون بعمل السلف والأُمة بخبر الواحد، وهذا القطع حصل لنا من تتبعُّ الشريعة وبلوغ جزئيات لا يمكن حصرها، ومَن تتبَّع أخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة والتابعين وجمهور الأُمة - ما عدا الفِرقة اليسيرة المخالفة - عَلِم ذلك قطعًا.
واعْلَم أن إمام الحرمين أول "البرهان" قال: (إنَّ إطلاق وجوب العمل بخبر الواحد فيه تساهُل؛ لأن نفس الخبر لو أوجب العمل لَعُلِم ذلك منه، وهو لا يثمر عِلمًا، وإنما وجب
بيانها من أقسام الصفة. كذا أورده وقرره أَبو الحسين [البصري] (¬1) في "شرح المعتمد". والحديث بهذه الزِّيادة رواه الدَّارَقُطني بإسناد ضعيف.
الثالثة: أن يكون ما عدا الصفة داخلًا تحتها، كالحكم بالشاهدين؛ لأن المفهوم - وهو الشاهد الواحد - داخل تحت لفظ "الشاهدين".
ومثله: حديث القلتين، فإن القُلة الواحدة داخلة تحت القُلتين، أي: فلو لم يكن الحكم في الواحد مخالفًا، لَمَا كان لِذِكْر الاثنين فائدة.
ويخرج مما سيأتي في أقسام الصفة مذاهب أخرى، ويجري بعض هذه المذاهب أيضًا في غير مفهوم الصفة كما سنشير إليه في كل واحد.
تنبيهات
أحدها: قد سبق أن المراد بالصفة أَعم مِن النعت النحوي وغيره، لكن إذا كان نعتًا فإِنما يكون له مفهوم حيث سِيق للتخصيص، ويكثر ذلك في النكرات، نحو: "رجل صالح"، أو للتوضيح وهو في المعارف، وربما تَردد بين الأمرين واحتملهما، كقوله تعالى: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} [النحل: 75]، فيحتمل:
- أن يكون للتخصيص، فيكون حجة للمالكية (وهو القديم عندنا) أن العبد يملّك بتمليك السيد.
- وأن يكون للتوضيح، أي: شأنه أن لا يَقدر على شيء. فيكون حجة للجديد من مذهبنا أنَّه لا يملك.
¬__________
(¬1) من (ز).
سبق في المسألة الأخيرة مِن الأقوال، وقد أوضحناها.
وقولي: (وَأَمَّا إنْ يَكُنْ قَدْ بُدِئَ) إلى آخِره فهو إشارة إلى ما فُرِّق به بين العام المخصوص والمراد به الخصوص.
وقولي: (أُطْلِقَ لِلَّذِي هُوَ الْجُزْئِيُّ) أي: مقصورًا عليه، وإلا فقد سبق أن مِثْل ذلك حقيقة. وهذا أصوب مِن التعبير بأنه كُلٌّ أُطلق على البعض؛ لأنَّ العموم في أفراده مِن قبيل الكلي مع جزئياته كما سبق تقريره غير مَرَّة، والله أعلم.
ص:
622 - وَبِالْعُمُومِ قَبْلَ أَنْ يُبْحَثَ عَنْ ... تَخْصِيصِهِ تَمَسُّكٌ لِمَنْ فَطَنْ
623 - أَيْ في حَيَاةِ الْمُصْطَفَى مُحَمَّدِ ... صَلَّى عَلَيْهِ اللهُ مِنْ مُمَجَّدِ
624 - كَذَاكَ بَعْدَهُ، وَحَيْثُ شُرِطَا ... فَالظَّنُّ كافٍ فِيهِ فِيمَا ضُبِطَا
الشرح:
من مباحث التخصيص أيضًا أن العام هل يجوز التمسك به قبل البحث عن مخصِّص له؟ أو لا يجوز؛ لأنَّ العمومات التي لم يَطْرقها تخصيص نادرة فلا بُدَّ مِن البحث عن المخصِّص قَبْلَ العمل؟ فيه خلاف.
قال الأستاذ أبو إسحاق: محلُّه بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، أما في حياته فلا خلاف في وجوب المبادرة إلى الأخذ به وإجرائه على عمومه؛ لأن أصول الشريعة لم تكن متقررة؛ لجواز أن يحدث بعد ورود العام مخصِّصٌ وبَعد النص نسخٌ، فلا يفيد البحث عن ذلك شيئًا.
وحاصل الخلاف فيما بعده - صلى الله عليه وسلم - مذهبان:
أحدهما وبه قال الصيرفي ومَالَ إليه إمام الحرمين وغيره: وجوب العمل قبل البحث،
ومثال "الغريب" -وسمي بذلك لأنه لم يشهد له غير أصله بالاعتبار- الطعم في الربا، فإنَّ نوع الطعم مؤثِّر في حُرمة الربا، وليس جنسه مؤثرًا في جنسه.
وأما الثلاثة الأخرى فتسمَّى الملائم؛ لكونها موافقة لِمَا اعتبره الشرع.
فمثال ما اعتبر الشرع عَيْن الوصف فى جنس الحكم: امتزاج النسبين في الأخ مِن الأبوين، اعتُبِر في تقديمه على الأخ مِن الأب في الإرث، وقِسْنَا عليه تقديمه عليه في ولاية النكاح وفي الصلاة ونحوها في الميت وتحمُّل العقل وغير ذلك من الأحكام، فإنه وإنْ لم يعتبره الشرع في عَيْن هذه الأحكام لكن اعتبره في جنسها وهو التقدُّم في الجملة.
ومثال ما اعتُبر فيه جنس الوصف فى عين الحكم: المشقة المشتركة بين الحائض والمسافر في سقوط القضاء، فإن الشارع اعتبرها في عَيْن سقوط القضاء في الركعتين من الرباعية، فسقط بها القضاء في صلاة الحائض؛ قياسًا. وإنما جُعِل الوصف هنا جنسًا والإسقاط نوعًا؛ لأنَّ مشقة السفر نوع مخالف لمشقة الحيض، وأمَّا السقوط فأمر واحد وإنِ اختلفت محالّه.
ومثال ما اعتُبر فيه جنس الوصف فى جنس الحكم: ما رُوي عن علي - رضي الله عنه - في شارب الخمر أنه: "إذا شرب هَذَى (¬1)، وإذا هَذَى افترى؛ فيكون عليه حد المفتري". أي: القاذف. ووافقه الصحابة عليه، فقد أوجبوا حد القذف على الشارب لا لكونه شرب، بل لكون الشرب مظنة القذف، فأقاموه مقام القذف؛ قياسًا على إقامة الخلوة بالأجنبية مقام الوطء في التحريم؛ لكون الخلوة مظنة له. فظهر أن الشارع إنما اعتبر المظنة (التي هي جنس لمظنة الوطء ومظنة القذف) في الحكم (الذي هو جنس لإيجاب حد القذف وحرمة الوطء).
¬__________
=داود: 181).
(¬1) يعني: صَدَر منه الهذيان، وهو كلام غَيْر مَعْقُول. لسان العرب (15/ 360).