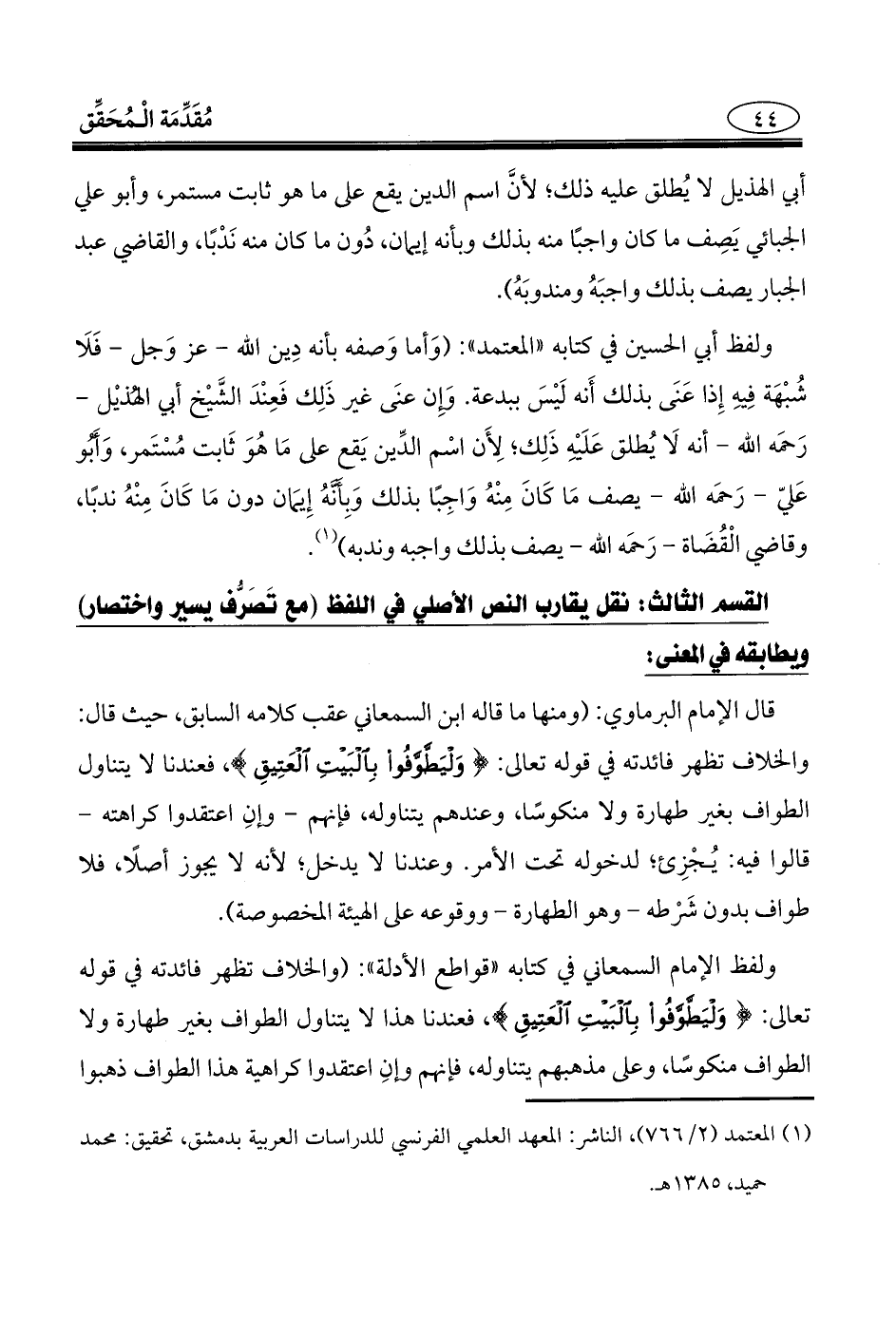
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية
أبي الهذيل لا يُطلق عليه ذلك؛ لأنَّ اسم الدين يقع على ما هو ثابت مستمر، وأبو علي الجبائي يَصِف ما كان واجبًا منه بذلك وبأنه إيمان، دُون ما كان منه نَدْبًا، والقاضي عبد الجبار يصف بذلك واجبَهُ ومندوبَهُ).ولفظ أبي الحسين في كتابه "المعتمد": (وَأما وَصفه بأنه دِين الله - عز وَجل - فَلَا شُبْهَة فِيهِ إِذا عَنَى بذلك أَنه لَيْسَ ببدعة. وَإِن عنَى غير ذَلِك فَعِنْدَ الشَّيْخ أبي الهُذيْل - رَحمَه الله - أنه لَا يُطلق عَلَيْهِ ذَلِك؛ لِأَن اسْم الدِّين يَقع على مَا هُوَ ثَابت مُسْتَمر، وَأَبُو عَليّ - رَحمَه الله - يصف مَا كَانَ مِنْهُ وَاجِبًا بذلك وَبِأَنَّهُ إِيمَان دون مَا كَانَ مِنْهُ ندبًا، وقاضي الْقُضَاة - رَحمَه الله - يصف بذلك واجبه وندبه) (¬1).
القسم الثالث: نقل يقارب النص الأصلي في اللفظ (مع تَصَرُّف يسير واختصار) ويطابقه في المعنى:
قال الإمام البرماوي: (ومنها ما قاله ابن السمعاني عقب كلامه السابق، حيث قال: والخلاف تظهر فائدته في قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}، فعندنا لا يتناول الطواف بغير طهارة ولا منكوسًا، وعندهم يتناوله، فإنهم - وإنِ اعتقدوا كراهته - قالوا فيه: يُجْزِئ؛ لدخوله تحت الأمر. وعندنا لا يدخل؛ لأنه لا يجوز أصلًا، فلا طواف بدون شَرْطه - وهو الطهارة - ووقوعه على الهيئة المخصوصة).
ولفظ الإمام السمعاني في كتابه "قواطع الأدلة": (والخلاف تظهر فائدته في قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}، فعندنا هذا لا يتناول الطواف بغير طهارة ولا الطواف منكوسًا، وعلى مذهبهم يتناوله، فإنهم وإنِ اعتقدوا كراهية هذا الطواف ذهبوا
¬__________
(¬1) المعتمد (2/ 766)، الناشر: المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية بدمشق، تحقيق: محمد حميد، 1385 هـ.
العمل عند سماعه بدليل آخَر وهي الأدلة القطعية على وجوب العمل عند رواية الآحاد. فالتحقيق - وهو قول المحققين - أنه يوجِب العمل عنده، لا بِه) (¬1).
قال: وهكذا القول في العمل بالقياس.
القول الثاني: إنَّ العمل بالآحاد لا يجب وإنْ كان جائزًا عقلًا، ونُقل ذلك عن ابن داود والرافضة، ونقله ابن الحاجب عن [القاساني] (¬2)، لكن سيأتي أنه ممن يقول بمنعه عقلًا، فلا ينبغي أن ينقل عنه هذا المذهب.
واحتجوا لهذا القول بنحو قوله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء: 36]، وقوله تعالى: {إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ} [الأنعام: 116].
وأجيب بأنه محمول على ما يجب فيه العمل باليقين، كالاعتقادات كما سيأتي بيانه.
القول الثالث: إنه لا يجوز العمل به؛ لعدم الدليل على حجيته.
الرابع: إن العمل به غير جائز عقلًا. وهو قول جمهور القدرية وطائفة من الظاهرية كالقاساني وغيره، ونقله ابن الحاجب عن الجبَّائي، لكن الصحيح في النقل عنه تفصيل يأتي ذِكره.
قالوا: لأنه يؤدي إلى تحريم الحلال وتحليل الحرام إذا رُوي كل منهما في محل واحد بالآحاد وكان أحدهما راجحًا. فإن لم يكن ترجيح، أدَّى إلى الجمع بين النقيضين أو الترجيح بلا مرجِّح.
ورُدَّ: بأنَّا إنْ قُلنا: (المصيب من المجتهدين واحد)، فإن كان الراجح هو الحقّ في نفس الأمر فواضح, وإن كان غيره فلَم يُكلَّف إلا بما غلب على ظنه وإن كان خطأ في نفس الأمر،
¬__________
(¬1) البرهان (1/ 388).
(¬2) في (ز، ظ، ش): القاشاني.
وكذا قوله - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا استعار من صفوان بن أمية (إذ قال له صفوان: "أغَصْبًا يا محمد؟ " فقال: "بل عارية مضمونة" (¬1) (يحتمل الإيضاح، أي: إن العارية شأنها ذلك، فهو حُكم العارية مطلقًا، ويحتمل التخصيص، أيْ: إنه شرط فيها الضمان، فلا تكون العارية مضمونة حتَّى يُشرط فيها ذلك، فيكون حجة للحنفية أنَّها لا تُضمن إلَّا بالشرط.
ومثله في الفروع الفقهية: لو قال: (إذا [تظاهرتُ] (¬2) مِن فلانة الأجنبية، فأنتِ عَلَيَّ كظهر أمي)، ثم تزوجها فظاهر منها، هل يصير مُظاهرًا مِن الأُولى؟ وجهان.
أما إذا سِيقَ النعت للتوكيد (نحو: {نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ} [الحاقة: 13]) أو للمدح (كصفات الله تعالى، نحو: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)، أو لمجرد الذم (نحو: الشيطان الرجيم) أو للترحم والتحنن (نحو: انظر لعبدك المسكين)، فهذه كُلها لا مفهوم لها.
ثانيها:
ما سبق مِن مُثُل "مفهوم الصفة" إذا كان هناك اسم تجري عليه الصفة متقدمًا أو متأخرًا على ما قررناه. أما لو ذكر الاسم المشتق بلفظ نحو: "في السائمة الزكاة" فهل هو كالصفة؛ لأن غايته أن الموصوف فيها محذوف؟ أوْ لا مفهوم له؛ لأن "الصفة" إنما جُعِل لها مفهوم لأنه لا فائدة لها إلَّا نَفْي الحكم، والكلام بدونها لا يختل، وأما "المشتق" فكاللقب يختل الكلام بدونه؟
اختلف أصحابنا في ذلك كما حكاه الشيخ أَبو حامد وابن السمعاني وغيرهما.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود (رقم: 3562)، السنن الكبرى للبيهقي (رقم: 11257)، المسند (رقم: 15337). قال الألباني: صحيح. (صحيح أبي داود: 3562).
(¬2) في (ز): ظاهرت.
حتى قال الإمام: إن قول التوقف على البحث غير معدود مِن مباحث العُقلاء و [مُضْطرب العلماء] (¬1)، وإنما هو قول صدر عن غباوة واستمرار في عناد.
ولأجل رجحان الأول عند المحققين واختاره حذاق المتأخرين جريتُ عليه في النَّظم بقولي: (كَذَاكَ بَعْدَهُ)؛ لأنَّ الأصل عدم المخصِّص.
وأيضًا فاحتماله مرجوح، وظاهر العموم راجح، والعمل بالراجح واجب، كما أن احتمال النسخ لا يؤثر في المبادرة بالعمل بالنص؛ ولذلك هَمَّ عثمان - رضي الله عنه - برجم التي ولدت لستة أشهر، وهَمَّ عمر - رضي الله عنه - برجم مجنونة؛ عملًا بظاهر العموم حتى أتاهما عَلِي - رضي الله عنه - بنص خاص يُخصِّص العموم.
الثاني: المنع. وبه قال ابن سريج، وحكاه الشيخان أبو حامد وأبو إسحاق الشيرازي وغيرهما عن عامة أصحابنا سوى الصيرفي، ونقله أبو حامد عن الإصْطَخْري وابن خيران والقفال الكبير.
ثم اختلف القائلون به في أنه هل يكفي في البحث الانتهاء إلى ظن عدم المخصص؟ أو لا بُدَّ من اعتقاد جازم يسكن إليه القلب؟ أو لا بُدَّ من القطع؟ ثلاثة أقوال، أصحها الأول؛ جريًا على الاكتفاء بالظن في مِثله، وبالثالث قال القاضي، قال: (ويحصل ذلك بتكرير النظر والبحث).
¬__________
(¬1) (في (ص، ق): مضطرف.
وبهذا يظهر الجواب عما ذكر فيه مِن إشكال مِن حيث إنَّ تفريع مظنة القذف على مظنة الوطء حقه أنْ يتساويا في الحد كما تَساويَا في التحريم؛ لأنَّ الوفاء بإقامة المظنة مقام المظنون أن يوجَب الحد بالخلوة، ولا قائل به. فصار في جعل الشرب مظنة القذف زيادة وجوب عقوبة ليست موجودة في الأصل الذي هو إلحاق الخلوة بالوطء؛ لأنَّ ذلك إنما هو في الحرمة فقط.
فيقال في جوابه: إنما أخذنا باعتبار الشرع الجنس في جنس الحكم، وجنس الحكم يشمل التحريم والعقوبة وإن تَغايرَا؛ إذ لو اتحد في الموضعين لكان مِن اعتبار الجنس في العين. فَتَأَمَّله.
واعلم أن المراد بالجنس دائمًا هو القريب، لا البعيد.
وأعلى هذه الثلاثة ما أثَّر عين الوصف في جنس الحكم؛ لأنَّ الإبهام في العلة أكثر محذورًا من الإبهام في المعلول، ثم عكسه، ثم الجنس في الجنس.
وأقسام "الملائم" كلها يسوغ التعليل بها عند الجمهور؛ لأنَّ الله تعالى شَرَّعَ أحكامه لمصالح العباد، وعُلِم ذلك بطريق الاستقراء، وذلك من فضل الله تعالى وإحسانه، لا بطريق الوجوب عليه، خلافًا للمعتزلة.
فإذا وُجِد وصفٌ صالح للعِلية وقد اعتبره الشرع بوجْهٍ مِن الوجوه السابقة، غلب على الظن أنه عِلة للحكم.
وأما "المُلْغَى": وهو الذي عُلِم أن الشارع ألغاه مع أنه مُتَخيَّل المناسبة فلا خلاف في أنه لا يجوز التعليل به. وذلك كإيجاب صوم الشهرين ابتداء على المجامِع في نهار رمضان إذا كان مَلِكًا؛ لأنَّ العتق سهل عليه، فلا يُرْدِعُه عَمَّا وقع منه إلا الصوم شهرين؛ ولهذا أنكروا على يحيى بن يحيى بن كثير الليثي - صاحب مالك - إمام أهل الأندلس حيث أفتى بعض