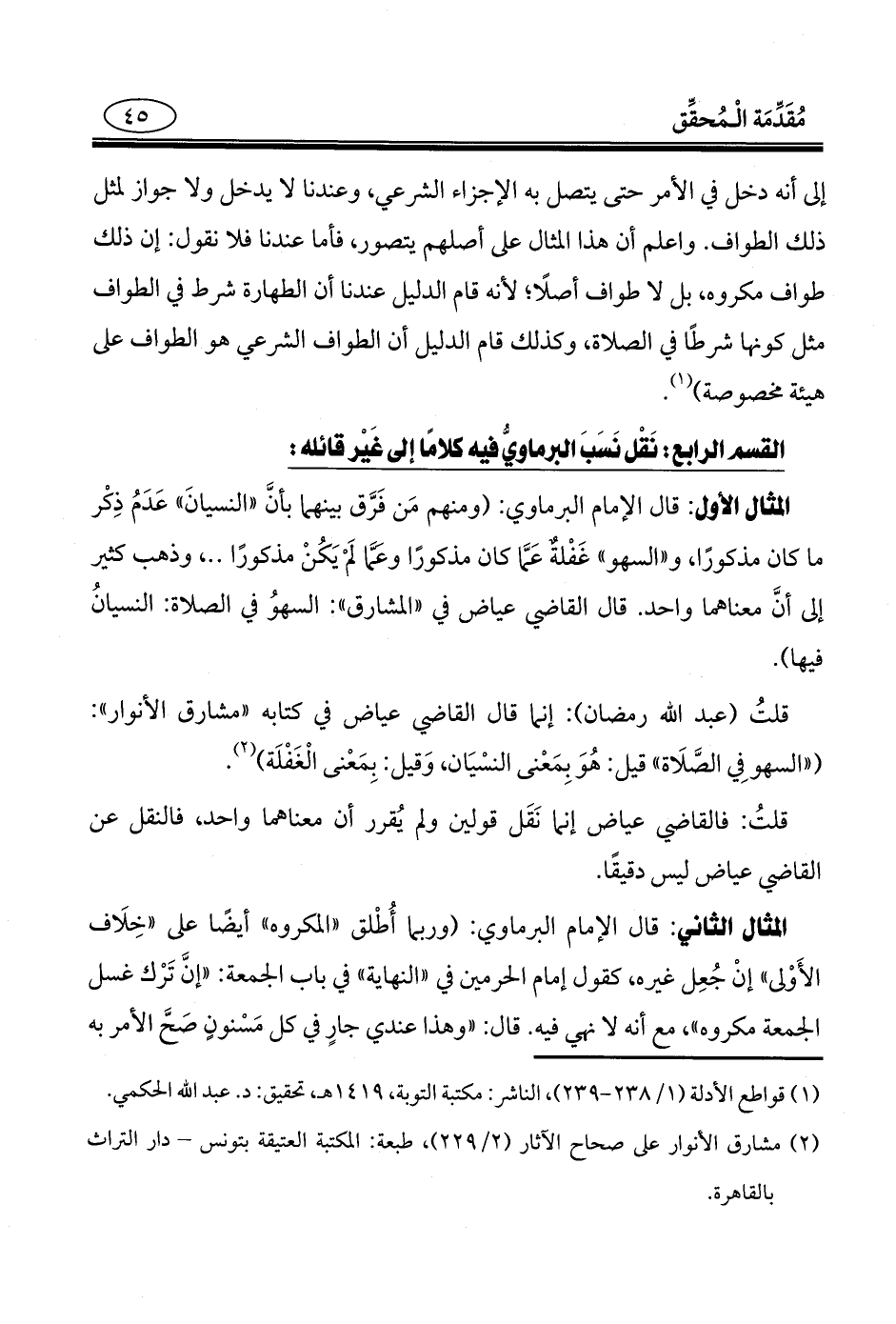
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية
إلى أنه دخل في الأمر حتى يتصل به الإجزاء الشرعي، وعندنا لا يدخل ولا جواز لمثل ذلك الطواف. واعلم أن هذا المثال على أصلهم يتصور، فأما عندنا فلا نقول: إن ذلك طواف مكروه، بل لا طواف أصلًا؛ لأنه قام الدليل عندنا أن الطهارة شرط في الطواف مثل كونها شرطًا في الصلاة، وكذلك قام الدليل أن الطواف الشرعي هو الطواف على هيئة مخصوصة) (¬1).القسم الرابع: نَقْل نَسَبَ البرماويُّ فيه كلامًا إلى غَيْر قائله:
المثال الأول: قال الإمام البرماوي: (ومنهم مَن فَرَّق بينهما بأنَّ "النسيانَ" عَدَمُ ذِكْر ما كان مذكورًا، و"السهو" غَفْلةٌ عَمَّا كان مذكورًا وعَمَّا لَمْ يَكُنْ مذكورًا .. ، وذهب كثير إلى أنَّ معناهما واحد. قال القاضي عياض في "المشارق": السهوُ في الصلاة: النسيانُ فيها).
قلتُ (عبد الله رمضان): إنما قال القاضي عياض في كتابه "مشارق الأنوار": ("السهو فِي الصَّلَاة" قيل: هُوَ بِمَعْنى النسْيَان، وَقيل: بِمَعْنى الْغَفْلَة) (¬2).
قلتُ: فالقاضي عياض إنما نَقَل قولين ولم يُقرر أن معناهما واحد، فالنقل عن القاضي عياض ليس دقيقًا.
المثال الثاني: قال الإمام البرماوي: (وربما أُطْلق "المكروه" أيضًا على "خِلَاف الأَوْلى" إنْ جُعِل غيره، كقول إمام الحرمين في "النهاية" في باب الجمعة: "إنَّ تَرْك غسل الجمعة مكروه"، مع أنه لا نهي فيه. قال: "وهذا عندي جارٍ في كل مَسْنونٍ صَحَّ الأمر به
¬__________
(¬1) قواطع الأدلة (1/ 238 - 239)، الناشر: مكتبة التوبة، 1419 هـ، تحقيق: د. عبد الله الحكمي.
(¬2) مشارق الأنوار على صحاح الآثار (2/ 229)، طبعة: المكتبة العتيقة بتونس - دار التراث بالقاهرة.
وعند التساوي يوقف إلى أن يتبين الرجحان؛ فلا يَلزم شيء مما قُلتم.
القول الخامس: لا يعمل به في الحدود؛ لأن الحدود تُدْرَأ بالشُّبهات، وكونه لم يُرْوَ إلا بالآحاد شُبهة. وهو قول الكرخي. وعبارة أبي الحسين في هذا القول المنع فيما ينتفي بالشبهة، وذلك أعم أن يكون حدودًا أو غيرها. قال: وأيضًا فإنَّ الكرخي يَقبله في إسقاط الحدود ولا يَقبله في إثباتها.
السادس: إنه لا يُعمل به في ابتداء النُّصُب، بخلاف غيرها. والفَرق أن ابتداء النصُب أصل والزائد فرع، فيقبل في النصاب الزائد على خمسة أوسق، ولا يقبل في ابتداء نصاب الفصلان (¬1) والعجاجيل؛ لأنه أصل. نقل ذلك ابن السمعاني عن بعض الحنفية.
السابع: لا يُعمل به فيما عمل الأكثر بخلافه. والحقُّ أنَّ عمل الأكثر مُرجَّح به، لا مانع.
الثامن: لا يعمل به إذا خالف عمل أهل المدينة. وهو قول المالكية؛ ولهذا نفوا خيار المجلس.
التاسع: لا يعمل به فيما تَعُم به البَلْوَى. وهو قول الحنفية؛ ولهذا أنكروا خبر نقض الوضوء مِن مَسِّ الذكَر والجهر بالبسملة وغيره.
العاشر: لا يقبل إذا خالفه راوِيه. نقل عن الحنفية؛ ولذلك لم يوجبوا السَّبع في الولوغ؛ لمخالفة أبي هريرة - رضي الله عنه - لروايته.
وقال صاحب "البديع" منهم: إن محله إذا خالفه بعد الرواية، فإنْ خالفه قَبل الرواية فلا يُرَد، وكذا إذا جُهل التاريخ.
الحادى عشر (عن الحنفية أيضًا): إنه لا يقبل ما عارض القياس؛ ولهذا ردوا خبر
¬__________
(¬1) جَمع "فصيل": من أولاد الإبل. (تهذيب اللغة، 12/ 135).
قال ابن السمعاني: (جمهور أصحاب الشافعي على الأول) (¬1). و [إنْ] (¬2) وقع في "جمع الجوامع" ترجيح خلافه.
واعْلَم أنَّ هذا غير مسألة "التعليق بالاسم المشتق يدل على تعليله بما منه الاشتقاق"، والفرق أن ذلك نَظرٌ في العِلة، ولا يلزمها الانعكاس، وهذا نظرٌ في دلالة هذا اللفظ.
وقد سبق نحوه مِن كلام إمام الحرمين وإنْ تعقبه بعض شُراح كلامه بشيء ضعيف.
نعم، الصفة المقيدة بذكر موصوفها أقوى دلالة في المفهوم مِن الصفة المطلقة؛ لأن المقيدة كالنص؛ ولهذا جعل أبو الحسن السُّهيلي -مِن أصحابنا- في كتاب "أدب الجدل" أن محل الخلاف في الاقتصار على الصفة دون الاسم، فإنْ ذُكِرَا جميعًا فظاهره أنه حُجة قطعًا.
وقال الهندي: الخلاف في هذا أَبعَد؛ لأن في صورة التخصيص بالصفة من غير ذِكر العام يمكن أن يكون الباعث على التخصيص عدم [خُطُورِه] (¬3) بالبال (¬4). وهذا الاحتمال وإنْ أَمْكَن في الصفة المقيدة بذكر موصوفها إلا أنه بعيد جدًّا.
وأَبْعَد مِن ذلك أيضًا إجراء الخلاف في صفة ليس مِن شأنها أنْ تطرأ وتزول، بل هي ملازمة للجنس، كالطعم في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبيعوا الطعام بالطعام" (¬5)، فهو قريب من
¬__________
(¬1) قواطع الأدلة في أصول الفقه (1/ 238).
(¬2) من (ز، ق، ص)، وليست في (ض).
(¬3) في (ش): حضوره.
(¬4) عبارة الهندي في (نهاية الوصول، 5/ 2569): (في صورة التخصيص بالصفة مِن غير ذِكْر العام يمكن أن يكون الباعث التخصيص هو خطرانه بالبال وذهول المتكلِّم عما ليس له تلك الصفة).
(¬5) صحيح مسلم (رقم: 1592) وغيره بلفظ: (الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ).
تنبيهات
الأول: حكاية الخلاف هكذا هو إيراد الإمام الرازي وأتباعه، وسبقهم إلى ذلك الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني والشيخ أبو إسحاق الشيرازي وغيرهما.
لكن اقتصر القاضي أبو الطيب وإمام الحرمين وابن السمعاني في النقل عن الصيرفي على وجوب اعتقاد العموم في الحال قبل البحث.
وصرح غيرهم عنه بأنه قال: يجب الاعتقاد والعمل. ولك أن تقول: إنْ دخل وقت العمل، لزم مِن وجوبِ الاعتقاد وجوبُ العمل؛ فلذلك اكتفَى مَن اقتصر على وجوب الاعتقاد بذلك.
وأما الغزالي ثم الآمدي وابن الحاجب فحكوا الخلاف على وجه آخر، وهو أنه يمتنع العمل قبل البحث قطعًا، وإنما الخلاف في كونه يكفي الظن (وهو قول الأكثر) أو لا بُدَّ من القطع (وهو قول القاضي)، قال: (ويحصل ذلك بتكرير النظر والبحث من اشتهار كلام الأئمة).
قالوا: وليس خلاف الصيرفي إلا في اعتقاد عمومه قبل دخول وقت العمل به، وإذا ظهر مخصِّص، تَعَيَّن الاعتقاد.
ومنهم مَن جمع بين الطريقين بأنهما مسألتان: وجوب العمل (وهو محل القطع)، واعتقاد العموم (وهو محل الخلاف).
وفيه نظر؛ فإن ذلك إنْ كان قبل دخول وقت العمل فقد جعلوا محل خلاف الصيرفي فيه، وإن كان بعد دخول وقت العمل فقد سبق أنه لا معنى لاعتقاده إلا وجوب العمل به.
ملوك المغاربة بذلك وهو الأمير عبد الرحمن بن الحكم الأُموي المعروف بِـ "الرَّبَضِي" (¬1) صاحب الأندلس، وكان قد نظر في رمضان إلى جارية له كان يحبها حبًّا شديدًا، فعبث بها ولم يملك نفسه أنْ وقع عليها، ثم ندم ندمًا شديدًا، فسأل الفقهاء عن توبته وكفارته، فقال له يحى بن يحمى: تصوم شهرين متتابعين. فلمَّا بَدر يحيى سكت بقية الفقهاء حتى خرجوا من عنده، فقالوا ليحيى: ما لك لم تُفْتِه بمذهب مالك وهو التخيير بين العتق والإطعام والصيام؛ فقال: لو فتحنا له هذا الباب سَهُل عليه أنْ يَطأ كل يوم ويعتق رقبة، ولكن حَملْتُه على أصعب الأمور؛ لئلَّا يَعُود.
وأما "المرسل": فهو ما لم يُعْلم أن الشرع ألغاه أو اعتبره. وربما سمي ذلك: "المصالح المرسلة". والخلاف فيها محكي عن مالك. وفي كلام ابن الحاجب ما يقتضي انقسام "المرسل" إلى مُرْسَل ملائم ومرسل غريب. أي: إنِ اعتُبر جنسه البعيد في جنس الحكم فهو الملائم، وإلا فهو "الغريب".
فالغريب بهذا التفسير غير الغريب بالتفسير السابق.
قال ابن الحاجب: (فإنْ كان - أيِ المرسل - غريبًا أو ثبت إلغاؤه فمردود اتفاقًا) (¬2).
أي: ولأ يُظَن بمالك أن يخالف فيه.
قال إمام الحرمين: (لا نرى التعلُّق عندنا بكل مصلحة، ومَن ظن ذلك بمالك فقد أخطأ) (¬3). انتهى
نعم، سبق أن ما ثبت إلغاؤه قَسِيم للمرسل، لا قِسم منه، ولا مشاححة في الاصطلاح.
¬__________
(¬1) نِسبة إلى "الربض": موضع بقرطبة.
(¬2) مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل (2/ 1098)، الناشر: دار ابن حزم.
(¬3) البرهان في أصول الفقه (2/ 783).