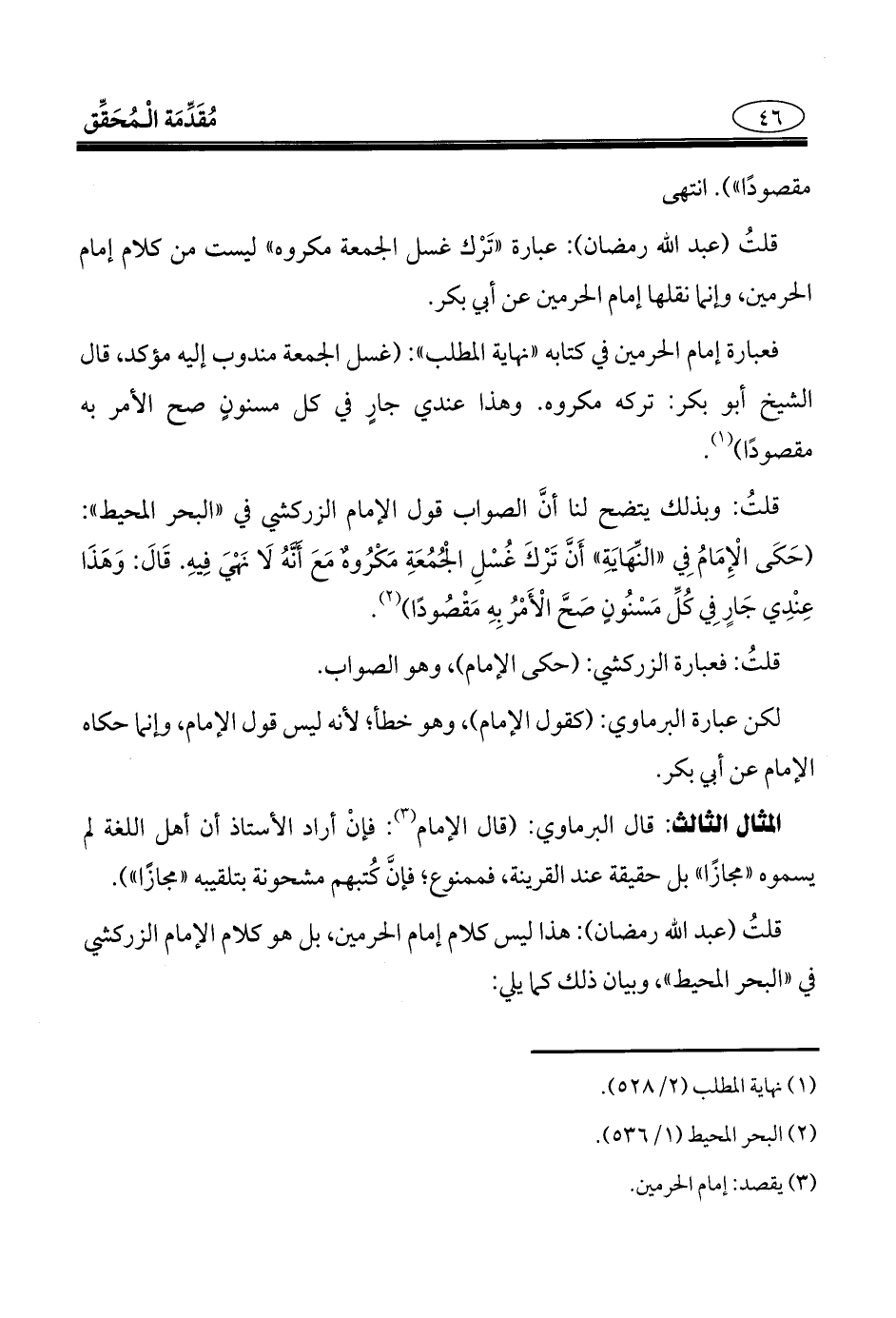
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية
مقصودًا"). انتهىقلتُ (عبد الله رمضان): عبارة "تَرْك غسل الجمعة مكروه" ليست من كلام إمام الحرمين، وإنما نقلها إمام الحرمين عن أبي بكر.
فعبارة إمام الحرمين في كتابه "نهاية المطلب": (غسل الجمعة مندوب إليه مؤكد، قال الشيخ أبو بكر: تركه مكروه. وهذا عندي جارٍ في كل مسنونٍ صح الأمر به مقصودًا) (¬1).
قلتُ: وبذلك يتضح لنا أنَّ الصواب قول الإمام الزركشي في "البحر المحيط": (حَكَى الْإِمَامُ فِي "النَّهَايَةِ" أَنَّ تَرْكَ غُسْلِ الْجُمُعَةِ مَكْرُوهٌ مَعَ أَنَّهُ لَا نَهْيَ فِيهِ. قَالَ: وَهَذَا عِنْدِي جَارٍ فِي كُلِّ مَسْنُونٍ صَحَّ الْأَمْرُ بِهِ مَقْصُودًا) (¬2).
قلتُ: فعبارة الزركشي: (حكى الإمام)، وهو الصواب.
لكن عبارة البرماوي: (كقول الإمام)، وهو خطأ؛ لأنه ليس قول الإمام، وإنما حكاه الإمام عن أبي بكر.
المثال الثالث: قال البرماوي: (قال الإمام (¬3): فإنْ أراد الأستاذ أن أهل اللغة لم يسموه "مجازًا" بل حقيقة عند القرينة، فممنوع؛ فإنَّ كُتبهم مشحونة بتلقيبه "مجازًا").
قلتُ (عبد الله رمضان): هذا ليس كلام إمام الحرمين، بل هو كلام الإمام الزركشي في "البحر المحيط"، وبيان ذلك كما يلي:
¬__________
(¬1) نهاية المطلب (2/ 528).
(¬2) البحر المحيط (1/ 536).
(¬3) يقصد: إمام الحرمين.
المُصَرَّاة. وقيَّده البيضاوي بكونه عند عدم فِقه الراوي، فإنْ كان فقيهًا فلا يُرد ولو خالف القياس.
نعم، في "اللمع" (¬1) للشيخ أبي إسحاق أن أصحاب مالك أطلقوا أنه لا يُقبل إذا خالف القياس، وأن أصحاب أبي حنيفة قالوا: إذا خالف قياس الأصول، لم يُقبل. وذكروه في أحاديث الوقف والقرعة والمصراة.
قال: (فإنْ أرادوا بالأصول القياس على ما ثبت بالأصول فهو قول المالكية، وإن أرادوا نفس الأصول التي هي الكتاب والسُّنة والإجماع فليس معهم فيما ردوه كتاب ولا سُنة). انتهى
نعم، الصحيح عند الحنفية - وحكاه في "البديع" عن الأكثرين - تقديم الخبر على القياس مطلقًا. وقال الباجي: إنه الأصح عندي مِن قول مالك - رضي الله عنه -، فإنه سُئل عن حديث المصراة فقال: أَوَ لِأَحَدٍ في هذا الحديث رأْي؟ !
وفي المسألة قول ثالث اختاره الآمدي وابن الحاجب: إنْ كانت العلة ثبتت بنص راجح على الخبر في الدلالة وهي موجودة في الفرع قطعًا فالقياس مقدَّم، أو ظنًّا فالتوقف، أو ثبتت لا بنصٍّ راجح فالخبر مقدم.
وقول رابع: إنهما متساويان مطلقًا. حكاه الباجي عن القاضي أبي بكر.
الموضع الثاني من الكلام في خبر الواحد:
أنه وإنْ وجب العمل به فإنه إنما يفيد الظن، ولا يفيد القطْع إلا بقرينة، وهو معنى قولي: (وَلَا يُشْعِرُ بِالْيَقِينِ) إلى آخِره.
¬__________
(¬1) اللمع (ص 73).
التخصيص بالاسم. و [لهذا] (¬1) جزم العبدري وابن [الحاج] (¬2) باشتراط هذا الشرط، بل زادا اشتراط أن يكون نقيض الصفة يخطر بالبال.
قلتُ: وفيه نظر؛ لأن المعنى: لا تبيعوا الشيء الموصوف بأنه طعام، أي: مطعوم. فهو لا ينفك عن موصوف محذوف تطرأ فيه الصفة وتزول.
ثالثها:
حيث قُلنا بأنَّ المفهوم حجة على معنى نَفْي الحكم المذكور في المنطوق عن المسكوت سواء مفهوم الصفة وغيرها فهو من حيث دلالة اللغة ووضع اللسان كما قاله أكثر أصحابنا كما نقله ابن السمعاني، وهو الصحيح، وهو ظاهر إطلاقِي في النَّظم؛ إذِ الكلام فيما يستفاد من اللغة.
وقال بعضهم: إنما هو مِن قِبل الشرع بتصرف منه زائد على وضع اللغة. وحكى الروياني في "البحر" وجهين في ذلك.
وقال الإمام في "المعالم": (إن ذلك من قبيل العُرف العام؛ لأنَّ أهل العرف يقصدون مثل ذلك) (¬3).
أما في "المحصول" فوافق الحنفية في المنع من الأصل.
وقيل: من حيث العقل. ويوافقه ما سيأتي في باب العموم أن عموم المفهوم عند بعضهم بالعقل.
¬__________
(¬1) في (ص): كذا. وفي (ش): لذا.
(¬2) في (ز): الحاجب.
(¬3) المعالم في أصول الفقه (ص 63)، الناشر: دار المعرفة.
الثاني: استند مَن قال بوجوب [العمل] (¬1) (وهو الصيرفي) إلى نَصِّ الشافعي في "الرسالة"، إذْ قال ما نصه: (والكلام إذا كان عامًّا ظاهرًا، كان على عمومه وظهوره حتى تأتي دلالة تدل على خلاف ذلك).
حكى ذلك عنه الشيخ أبو حامد، وحُكي عن القفال أن الصيرفي سُئل عن قوله تعالى: {فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ} [الملك: 15] مَن سَمع هذا، يأكل جميع ما يجده؟ قال: يبلع الدنيا بلعًا.
قال أبو حامد: (وابن سريج ورفقته تعلقوا بقول الشافعي ما نصه: وعلى أهل العلم بالكتاب والسنة أن يطلبوا دليلًا يفرقون به بين الحتم وغيره في الأمر والنهي) (¬2). انتهى
الثالث: مثار الخلاف في المسألة التعارض بين الأصل والظاهر، وله مثار آخر وهو أن التخصيص هل هو مانع؟ أو عدمه شرط؟
فالصيرفي يجعله مانعًا، فالأصل عدمه.
وابن سريج يجعله شرطًا، فلا بُدَّ مِن تحقُّقه. ونظيره الشاهد عند الحاكم لا يُعرف حاله، فيُبحث عنه حتى يُعمل بشهادته إذا عُدِّل.
ونظيره أيضًا صيغة العموم المحتملة للعهد، هل يُعمل بها؛ لأن العهد مانع والأصل عدمه؟ أو عدم العهد شرط، فلا بُدَّ مِن تحقُّقه؟
الرابع: قال ابن الحاجب: (إنَّ هذا الخلاف يجري في كل دليل مع معارِضِه).
وهي طريقة لبعضهم ممن ذكرها الشيخ أبو حامد، إذ قال: (وهذا الخلاف بين أصحابنا في لفظ الأمر والنهى إذا وردَا مُطلقَين).
¬__________
(¬1) في (ت): وقت العمل.
(¬2) الأم (5/ 143).
ثم قال (¬1): (وإن كان ملائمًا - أيْ مُرْسَلاً ملائمًا - فقد صرح الإمام والغزالي بقبوله، وذُكِر عن مالك والشافعي) (¬2).
وانتُقِد عليه في نقله عن الشافعي ذلك؛ فإنَّ الذي يعتبره الشافعي إنما هو الذي شهد الشرع باعتباره كما سبق، وبأنَّ الإمام والغزالي لا يُطْلِقان، كما قد صح عن مالك أنه يعتبر جنس المصالح مطلقًا.
ثم قال ابن الحاجب: (المختار ردُّه). أيْ: كما هو مذهب الأكثر.
وحاصل ما في المرسل مِن الخلاف مذاهب:
أحدها: المنع مطلقًا، وعليه الأكثرون. وإليه أشرتُ بقولي: (فَذَاكَ "مُرْسَلٌ" يَكُونُ مُلْغَى).
ويقابل هذا المذهب الثاني: وهو القبول مطلقًا؛ لإفادته ظن العِلية. وهو المنقول عن مالك، وسبق مخالفة ابن الحاجب والأكثرين له.
وبالغ إمام الحرمين في الرد عليه، وقال: (الذي ننكره مِن مذهب مالك تركه رعاية ذلك، وجريانه على استرساله في الاستصواب مِن غير اقتصاد) (¬3).
قال: (ونحن نعرض على مالك واقعة وقعت نادرة لا يُعْهَد مِثلها، ونقول له: لو رأى ذو نظر فيها جدع أنف أو اصطلام شفة، وأبدى رأيًا لا تنكره العقول صائرًا إلى أن العقوبة شُرعت لحسم الفواحش، وهذه العقوبة لائقة بهذه النازلة، لَلَزِمَكَ التزام هذا؛ لأنك تُجَوِّز
¬__________
(¬1) يعني: ابن الحاجب.
(¬2) مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل (2/ 1098)، الناشر: دار ابن حزم.
(¬3) البرهان في أصول الفقه (2/ 733).