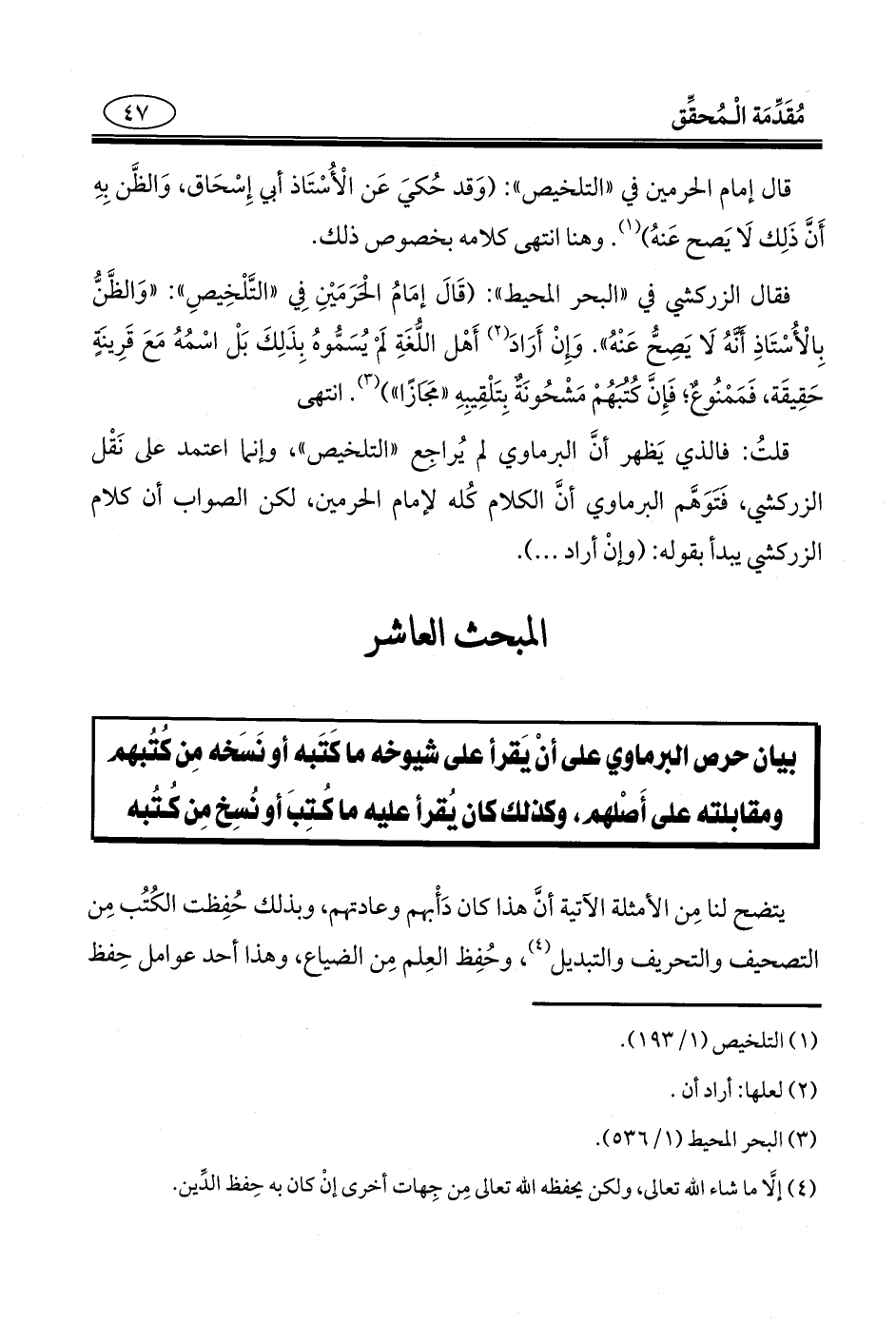
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية
قال إمام الحرمين في "التلخيص": (وَقد حُكيَ عَن الْأُسْتَاذ أبي إِسْحَاق، وَالظَّن بِهِ أَنَّ ذَلِك لَا يَصح عَنهُ) (¬1). وهنا انتهى كلامه بخصوص ذلك.فقال الزركشي في "البحر المحيط": (قَالَ إمَامُ الحْرَمَيْنِ فِي "التَّلْخِيصِ": "وَالظَّنُّ بِالْأُسْتَاذِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ عَنْهُ". وَإِنْ أَرَادَ (¬2) أَهْل اللُّغَةِ لَمْ يُسَمُّوهُ بِذَلِكَ بَلْ اسْمُهُ مَعَ قَرِينَةٍ حَقِيقَة، فَمَمْنُوعٌ؛ فَإِنَّ كُتُبَهُمْ مَشْحُونَةٌ بِتَلْقِيبِهِ "مَجَازًا") (¬3). انتهى
قلتُ: فالذي يَظهر أنَّ البرماوي لم يُراجع "التلخيص"، وإنما اعتمد على نَقْل الزركشي، فَتَوَهَّم البرماوي أنَّ الكلام كُله لإمام الحرمين، لكن الصواب أن كلام الزركشي يبدأ بقوله: (وإنْ أراد ... ).
المبحث العاشر: بيان حرص البرماوي على أنْ يَقرأ على شيوخه ما كَتَبه أو نَسَخه مِن كُتُبهم ومقابلته على أَصْلهم، وكذلك كان يُقرأ عليه ما كُتِبَ أو نُسِخ مِن كُتُبه
يتضح لنا مِن الأمثلة الآتية أنَّ هذا كان دَأْبهم وعادتهم، وبذلك حُفِظت الكُتُب مِن التصحيف والتحريف والتبديل (¬4)، وحُفِظ العِلم مِن الضياع، وهذا أحد عوامل حِفظ
¬__________
(¬1) التلخيص (1/ 193).
(¬2) لعلها: أراد أن.
(¬3) البحر المحيط (1/ 536).
(¬4) إلَّا ما شاء الله تعالى، ولكن يحفظه الله تعالى مِن جِهات أخرى إنْ كان به حِفظ الدِّين.
والمسألة فيها مذاهب:
أرجحها: أنه لا يفيد العلم إلا إذا انضم إليه قرائن يَقطع السامع مع وجودها بصدق الخبر، كإخبار مَلِك عن موت ولده المريض عنده مع قرينة البكاء وإحضار الكفن وآلات الدفن ونحو ذلك، وأما تجويز أن يكون قد أغمي عليه فلا يقدح في المسألة، بل في المقال، فيضيق الفرض فيه بما يمنع الحمل على الإغماء من قرينة أخرى.
وإنما مرَدُّ القرائن إلى ما يحصُل معه القطْع؛ إذ منها ما لا يعبر عنه كما يظهر بِوَجْه الخجِل والوَجِل؛ ولهذا قال المازري: إن القرائن لا يمكن أن تضبَط بعبارة.
وقال غيره: يمكن أن تضبط بما تسكن إليه النفْس، كالسكن للمتواتر أو قريب منه بحيث لايبقى فيه احتمال عنده.
ومن القرائن المفيدة للقطع: نحو الإخبار بحضرته - صلى الله عليه وسلم - فلا ينكره، أو بحضرة جمعٍ يستحيل تواطؤهم على الكذب، أو تتلقاه الأُمة بالقبول - على رأي ابن الصلاح حيث قال: (إن ما في صحيحي البخاري ومسلم أو أحدهما مِن لازِم تَلَقِّي الأُمة له بالقبول اتفاق الأُمة على صحته، فهو مقطوع بصحته، والعلم القطعي حاصل فيه، خلافًا لمن نفى ذلك محتجًّا بأنه لا يفيد. في أصله إلا الظن، وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن، والظن قد يخطئ).
قال الشيخ: (وقد كنت أميل إلى هذا وأَحسبه قويًّا، ثم بان لي أن ما اخترته هو الصحيح؛ لأن ظن مَن هو معصوم مِن الخطأ لا يخطئ، والأُمة في إجماعها معصومة من الخطأ؛ ولهذا كان الإجماع المبني على الاجتهاد حُجة مقطوعًا بها، وأكثر إجماعات العلماء كذلك) (¬1).
انتهى النووي: (إن الشيخ قد خالفه في ذلك المحققون والأكثرون، فقالوا: يفيد الظن ما لم
¬__________
(¬1) مقدمة ابن الصلاح (ص 28).
رابعها:
اختلفوا أيضًا: هل دل على النفي عمَّا عداه مطلقًا سواء أكان من جنس المنعوت فيه أو لم يكن؟ أو تختص دلالته بما إذا كان من جنسه؟
ففي نحو: "في الغنم السائمة الزكاة" هل الزكاة منفية عن المعلوفة مطلقًا سواء أكانت من الإبل أو البقر أو الغنم؟ أو معلوفة الغنم فقط؟ على قولين حكاهما الإمام الرازي وغيره، وحكاه الشيخ أبو حامد خلافًا لأصحابنا، وصحح الثاني.
ووَجْهُه أن المفهوم نقيض المنطوق، والمنطوق سائمة الغنم دُون غيرها.
قال ابن السبكي: (ولعل هذا الخلاف مخصوص بصورة "في الغنم السائمة زكاة"، أما صورة "سائمة الغنم" فقد قُلنا: إنَّ المنفي فيها سائمة غير الغنم، فالمنفي "سائمة"، لا "غير سائمة"، والمنفي هناك "غير سائمة". لكن "غير سائمة" على العموم؟ أو على الخصوص؟ فيه القولان) (¬1).
قلت: وقد سبق ما فيه من النظر.
خامسها:
قال ابن السمعاني: إذا اقترن بالحكم المعلَّق بالصفة حُكم مطلق، فقد اختلف قول الشافعي في دليل المقيَّد بالصفة (أي: دليل الخطاب فيه، وهو مفهوم المخالفة) هل يصير مستعملًا في المطلق؟ على قولين.
مثاله قوله تعالى: {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49] فكان مقيَّدًا بصفة اقتضت أن لا عدة
¬__________
(¬1) منع الموانع عن جمع الجوامع (ص 520).
نعم، منهم مَن نقل الإجماع على أنه لا يجب -عند سماع الحقيقة- طلبُ المجاز وإنْ وجب عند سماع العام طَلَبُ المخصِّص؛ لأنَّ تَطرُّق التخصيص إلى العام أكثر.
قال الشيخ تقي الدين السبكي: (ولأن في العام دلالتين: إحداهما على أصل المعنى وهي نَص، والثانية على استغراق الأفراد وهي ظاهرة. واحتمال المجاز حاصل في الأول. وأما الحقيقة فاللفظ فيها يدل على مُعيَّن مفرد، والدلالة الإفرادية عِلمية قطعية؛ فلذلك لم يُطلب المجاز، واحتمال التخصيص إنما هو في الثانية) (¬1).
قال: (ومَن شَبَّه العام بالحقيقة فقد أتى بساقط مِن القول).
الخامس: إذا اقتضى العام عملًا مؤقتًا وضاق الوقت عن طلب الخصوص، فهل يُعمل بالعموم؟ أو يُتوقَّف؟ حكى ابن الصباغ فيه خلافًا.
ونظيره هل للمجتهد التقليد عند ضيق الوقت؟ فيه وجهان.
وكذا القادر على الاجتهاد في القِبلة، وكذا لو استيقظ قبل الوقت وكان بحيث لو اشتغل بالوضوء لخرج الوقت، هل يتيمم؟ أو يتوضأ وإنْ خرج الوقت؟ وجهان.
قولي: (وَحَيْثُ شُرِطَا) أَجود من قوله في "جمع الجوامع": (وكذا بعد الوفاة، خلافًا لابن سريج. ثم يكفي في البحث الظن، خلافًا للقاضي) (¬2).
لأنه يُوهِم أنه تفريع على القول بعدم البحث، وليس كذلك، بل هو على وجوبه. وأيضًا ففيه تخليط طريقة بطريقة، وقد أوضحنا الطريقين. والله أعلم.
¬__________
(¬1) الإبهاج (2/ 142).
(¬2) جمع الجوامع (2/ 40) مع شرح المحلي وحاشية العطار.
لأصحاب [الإيالات] (¬1) القتل في التُّهَم العظيمة، حتى نَقل عنك الثقات أنك قلت: "أقتل ثلث الأُمة في استبقاء ثلثيها").
قال: (ثم إنَّا نقول له ثانيًا: لا يجوز التعلق بكل رأي. فإنْ أبَى ذلك، لم نجد مرجعًا نقر [عنده] (¬2) إلا ما ارتضاه الشافعي مِن اعتبار المصالح المشبهة [بما] (¬3) عُلِم اعتباره. وإنْ لم يذكر ضابطًا وصرح بأنَّ ما لا نَص فيه ولا أصل له فهو مردود إلى الرأي واستصحاب ذوي العقول، فهذا اقتحام عظيم، وخروج عن الضبط، ومصير إلى إبطال أبَّهة الشريعة، وأنَّ كُلًّا يفعل ما يرى، ثم يختلف ذلك باختلاف الزمان والمكان وأصناف الخلق، وهو في الحقيقة خروج عما درج عليه الأوَّلون) (¬4). انتهى
والله أعلم، ثم عرضت بذكر باقي المذاهب في المسألة بقولي:
ص:
835 - إنْ يَكُنْ في غَيْرِ مَا عِبَادَةْ ... وَلَيْسَ مِنْ هَذَا لِمَنْ أَرَادَهْ
836 - مَصْلَحَةٌ قَطْعِيَّة كلِّيَّهْ ... مِنَ الضَّرُورِيِّ؛ فَذِي الْمُضِيَّهْ
837 - دَلَّ عَلَى اعْتِبَارِهَا الدَّلِيلُ ... فَهْيَ مِنَ الْحَقِّ، بِهِ نَقُولُ
الشرح: فالمذهب الثالث: التفصيل بين العبادات وغيرها:
فما كان من العبادات فلا يجوز التعليل بالمرسل فيه؛ لِمَا فيها من لحاظ التعبد.
¬__________
(¬1) في (ت): الولايات.
(¬2) في (ق): منه. وفي سائر النسخ: عنه. والتصويب من البرهان (2/ 725).
(¬3) في (ص، ق): لما.
(¬4) البرهان في أصول الفقه (2/ 725).