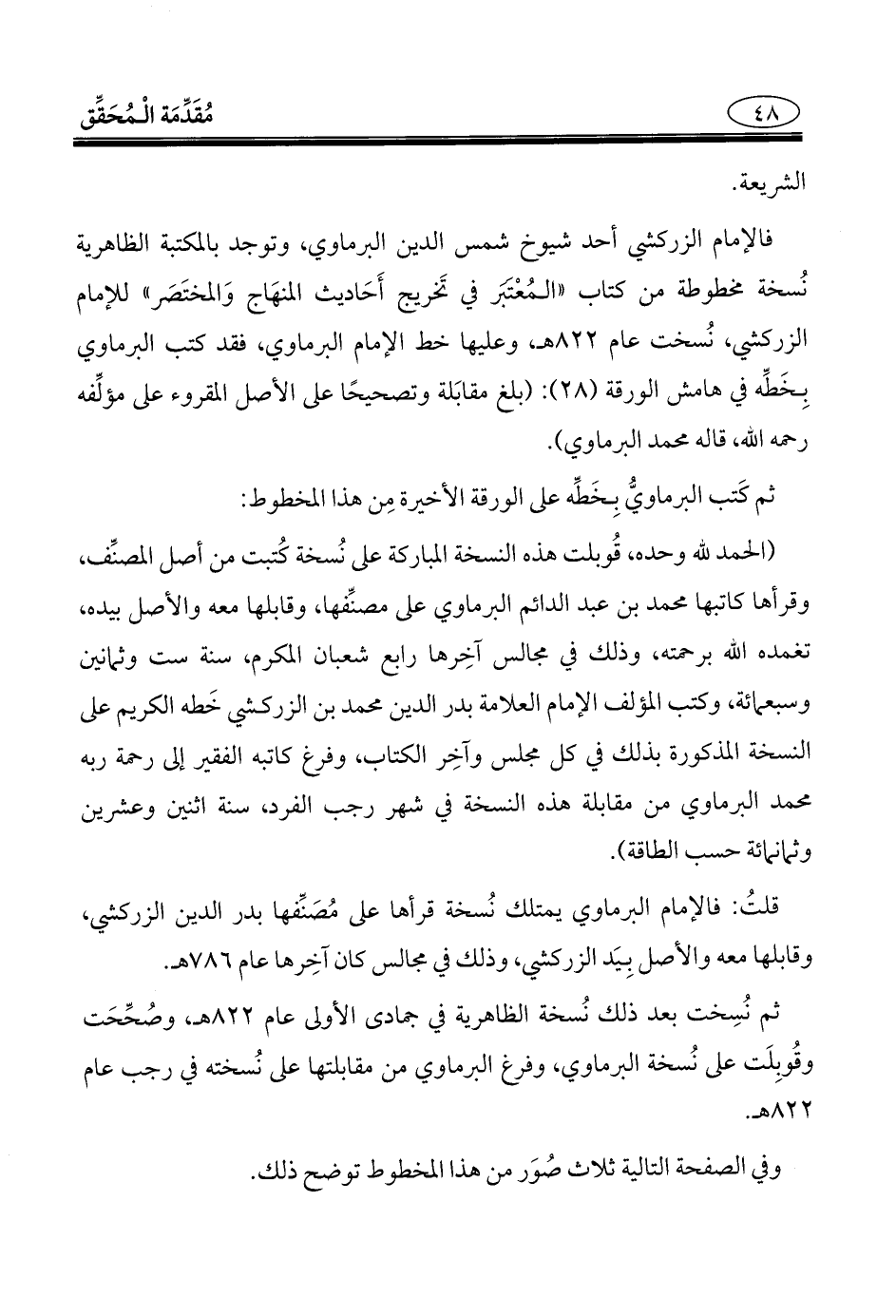
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية
الشريعة.فالإمام الزركشي أحد شيوخ شمس الدين البرماوي، وتوجد بالمكتبة الظاهرية نُسخة مخطوطة من كتاب "المُعْتَبَر في تَخريج أَحَاديث المنهَاج وَالمختَصَر" للإمام الزركشي، نُسخت عام 822 هـ، وعليها خط الإمام البرماوي، فقد كتب البرماوي بِخَطِّه في هامش الورقة (28): (بلغ مقابَلة وتصحيحًا على الأصل المقروء على مؤلِّفه رحمه الله، قاله محمد البرماوي).
ثم كَتب البرماويُّ بِخَطِّه على الورقة الأخيرة مِن هذا المخطوط:
(الحمد لله وحده، قُوبلت هذه النسخة المباركة على نُسخة كُتبت من أصل المصنِّف، وقرأها كاتبها محمد بن عبد الدائم البرماوي على مصنِّفها، وقابلها معه والأصل بيده، تغمده الله برحمته، وذلك في مجالس آخِرها رابع شعبان المكرم، سنة ست وثمانين وسبعمائة، وكتب المؤلف الإمام العلامة بدر الدين محمد بن الزركشي خَطه الكريم على النسخة المذكورة بذلك في كل مجلس وآخِر الكتاب، وفرغ كاتبه الفقير إلى رحمة ربه محمد البرماوي من مقابلة هذه النسخة في شهر رجب الفرد، سنة اثنين وعشرين وثمانمائة حسب الطاقة).
قلتُ: فالإمام البرماوي يمتلك نُسخة قرأها على مُصَنَّفها بدر الدين الزركشي، وقابلها معه والأصل بِيَد الزركشي، وذلك في مجالس كان آخِرها عام 786 هـ.
ثم نُسِخت بعد ذلك نُسخة الظاهرية في جمادى الأولى عام 822 هـ، وصُحِّحَت وقُوبِلَت على نُسخة البرماوي، وفرغ البرماوي من مقابلتها على نُسخته في رجب عام 822 هـ.
وفي الصفحة التالية ثلاث صُوَر من هذا المخطوط توضح ذلك.
يتواتر؛ لأن أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن، ولا يَلْزَم مِن إجماع الأُمة على العمل بما فيها إجماعهم على أنه مقطوع به مِن كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (¬1).
وممن أَنكَر هذه المقالة ابن برهان وابن عبد السلام وغيرهما.
فإنْ لم تحتف بالآحاد قرائن فلا يفيد اليقين؛ لاحتمال الغلط والسهو ونحو ذلك.
وبهذا التفصيل قال الإمام الرازي والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي وغيرهم من المتأخرين.
والقول الثاني: إنه لا يفيد العلم مطلقًا. وبه قال الأكثرون. قال الحارث المحاسبي في كتاب "فهم السنن": هو قول أكثر أهل الحديث [من] (¬2) أهل الرأي والفقه.
الثالث وهو قول أهل الظاهر: إنه يفيد العِلم مطلقًا. ونقله ابنُ عبد البر عن الكرابيسي، والباجيُّ عن أحمد وابنِ خُويز منداد. زاد [المازري] (¬3): وإنه (¬4) نَسَبَه إلى مالك، وأنه نَصَّ عليه. ولكن نازعه (¬5) بأنه لم يعثر لمالك على نَص فيه، قال: ولَعَلَّه رأَى مقالة تشير إليها، ولكنها مُتَأَوَّلة.
الرابع: إنه يوجب العلم الظاهر دون الباطن. نقله المازري، وأرادوا أنه يُثْمر الظن
¬__________
(¬1) شرح النووي على صحيح مسلم (ص 20)، الناشر: دار إحياء التراث العربي.
(¬2) كذا في جميع النُّسخ، وعبارة الزركشي في (البحر المحيط، 3/ 322): (رَأَيْت كَلَامَهُ فِي كِتَابِ "فَهْمِ السُّنَنِ" نَقَلَ عَنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَأَهْلِ الرَّأْيِ وَالْفِقْهِ أَنَّهُ لَا يُفِيدُ الْعِلْمَ).
(¬3) كذا في (ق) وهو الصواب؛ لأن الكلام للمازري في كتابه (إيضاح المحصول من برهان الأصول، ص 421). وفي سائر النُّسخ: الماوردي.
(¬4) يقصد: ابن خويز منداد.
(¬5) أي: المازري نازعَ ابن خويز منداد.
على غير المدخول بها، ودليله وجوب العدة على المدخول بها.
ثم قال تعالى: {فَمَتِّعُوهُنَّ} [الأحزاب: 49]، فهل تكون المتعة معطوفة على العدة في اشتراط الدخول فيها؟ على قولين:
أحدهما: تصير بالعطف مشروطة.
والثاني: لا، ويجري قوله تعالى: {فَمَتِّعُوهُنَّ} على إطلاقه.
سادسها:
ذكر بعضهم أنَّ أبا حنيفة إنما يخالف في مفهوم الصفة إذا ورد دليل العموم ثم ورد إخراج فَرْد منه بوصفٍ، كمجيء دليل بوجوب زكاة الغنم مطلقًا، ثم يقول: "في الغنم السائمة زكاة"، فلا ينفي الزكاة عن غير السائمة؛ استصحابًا لدليل العموم السابق. أما إذا لم يسبق عموم بل جاء ابتداءً "في السائمة الغنم الزكاة"، فأبو حنيفة يوافق على عدم الزكاة في المعلوفة.
قولي: (وَمنْهُ: عِلَّةُ) إلى آخِره -إشارة إلى أن مفهوم الصفة يدخل تحته أقسام أربعة وإنْ كان كثير من الأصوليين يغاير بينها وبين الوصف.
لكن إمام الحرمين جعلها من الوصف؛ لرجوعها إليه، فقال: (لو عُبِّر عن جميع هذه الأنواع بالصفة لَكان ذلك منقدحًا؛ فإنَّ المحدود والمعدود موصوفان بعددهما وحدهما، والمخصوص بالكون في زمان أو مكان موصوف بالاستقرار فيهما، فقول القائل: "زيد في الدار" أي: مستقر فيها، وكذا القتال يوم الجمعة، أي: كائن فيه) (¬1).
وكذلك صرح القاضي أبو الطيب في العَدد بأنه قِسم مِن الصفة، وأشار إليه ابن
¬__________
(¬1) البرهان (1/ 301).
المُخَصِّص:
625 - مُخَصِّصُ الْعُمُومِ إمَّا مُتَّصِلْ ... لَا [يَسْتَقِلُّ] (¬1) مُفْرَدًا، أَوْ مُنْفَصِلْ
الشرح:
لَمَّا فرغتُ مِن بيان التخصيص، شرعت في المخصِّص (بالكسر)، وهو حقيقةً فاعِلُ التخصيص الذي هو الإخراج كما سبق، ثم أُطلق على إرادته الإخراج؛ لأنه إنما يُخصِّص بالإرادة، فأُطلِق على نَفْس الإرادة "تخصيصًا"، حتى قال الإمام الرازي وأتباعه: (إن حقيقة التخصيص هو الإرادة) (¬2).
لكن الأصوب ما ذكرناه. ثم أُطلق "المخَصِّص" على الدليل الدال على الإرادة.
ومنهم من يحكي هذين قولين كما فعل القاضي عبد الوهاب وابن برهان:
أحدهما: أنَّ "المخصِّصَ": إرادةُ المتكلم إخراج بعض ما يتناوله الخطاب.
والثاني: الدليل الدال على إرادة ذلك.
وبالجملة فالمقصود من الترجمة الثاني، وهو الدليل، فإنه الشائع في الأصول حتى صار حقيقة عرفية. وربما أطلق "المخصِّص" على المُظْهِر لإرادة مُرِيد التخصيص مِن مجتهدٍ أو غيره.
إذا عُرف ذلك، فالمخصِّص قسمان:
متصل: وهو ما لا يستقل، بل مرتبط بكلام آخَر.
¬__________
(¬1) في (ت): مستقل.
(¬2) المحصول (3/ 8).
وما كان من غير العبادات كبيع ونكاح وحدود وقصاص فيجوز؛ لأنَّ الملاحظ فيها المناسبات اللائحة في مصالحها. وهذا قول الأبياري شارح "البرهان"، وزعم أنه الذي يقتضيه مذهب مالك.
المذهب الرابع: قول الغزالي واختاره البيضاوي: أنه يُعَلَّل به بثلاثة قيود:
أن يشتمل ذلك "المناسب المرسل" على مصلحة ضرورية كلية قطعية، فإنْ فات شيء من الثلاثة فلا يعتبر. فالضرورية ما يكون من الضروريات الخمس السابقة، والقطعية ما يُجْزَم بحصول المصلحة فيها، والكُلية ما تكون موجِبة لفائدة تَعُم المسلمين.
مثاله: ما لو تَتَرس الكفار حال التحام القتال بأسارى المسلمين وقطعنا بأنَّا إنْ رمينا الترس نقتل مسلمًا بلا جريمة صدرت منه، وإلا فيُقطع باستئصال المسلمين.
قال الغزالي: (فحفظ المسلمين أَقْرب إلى مقصود الشرع؛ لانا نقطع بأن الشرع يقصد تقليل القتل كما يقصد حَسْم سبيله عند الإمكان. وإذا لم نَقدر على الحسم فقد قدرنا على التقليل. فليس في معنى اجتماع هذه القيود في هذه الصورة ما لو تترس الكفار في قلعة بمسلم، فإنه لاْ يحل رَمْي الترس؛ إذ لا ضرورة بنا إلى أخذ القلعة.
وليس في معنى ذلك جَمْع في سفينة لو طرحوا واحدًا لَنَجوا وإلا غرقوا جميعًا؛ لأنها ليست كُلية؛ إذ يحصل بها هلاك عدد محصور، ولَعَلَّ مصلحة الدِّين في بقاء مَن طُرِح أَعْظم منها في بقاء مَن بقي في مخمصة لو أكلوا واحدًا بالقرعة لنجوا، فلا رخصة فيه. وكذا ليس في معنى ذلك ما إذا لم يُقْطَع بظفرهم، فإنها ليست قطعية، بل ظنية) (¬1).
نعم، قال الغزالي في "المستصفى": (إن الظن القريب مِن القطع كالقطع) (¬2).
¬__________
(¬1) المستصفى (1/ 176).
(¬2) انظر: المستصفى (1/ 177).