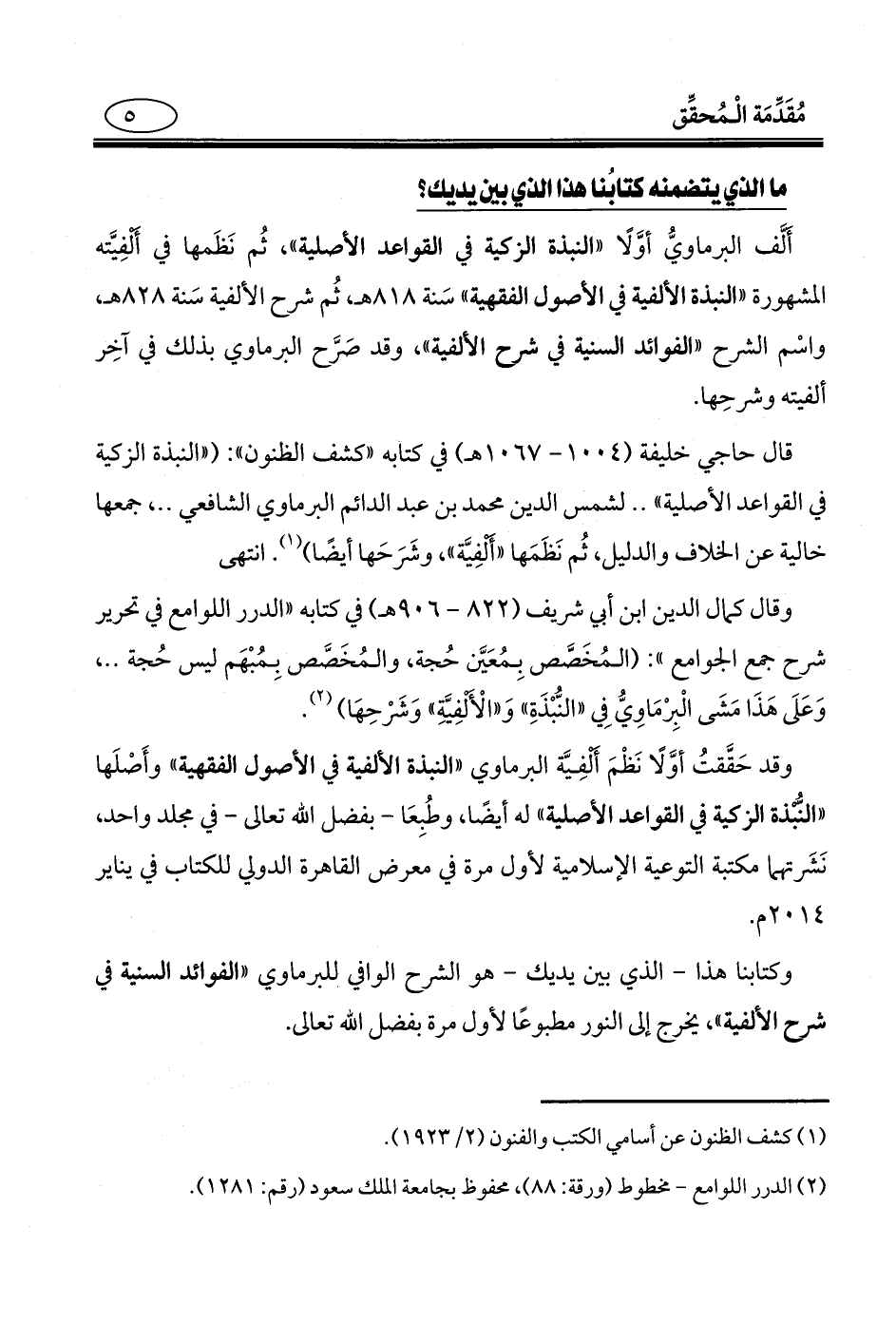
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية
ما الذي يتضمنه كتابُنا هذا الذي بين يديك؟أَلَّف البرماويُّ أوَّلًا "النبذة الزكية في القواعد الأصلية"، ثُم نَظَمها في ألفِيَّته المشهورة "النبذة الألفية في الأصول الفقهية" سَنة 818 هـ، ثُم شرح الألفية سَنة 828 هـ، واسْم الشرح "الفوائد السنية في شرح الألفية"، وقد صَرَّح البرماوي بذلك في آخِر ألفيته وشرحِها.
قال حاجي خليفة (1004 - 1067 هـ) في كتابه "كشف الظنون": ("النبذة الزكية في القواعد الأصلية" .. لشمس الدين محمد بن عبد الدائم البرماوي الشافعي .. ، جمعها خالية عن الخلاف والدليل، ثُم نَظَمَها "أَلْفِيَّة"، وشَرَحَها أيضًا) (¬1). انتهى
وقال كمال الدين ابن أبي شريف (822 - 906 هـ) في كتابه "الدرر اللوامع في تحرير شرح جمع الجوامع": (المُخَصَّص بِمُعَيَّن حُجة، والمُخَصَّص بِمُبْهَم ليس حُجة .. ، وَعَلَى هَذَا مَشَى الْبِرْمَاوِيُّ فِي "النُّبْذَةِ" وَ"الْأَلْفِيَّةِ" وَشَرْحِهَا) (¬2).
وقد حَقَّقتُ أوَّلًا نَظْمَ أَلْفِيَّة البرماوي "النبذة الألفية في الأصول الفقهية" وأَصْلَها "النُّبْذة الزكية في القواعد الأصلية" له أيضًا، وطُبِعَا - بفضل الله تعالى - في مجلد واحد، نَشَرتهما مكتبة التوعية الإسلامية لأول مرة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في يناير 2014 م.
وكتابنا هذا - الذي بين يديك - هو الشرح الوافي للبرماوي "الفوائد السنية في شرح الألفية"، يخرج إلى النور مطبوعًا لأول مرة بفضل الله تعالى.
¬__________
(¬1) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (2/ 1923).
(¬2) الدرر اللوامع - مخطوط (ورقة: 88)، محفوظ بجامعة الملك سعود (رقم: 1281).
الباب الثاني: فيما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة
وهو أربعة أنواع:
الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأُولى وهو السند
257 - فَالسَّنَدُ الْإخْبَارُ عَنْ مَتْنٍ ضَبَطْ ... مِنْ قَوْلٍ اوْ فِعْلٍ وَلَوْ فِيهِ وَسَطْ
258 - وَذَاكَ آحَادٌ وَ [ذُو] (¬1) تَوَاتُرِ ... فَالثَّانِ نَقْلُ عَدَدٍ مِنْ آثِر
259 - عَلَيْهِمُ يَمْتَنِعُ التَّوَاطُؤُ ... في الْكِذْبِ عَنْ حِسٍّ بِهِ تَوَاطَؤوا
260 - أَوْ خَبَرٌ عَنْ مِثْلِهِمْ إلى انْتِهَا ... لِذَلِكَ الْمَحْسُوسِ، فَهْوَ الْمُنْتَهَى
الشرح: إنما قدمتُ من الأنواع الأربعة ما يتوقف عليه من حيث الثبوت؛ لأن الكلام في الشيء إنما يكون بعد ثبوته، ثم يتلوه ما يتوقف عليه من حيث دلالة الألفاظ؛ لأنه بعد الصحة يتوجه النظر إلى [مدلول ذلك الثابت] (¬2)، ثم يتلوه ما يتوقف عليه من حيث استمرار الحكم وبقاؤه، فلم يُنسخ، ثم يتلوه ما يتوقف عليه الدليل الرابع وهو "القياس" من بيان أركانه وشروطه وأحكامه؛ لأنه مُفَرع عن الثلاثة الأولى؛ إذ لا قياس إلا على ما ثبت بواحد منها كما سيأتي.
¬__________
(¬1) كذا في (ز، ش، ت، ن). لكن في (ص، ض، ظ، ق): ذا.
(¬2) كذا في (ز، ش)، لكن في (ق): ما دل ذلك الثابت عليه. وفي سائر النسخ: ما دل ذلك الثابت.
"المتشابه" كأعداد الصلوات واختصاص رمضان بالصيام دون شعبان) (¬1).
وفي تفسير المحكم والمتشابه سوى ما سبق أقوال كثيرة:
منها: أن "المحكم" ما خَلُص لفظُه مِن الاشتراك ولم يُشَبْ بغيره، و"المتشابه" بخلافه.
أو أن "المحكم" ما اتصلت حروفه، و"المتشابه" ما تقطعت، كالحروف المقطعة أوائل السور.
أو أن "المحكم" ما تُوُعِّد به الفساق، و"المتشابه" ما أُخْفي عقابه.
أو أن "المحكم" ما احتج الله تعالى به على الكفار، و"المتشابه" خلافه.
أو أنَّه الوعد والوعيد في الأحكام، و"المتشابه" القصص وسِيَر الأولين.
أو أن "المحكم" نعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في التوراة والكتب المتقدمة، و"المتشابه" نعته في القرآن.
أو أن "المحكم" الناسخ، و"المتشابه" هو المنسوخ.
أو أن "المتشابه" آيات القيامة، و"المحكم" ما سواها.
أو نحو ذلك مِن الأقوال المنتشرة.
قال ابن السمعاني: أحسنها أن "المحكم" ما أبان معرفة المراد بظاهره أو بدلالة تكشف عنه، و"المتشابه" بخلافه، فيدخل في كلامه في "المحكم" المُؤَوَّل، ويجمع بينه وبين ما سبق من القول الراجح أنَّه -مِن حيث هو- كان "متشابهًا"؛ لِعدم إرادة الظاهر فيه، وبَعد قيام الدليل على إرادة المرجوح صار "مُحْكَمًا".
وإليه أشرتُ بقولي: (إذَا تُقَابِلُ)، أي: إذا أردت أن تقابله بالمحكم وإنْ أُطلق عليه في
¬__________
(¬1) تفسير النكت والعيون (1/ 370).
وقد يجاب بأن الكلام في عامٍّ باقٍ على أن دلالته على فرد فرد ظاهرة، لا نص. وبعد وقوع العمل يصير كالنص على كل فرد فرد؛ فلذلك كان نسخًا.
الرابع: قد يورَد على تعريف "التخصيص" أنه إنما يكون تخصيصًا بدليل، فَلِمَ لا قيل: قَصْر العام بدليل؟
وجوابه: أن الكلام في التخصيص الشرعي، فالتقدير: قَصْر الشارع العام على بعض أفراده. فأُضيف المصدر إلى مفعوله وحُذف الفاعل؛ لِلعِلم به؛ ولأجل ذلك لم أتعرض لكون تخصيص العام جائزًا؛ استغناءً بِذكر جوازه إلى واحد أو كذا إلى آخِر ما سيأتي.
وقد تَعرض ابن الحاجب وغيره لحكاية الخلاف في جواز تخصيص العام، فقال: (التخصيص جائز إلا عند شذوذ) (¬1).
وأراد بذلك أن العام سواء كان أمرًا أم نهيًا أم خبرًا يجوز أن يَطرقه التخصيص ولو كان مؤكدًا بِـ"كل" ونحوها، إلا أن قومًا شذوا فمنعوه مطلقًا - وكذا حكاه الإمام الرازي وأتباعه.
لكن مقتضى إيراد الشيخ أبي حامد وسليم والشيخ أبي إسحاق وابن الصباغ وابن السمعاني وأبي الحسين والآمدي أن الخلاف إنما هو في تخصيص العام إذا كان خبرًا، لا أمرًا أو نهيًا، فإنه جائز بلا خلاف.
لنا: ورود ما هو مخصوص قطعًا، نحو: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} [الرعد: 16]، {تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا} [الأحقاف: 25]، {يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ} [القصص: 57]، {وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ} [النمل: 23]، {وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا} [الكهف: 84].
وفي الأمر: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: 5]، وفي النهي: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى
¬__________
(¬1) مختصر المنتهى (2/ 235) مع بيان المختصر.
رواية: "إذًا يكفيك الله هَم الدنيا والآخرة" (¬1). والله أعلم.
ص:
803 - أَوْ ظَاهِرٌ، كَاللَّامِ أَوْ أَنْ قُدِّرَتْ ... كـ "أَنْ كذَا"، فَالْبَاءِ، فَالْفَاءِ ثَبَتْ
804 - في كَلِمِ الشَّارعِ فَالْفَقِيهِ ... مِنَ الرُّوَاةِ، ثُمَّ غَيْرٍ فِيهِ
805 - وَ"إنَّ، إذْ"، وَمَا مَضى لِلسَّبَبِ ... وَالثَّالِثُ: "الْإيمَاءُ" في التَّجَنُّبِ
الشرح:
القسم الثاني مِن قِسْمَي النص وهو ما كان ظاهرًا -لا صريحًا- له ألفاظ:
أحدها:
"اللام"، ظاهرة كانت نحو: {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ} [إبراهيم: 1] أو مُقدَّرة كقوله تعالى: {عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ (13) أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ} [القلم: 13، 14] أيْ: لِأنْ كان. وهذا معنى قولي: (أَوْ أَنْ قُدِّرَتْ) وهو بفتح الهمزة، وهو عطف على مُقدَّر، أي: كـ"اللام" ظهورًا أو تقديرًا. فإنَّ "أنْ" والفعل يتَأَوَّلان بالمصدر.
ثم مثلت المقدَّرة بقولي: (كـ "أَنْ كَذَا") أي: كما يقال في الكلام: "أنْ كذا". فالتعليل مستفاد من "اللام" المقدَّرة، لا مِن "أن".
ومن هذا ما في الحديث الصحيح في قصة الزبير من قول الأنصاري الذي خاصمه: "أنْ
¬__________
(¬1) مسند الإمام أحمد (رقم: 21280)، مصنف ابن أبي شيبة (رقم: 8706، 31783) بنحوه.
قال الألباني: (هذا مرسل صحيح الإسناد، ويشهد له ما بعده). تحقيق كتاب "فضل الصلاة على النبي، ص 31".