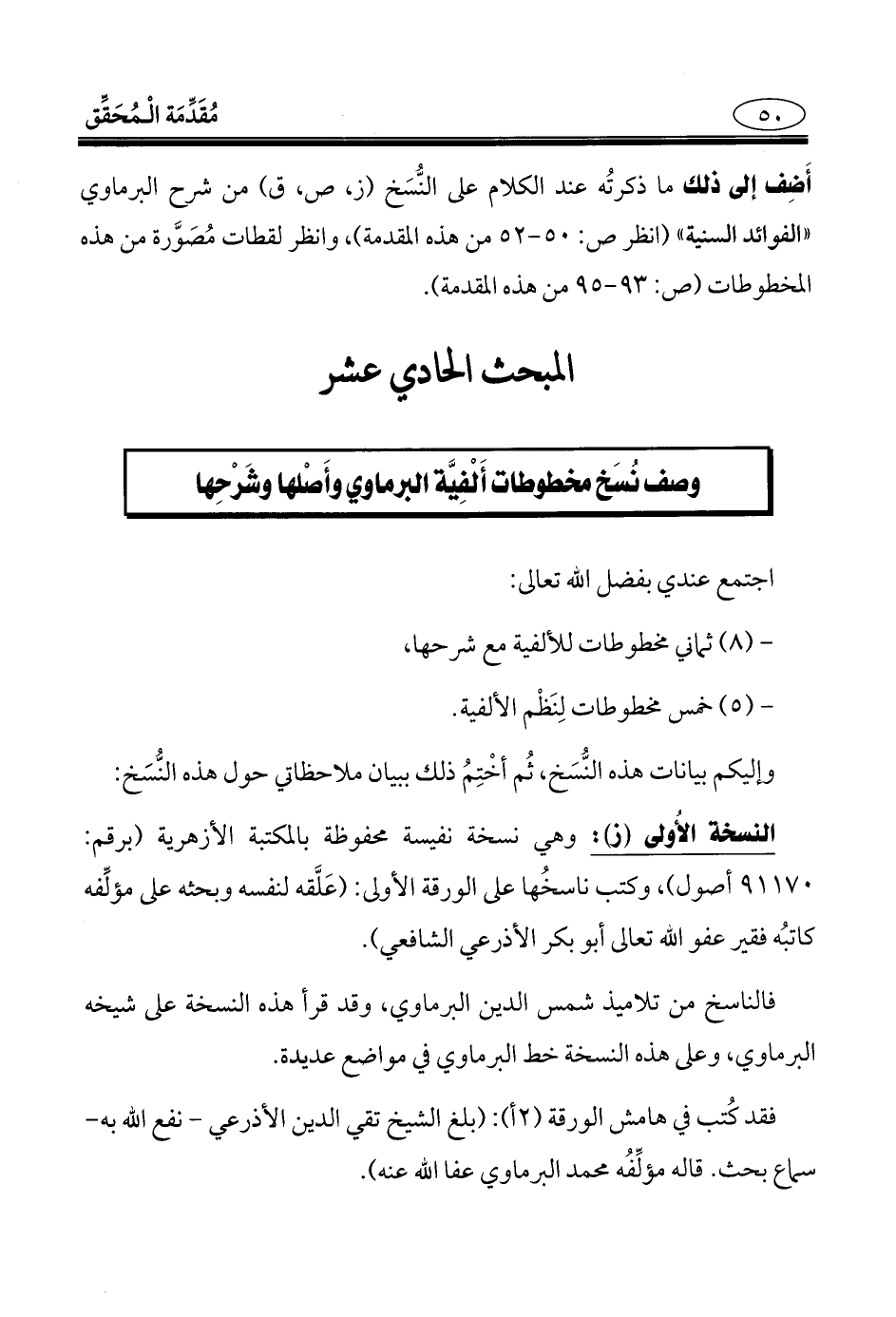
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية
أَضف إلى ذلك مما ذكرتُه عند الكلام على النُّسَخ (ز، ص، ق) من شرح البرماوي "الفوائد السنية" (انظر ص: 50 - 52 من هذه المقدمة)، وانظر لقطات مُصَوَّرة من هذه المخطوطات (ص: 93 - 95 من هذه المقدمة).المبحث الحادي عشر: وصف نُسَخ مخطوطات أَلْفِيَّة البرماوي وأَصْلها وشَرْحِها
اجتمع عندي بفضل الله تعالى:
- (8) ثماني مخطوطات للألفية مع شرحها،
- (5) خمس مخطوطات لِنَظْم الألفية.
وإليكم بيانات هذه النُّسَخ، ثُم أخْتِمُ ذلك ببيان ملاحظاتي حول هذه النُّسَخ:
النسخة الأُولى (ز): وهي نسخة نفيسة محفوظة بالمكتبة الأزهرية (برقم: 91170 أصول)، وكتب ناسخُها على الورقة الأولى: (عَلَّقه لنفسه وبحثه على مؤلِّفه كاتبُه فقير عفو الله تعالى أبو بكر الأذرعي الشافعي).
فالناسخ من تلاميذ شمس الدين البرماوي، وقد قرأ هذه النسخة على شيخه البرماوي، وعلى هذه النسخة خط البرماوي في مواضع عديدة.
فقد كُتب في هامش الورقة (2 أ): (بلغ الشيخ تقي الدين الأذرعي - نفع الله به - سماع بحث. قاله مؤلِّفُه محمد البرماوي عفا الله عنه).
قولي: (وَشَرْطُهُ أَذْكُى مُبِينَهْ) أَيْ: وشرط العمل بخبر الواحد (سواء قلنا: يفيد الظن أو العِلم) ما أذكره بعد ذلك مبينًا له ومفصِّلًا، وهو ثلاثة شروط: عدالة الراوي ومروءته، وضبطه. وسيأتي شرحها في الأبيات التي بعد هذه موضحة إن شاء الله تعالى.
ونصب (مُبِينَهْ) على الحال؛ لأنه نَكرة؛ لكون إضافته غير مَحْضة.
والمراد بالشرط مجموع الشروط؛ لأن المفرد المضاف يَعُم.
وضابط الشروط في رواته: صفات تُغَلِّب على الظن أن المخبِر صادق.
ولم أذكر من الشروط:
- ما ذكره البيضاوي وغيره مما يرجِع إلى المخبَر عنه، ككون اللفظ لا يخالفه قاطع؛ لأن هذا الشرط جارٍ في كل عملٍ بظني، لا بخصوص خبر الواحد.
- ولا ما يرجع إلى نفس الخبر، كألفاظ الراوي في كيفية روايته؛ لأن ذلك مما يتحقق به وجود الرواية وصدقها عمن رُويت عنه؛ لأن [مِن] (¬1) شرائط العمل بها تقدم وجودها. والله أعلم.
ص:
283 - أَمَّا الْعَدَالَةُ فَتِلْكَ مَلَكَهْ ... مَانِعَةُ اقْتِرَافِ كُلِّ هَلكَهْ
284 - كَبِيرَةً تَكُونُ أَوْ إِصْرَارَا ... عَلَى صَغِيرَةٍ، أَيِ الْإكْثَارَا
الشرح:
الشرط الأول من شروط الراوي الذي يجب العمل بخبره: العدالة.
وهى لُغةً: التوسط في الأمر من غير ميل إلى أحد الطرفين، بل يكون معتدلًا، لا إفراط
¬__________
(¬1) ليس في (ز، ش).
ولو ادَّعى عليه بعشرة فقال: (لا يلزمني اليوم)، لا يكون إقرارًا؛ لأنَّ الإقرار لا يثبت بالمفهوم. نقله الرافعي عن القاضي [حسين] (¬1).
وأما المكان فنحو: {فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} [البقرة: 198]، وهو حُجة كما نقله الإمام والغزالي في "المنخول"، ولو قال: (بعْ في مكان كذا)، تَعَين على الأصح.
نَعَم، هنا بحث، وهو أنه هل يُشترط كَوْن الفاعل والمفعول في المكان؟
مقتضَى كلام النحاة أنه لا يشترط، وقد فرق أصحابنا بين ما لو قال: (إنْ قتلتِ زيدًا في المسجد فأنت طالق) وبين قوله: (إنْ قذفتِ زيدًا في المسجد فأنت طالق) بِشَرط وجود القاذف فيه والمقتول فيه.
والتحقيق في هذه القاعدة التفصيل بين الحسي فيشترط وجوده كالمسألة الأولى، و [المعنوي فلا يشترط] (¬2) كالثانية.
ونشأ مِن هذا خلاف بيننا وبين [الحنفية] (¬3) في حديث: "صَلَّى على سُهيل بن بيضاء في المسجد" (¬4). فَهُم يقولون: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسجد وسهيل خارجه. ونحن نقول: كانا في المسجد.
ويُضعِّف قولهم أن الصلاة مِن الحسي، فلا بُدَّ من وجود الفاعل والمفعول في الظرف.
وَيرُد قولهم أيضًا أن الواقع أنْ ليس في حائط مسجده - صلى الله عليه وسلم - فُرْجة من جهة القِبلة حتى يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - يراه منها فيُصلي عليه وهو خارج عن المسجد.
¬__________
(¬1) في (ز، ظ، ض): الحسين.
(¬2) في (ز، ق): إلا فلا.
(¬3) في (ز): أبي حنيفة.
(¬4) صحيح مسلم (رقم: 973) بنحوه.
واجب الدخول في آخَر دال عليه.
فَـ "إخراج" جنس يدخل فيه التخصيص بالمنفصل والمتصل بأقسامهما.
وقولنا: (بِنَحْوِ "إلَّا") إلى آخِره - مخُرِج لما سوى الاستثناء المتصل مما دخل تحت "إخراج".
والإشارة بِـ "نحو: إلا" إلى أدوات الاستثناء الثمانية المشهورة التي منها ما هو حرف اتفاقًا كَـ "إلا" أو على الأصح: كَـ "حاشَا" فإنها حرف عند سيبويه دائمًا، ويقال فيها أيضًا: "حاشَ" و "حَشَا".
ومنها ما هو فعل (كَـ "لا يكون") أو على الراجح (كَـ "ليس").
ومنها ما يتردد بين الفعلية والحرفية، فإنْ نَصب ما بعده، كان فعلًا، أو خفضه، كان حرفًا، وهو "خَلَا" باتفاق، و"عَدَا" عند غير سيبويه.
ومنها ما هو اسم، وهو "غَيْر" و"سِوَى"، سواء قلنا: إنه ظرف دائمًا استثني به. أو قُلنا: يتصرف تَصرف الأسماء. ويقال فيه: "سُوى" بضم السين، و"سواء" بفتحها والمد، أو بكسرها والمد. ذكرها الفاسي في شرح الشاطبية.
نعم، قيد البيضاوي وابن الحاجب في بعض تعاريفه "إلا" بغير الصفة وإن لم يقيد في تعريفه المختار.
والقصد بهذا القيد إخراج نحو: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} [الأنبياء: 22]، فليست "إلا" فيه استثناء، بل وصف، وإلا لفسد المعنى؛ لأنه إذا كان الفساد مرتبًا على وجود آلهة ليس فيهم الله، اقتضَى نَفْي الفساد في وجود آلهة فيهم الله. وذلك باطل قطعًا.
نعم، زعم المبرد أنها استثناء، وما بعدها بدل؛ لأنَّ الشرط بِـ "لو" امتناع، وهو معنى النفي.
فيها، بل نقطع بكونها حُجة. وحيث جاء خلاف فهو عند تَعارض مصلحتين ومقصودين، فيرجح الأقوى؛ ولذلك قطعنا بكون الإكراه مبيحًا لكلمة الكفر وللشرب؛ لأنَّ الحذر مِن سفك دم أشد مِن هذه الأمور، ولا يُباح به الزنا؛ لأنه في مثل محذور الإكراه) (¬1).
وإلى كَوْنه لا يُستثنى مِن المناسب المرسل أشرتُ بقولي: (وليس مِن هذا) إلى آخِر الأبيات.
الثاني:
نشأ من تقييد هذه المسألة بالقيود الثلاثة مسائل فيها الخلاف:
منها: "ضرب المتهم؛ لِيمر بالسرقة إنْ كان سرق" فيه مصلحة، قال به مالك، ونحن نمنع؛ لمعارضة هذه المصلحة لمصلحة المضروب؛ إذ قد يكون بريئًا. وترك الضرب في المُذْنِب أَهْوَن مِن ضرب البريء ولو لَزِمَ منه مصلحة عامة وهي أنْ لا يُفتح باب يَعْسُر معه انتزاع الأموال، فإنَّ الضرب فتح باب لتعذيب البريئين.
ومنها: الزنديق [المُتستر] (¬2) إذا تاب، المصلحة في قتله وأنْ لا تُقبَل توبته. وبه قال مالك، لكن الأصح عندنا القبول؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أُمرت أنْ أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فإذَا قالوها، عصموا مني دماءهم وأموالهم" (¬3).
وتأويله بغير الزنديق تأويل بلا دليل، ويعارض مصلحة قتله وعدم قبول توبته بِنفرة مَن يريد التوبة مِن الإسلام؛ لأنه يقول: لا يعصمني من القتل. و [ينتشر] (¬4) ذلك
¬__________
(¬1) المستصفى (1/ 179).
(¬2) كذا في (ش)، لكن في (ص): المستسر. وفي (ق): المستستر. وفي (ت، س): المصر. وفي (ض): المسر.
(¬3) صحيح البخاري (رقم: 25)، صحيح مسلم (رقم: 21).
(¬4) في (س، ت): ينسدّ.