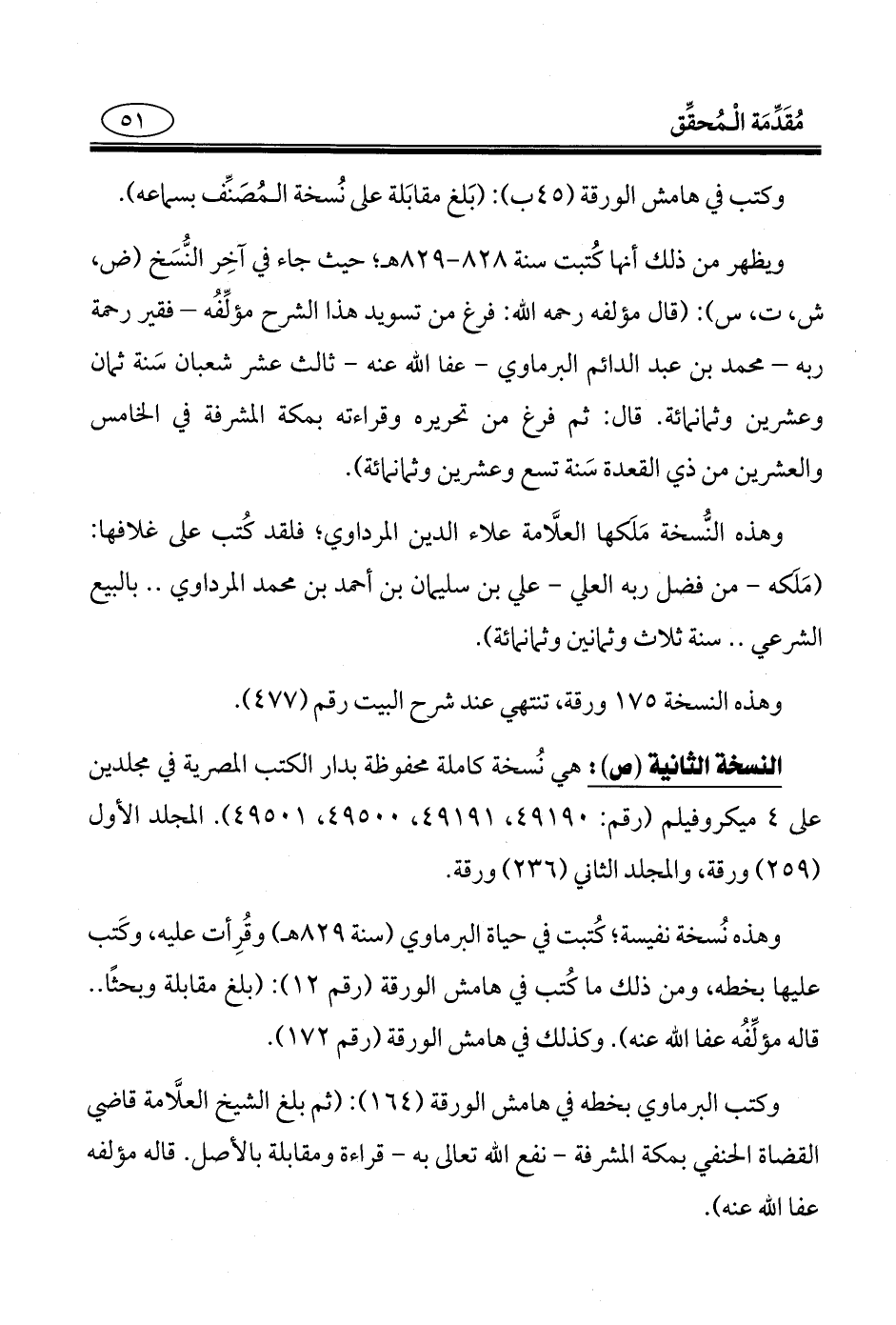
كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية
وكتب في هامش الورقة (45 ب): (بَلغ مقابَلة على نُسخة المُصَنِّف بسماعه).ويظهر من ذلك أنها كُتبت سنة 828 - 829 هـ؛ حيث جاء في آخِر النُّسَخ (ض، ش، ت، س): (قال مؤلفه رحمه الله: فرغ من تسويد هذا الشرح مؤلِّفُه - فقير رحمة ربه - محمد بن عبد الدائم البرماوي - عفا الله عنه - ثالث عشر شعبان سَنة ثمان وعشرين وثمانمائة. قال: ثم فرغ من تحريره وقراءته بمكة المشرفة في الخامس والعشرين من ذي القعدة سنة تسع وعشرين وثمانمائة).
وهذه النُّسخة مَلَكها العلَّامة علاء الدين المرداوي؛ فلقد كُتب على غلافها: (مَلَكه - من فضل ربه العلي - علي بن سليمان بن أحمد بن محمد المرداوي .. بالبيع الشرعي .. سنة ثلاث وثمانين وثمانمائة).
وهذه النسخة 175 ورقة، تنتهي عند شرح البيت رقم (477).
النسخة الثانية (ص): هي نُسخة كاملة محفوظة بدار الكتب المصرية في مجلدين على 4 ميكروفيلم (رقم: 49190، 49191، 49500، 49501). المجلد الأول (259) ورقة، والمجلد الثاني (236) ورقة.
وهذه نُسخة نفيسة؛ كُتبت في حياة البرماوي (سنة 829 هـ) وقُرِأت عليه، وكَتب عليها بخطه، ومن ذلك ما كُتب في هامش الورقة (رقم 12): (بلغ مقابلة وبحثًا .. قاله مؤلِّفُه عفا الله عنه). وكذلك في هامش الورقة (رقم 172).
وكتب البرماوي بخطه في هامش الورقة (164): (ثم بلغ الشيخ العلَّامة قاضي القضاة الحنفي بمكة المشرفة - نفع الله تعالى به - قراءة ومقابلة بالأصل. قاله مؤلفه عفا الله عنه).
ولا تفريط.
وأما في الشرع: فهي مَلَكَة مانعة من اقتراف كبيرة، ومن إصرار على صغيرة.
فَـ "مَلَكَة" جنس، وهي الصفة الراسخة في النفْس. أما الكيفية النفسانية في أول حدوثها قبل أن ترسخ فتسمى "حالًا"، و [لذلك] (¬1) عِيبَ على صاحب "البديع" في تعبيره بأن "العدالة": (هيئة في النفس) إلى آخِره؛ لشمولها الحال والملكة.
ويعرف هذا الرسوخ بغلبة الطاعات كما قال الشافعي في "الرسالة" ما نَصه: (وليس للعدل علامة تفرق بينه وبين غير العدل في بدنه ولا لفظه، وإنما علامة صدقه ما يخبر عن (¬2) حاله في نفسه، فإذا كان الأغلب من أمره ظاهر الخير، قُبل) (¬3). انتهى
وهو معنى قول ابن القشيري: إن الذي صح عن الشافعي أنه قال: ليس في الناس من يُمحض الطاعة فلا يمزجها بمعصية، ولا من المسلمين من يمحض المعصية ولا يمزجها بالطاعة، فلا سبيل إلى رَد الكل ولا إلى قبول الكل. فإنْ كان الأغلب من أمر الرجُل الطاعة والمروءة، قبلت شهادته وروايته. وإن كان الأغلب المعصية وخلاف المروءة، رددتها.
وكذا جرى على نحو ذلك أبو بكر الصيرفي وغيره. وما أحسن ما تأسى بذلك محمد بن يحيى في تعليقته، فقال: (العدل مَن اعتاد العمل بواجب الدِّين، واتبع إشارة العقل فيه برهَةً من الدهر حتى صار ذلك عادةً ودَيْدنًا له، والعادة طبيعة خامسة، فيغلب دينه بحكم التمرين و [الترسخ] (¬4) في النفس، فيوثق بقوله، بخلاف الفاسق، فإنه الذي يُتبع نَفْسه
¬__________
(¬1) في (ز): لهذا.
(¬2) في "الرسالة، ص 493": (علامة صدقه بما يُختبر من حاله في نفسه).
(¬3) الرسالة (ص 493).
(¬4) في (ق، ظ، ت): التولج.
ونحو ذلك أيضًا: "البصاق في المسجد خطيئة" (¬1)، فهل يمتنع مَن بالمسجد أن يبصق إلى خارجه؟ يجري فيه هذا العمل.
الثالث: "مفهوم الحال":
كقوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: 187]. ذكره ابن السمعاني في "القواطع" وإنْ لم يذكره أكثر المتأخرين، وقال: (إنه كالصفة) (¬2).
وهو ظاهر؛ لأن الحال صفة في المعنى قُيِّد بها.
الرابع: "مفهوم العدد":
أي: تعليق الحكم بِعَدد مخصوص، كقوله تعالى: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور: 4]، وهو كالصفة كما قاله الشيخ أبو حامد وابن السمعاني، وجرى عليه الإمام والغزالي وابن الصباغ في "العدة"، وسليم قال: وهو دليلنا في نصاب الزكاة والتحريم بخمس رضعات.
ونقله الشيخ أبو حامد عن نَص الشافعي. وكذا الماوردي في باب "بيع الطعام قبل أن يستوفى"، ومَثَّله بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "في أربعين شاةً شاةٌ" (¬3)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا بلغ الماء قُلتين، لم يحمل خبثًا" (¬4).
¬__________
(¬1) سنن النسائي (723)، وقال الألباني في (صحيح النسائي: 722): صحيح. وفي: صحيح البخاري (رقم: 405)، صحيح مسلم (رقم: 552) بلفظ: (البُزَاقُ فِي المَسْجِدِ خَطيئةٌ).
(¬2) قواطع الأدلة في الأصول (1/ 251).
(¬3) سنن ابن ماجه (رقم: 1805)، وفي سنن أبي داود (رقم: 1568) وغيره بلفظ: (في كل أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ). وقال الألباني فيهما: صحيح. (صحيح ابن ماجه: 1834، صحيح أبي داود: 1568).
(¬4) سبق تخريجه.
ورُدَّ بأنه لا يقال: (لو جاءني ديار أو من أحد) كما يقال: (ما جاءني ديار أو من أحد).
وإنما لم أُقيد به اعتناءً بلفظ إخراج، فإنَّ "إلا" الوصفية لا إخراج فيها بالوضع وإنْ كانت مُخرجة من حيث الوصفية؛ ولذلك لم يذكرها الإمام الرازي وأتباعه غير مَن ذكرنا. بل مِن الوصف ما لا إخراج به أصلًا كما لو كان للمدح أو الذم أو الترحم أو التوكيد.
وأيضًا فلا يُقصر هذا القيد على "إلا"، بل يجري فيما يكون وصفًا مما هو نحو "إلا" كَـ "غير" و "سوى"، فينبغي تأخير القيد عن قوله: (ونحوها)؛ لِيَعُم "إلا" وغيرها.
وأيضًا فينبغي أن يحترز عن "إلا" الواقعة عاطفة كما ذكره الأخفش والفراء وأبو عبيد، كقوله تعالى: {لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ (10) إِلَّا مَنْ ظَلَمَ} [النمل: 10 - 11]، الآية، ومنه على رأْيٍ:
وكُلُّ أَخٍ مُفارِقُهُ أخوه ... لَعَمْرُ أبيكَ إلاَّ الفَرقدانِ
أي: والفرقدان.
والزائدة -كما قاله الأصمعي وابن جني- نحو: (حَرَاجِيجُ لاَ تَنْفَكُّ إلاَّ مُنَاخَةً). إذ المعنى: لا تنفك مناخة.
وقولنا: (مما هو واجب الدخول) احتراز مِن نحو: (جاء رجال إلا زيدًا)؛ لاحتمال أن لا يريد المتكلم دخوله حتى يُخرجه.
أما إذا أفاد الاستثناء من النكرة كاستثناء جزء من مركب، فيجوز، نحو: اشتريت عبدًا إلا رُبعه، أو: دارًا إلا سَقْفها.
ومنه الاستثناء مِن العدد، نحو: {فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا} [العنكبوت: 14].
وكما أن الاستثناء مِن النكرة إذا لم يُفِد لا يكون متصلًا كذلك لا يكون منقطعًا؛ لأن
ويستعينون بالهرب وبالحرب. هذا ما نَص عليه الشافعي في "المختصر"، وقطع به العراقيون، وصححه المتأخرون. وخالف فيه بعض الأصحاب، ووافقهم الروياني.
وقيل: لا تُقبل مِن المتناهين في الخبث، كدعاة الباطنية. قاله القفال.
وقيل: إنْ أُخِذ لِيقتل فتاب، لا تُقبل توبته. وإنْ جاء تائبًا، قُبِلَت. قاله الأستاذ أبو إسحاق.
وقيل: لا تُقبل إنْ تكررت رِدته. قاله أبو إسحاق المروزي.
وفروع الباب كثيرة، والمدارك فيها شهيرة، وفي هذا القدر هنا كفاية. والله أعلم.
ص:
838 - وَالْمُفْسِدُ اللَّازِمُ لِلْمُنَاسِب ... يَخْرُمُ غَيْرَ رَاجِحِ التَّنَاسُبِ
الشرح:
لَمَّا سبق أنَّ المناسب تثبت عِليته إذا اعتبره الشرع لا ما إذا ألغاه أو لم يعتبره ولم يَلْغِه، بينتُ هنا أنه هل تنخرم مناسبته بأنْ يشتمل على مفسدة معارِضة لِمَا فيه مِن المصلحة؛ أو لا؟
فقلتُ: إنها تنخرم في مَحَلَّين: أن تكون المفسدة راجحة على تلك المصلحة، أو مساوية. وهُما داخلان تحت قولي: (غَيْرَ رَاجِحِ التّنَاسُبِ). أي: أما إذا كانت المصلحة التي في "المناسب" راجحة على المفسدة، فلا خلاف أنها لا تنخرم، كما لو لم تكن مفسدة أصلًا.
والانخرام بالمفسدة الراجحة والمساوِية هو ما اختاره ابن الحاجب والصفي الهندي من المذهبين في المسألة، وهو الراجح. والإمام الرازي وأتباعه - كالبيضاوي - رجحوا الثاني، وهو عدم انخرام المناسبة بذلك.